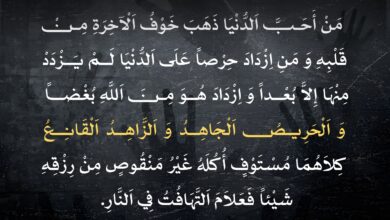بعد الرسول صلىاللهعليهوآله، حيث ازدحمت الحوادث واختلفت النّعرات، نری الامام الحسين يقف جنباً إلى جنب مع والده العظيم في قضيّة الحقّ، ويُعلنها في أوضح برهان، والمسلمون هناك، يهتدون على مَن يهتدون.
ومرّة اُخرى نلتقي بالحسين عليهالسلام وهو شاب يمثّل شمائل أبيه المهيبة، ويقود الجيوش المزمجرة ضدّ طاغية الشام معاوية بن أبي سفيان، وتتمّ على مضاء عزمه ومضاء سيفه، وسداد فكره وسداد خططه انتصارات باهرة ضدّ الطغيان الاُموي الذي أراد أنْ يرجع بالاُمّة الإسلاميّة إلى جاهليّتها الاُولى، وقد فعل.
ثمّ تُدَبَّر مؤامرة لئيمة لاغتيال الإمام عليٍّ عليهالسلام، وينتهي الأمر بمصرعه الفاجع، وتلقي الاُمّة بأبهض مسؤوليّاتها وأخطرها على كاهل الإمام الحسن عليهالسلام، فيمارس الإمام الحسين عليهالسلام جهاده المقدّس في أداء أمانة الحقّ ومسؤوليّة الاُمّة، ويُحرّض الشعب الإسلامي ضدَّ الباطل المحتشدة كلّ قواه في عرصات الشام، ويُحذّره من كلِّ ما يُرتقب من مآسي وويلات على يد الطاغية إنْ تمَّ له الأمر.
وينتهي دور الإمام الحسن عليهالسلام فيُقتل بسمٍّ يدسّه إليه طاغية الشام، فتقع دفّة الخلافة الإلهيّة بيد الحسين عليهالسلام، ويتابعه المسلمون الواقعيّون الذين لم يشاهدوا في بني اُميّة إلاّ مُلكاً عضوضاً، كلُّ همِّه القضاء على مُقدّسات الاُمّة ومشاعرها في آن واحد. نعم، انتقلت الإمامة إلى رحاب الحسين عليهالسلام في أوائل السّنَة الخمسين من الهجرة النبويّة، ولنلقي نظرة خاطفة على الوضع السّائد في البلاد الإسلاميّة آنذاك.
في السّنَة الواحد والخمسين حجّ معاوية إلى بيت الله الحرام ليرى من قريب الوضع السّياسي في مركز الحركة المناوئة لخلافته؛ حيث إنّ الحَرمين كانا مقرّا الصحابة والمهاجرين، وهم أبغض خلق الله لمعاوية؛ لأنّهم أشدّهم خلافاً عليه. فلمّا طاف بالبلاد المقدّسة عرف أنّ الأنصار -بصورة خاصّة- يُبغضونه ويكرهون خلافته على أشدّ ما تكون الكراهيّة والبغض.
وذات يوم سأل الملأ حوله: ما بالُ الأنصار لَم يستقبلوني؟ فأجابه طائفة من زبانيته: إنّهم لايملكون من الإبل ما يستطيعون استقبالك عليها.
وكان معاوية يعرف الحقيقة من برودة تلقّي الأنصار مجيئه، فحينما سمع هذا الجواب الروتيني لمز وغمز، وقال: ما فعلت النّواضح؟ -أراد الاستهزاء بساحة الأنصار، بأنّهم كانوا ذات يوم من عمّال اليهود في المدينة، أصحاب إبل تنضح الماء لبساتين اليهود- وكان في الحاضرين بعضُ زعماء الأنصار فأجابه -وهو قيس بن سعد بن عبادة- قائلاً:
أفنوها يوم بدر واُحد وما بعدهما من مشاهد رسول الله صلىاللهعليهوآله، حيث ضربوك وأباك على الإسلام حتّى ظهر أمر الله وأنتم كارهون. أما إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله عهد إلينا أنّا سنلقي بعده أثرة.
ثمّ جاش صدر قيس، فاندلعت منه شرارة فيها ذكريات الماضي الزاهر، وعواصف هذا اليوم الأسود، فقال وأمعن في إيضاح سوابق بني اُميّة ولواحقهم، وشرح ما كان من وقوفهم ضدّ الدعوة النبويّة -أول يوم- وما كان من إنكارهم حقّ عليٍّ عليهالسلام بعد ذلك، وما كان من أمر معاوية -بالذات- مع إمام زمانه، وما جاء عن لسان النّبيِّ صلىاللهعليهوآله من الأحاديث بشأن عليٍّ عليهالسلام، الذي افترضه معاوية مناوئه الوحيد على كرسي الحكم.
ولَم يدرِ قيس -ذلك اليوم- ما الذي كان يحمله معاوية من بغضٍ وكره سوف يحدوان به إلى ما لا تُحمد عواقبه.
ورجع معاوية يفكّر في إجراء التدابير اللازمة ضدّ مناوآت الأنصار والمهاجرين. وأول خطّة اتخذها هي التي سوف يُتلى عليك تفصيلها. وعرف معاوية أنّ في البلاد الإسلاميّة كثرة واعية من المفكّرين الذين محضوا عن تجارب الماضي القريب، ولمسوا حقيقة أمر الحزب الاُموي الحاكم، كما آمنوا بقداسة الحق وبوجوب متابعته، والدفاع عن نواميسه السامية مهما كلّفهم الأمر.
وعرف كذلك أنّه يستقرّ في مركز حركة هؤلاء الذين ناوأوه، عليّاً أولاً، والحسن ثانيا ً، وهذا الإمام ثالثاً، ثمّ عرف أيضاً ما لهذا البيت العلوي من دعائم وطيدة، ومؤهّلات كافية تنذر عرش الاُمويّين بالفناء العاجل.
فمن هنا بدأت خطّته اللئيمة، ففكّر في أنّ مَن يُحبّ عليّاً وآل عليٍّ عليهمالسلام لا شكّ في أنّه يستاء من مُلك بني اُميّة. إذاً فلنقلع حبّ الإمام عليهالسلام أوّلاً من صدور الشعب المسلم، ولنستأصل مقاييس المسلمين التي يُميّزون بها الحقّ عن الباطل، ألا وهي تمثّل الإسلام الحقّ في بيت الرسالة.
فلذا أخذ يكتب إلى كلّ والٍ له في أطراف البلاد برسالة، إليك نصّها بالحرف: أمّا بعد، انظروا إلى مَن قامت عليه البيّنة أنّه يُحبّ عليّاً وأهل بيته؛ فامحوه من الديوان، واسقطوا عطاءه ورزقه، ولا تُجيزوا لأحدٍ من شيعة عليٍّ وأهل بيته شهادة. وهذه أوّل محنة واجهها أنصار عليٍّ عليهالسلام الذين كانوا يُشكّلون الجبهة المناوئة للحزب الاُموي الحاكم، وقد كانت جبهةً شديدةً عنيفةً جدّاً.
ثمّ راح معاوية في ظلمه يخطو خطوة اُخرى، أقسى من الاُولى وأعنف كثيراً، فكتب إلى ولاته يقول: أمّا بعد، خذوهم على الظنَّة، واقتلوهم على التُّهمة.
ففكِّروا في هذه الكلمة: (اقتلوهم على التُّهمة). فهل تعرفون أقسى منها في قاموس المجرمين، وأعنف حُكماً؟! في مثل هذا الجوّ الرهيب كان يعيش الإمام الحسين عليهالسلام وهو يتقلّد منصب الخلافة الإلهيّة، ولا شكّ في أنّه كان يؤلمه الشوك في طريق أصحاب الحقّ على الظنّة، وإبادتهم بالتُّهمة.
ولكنَّ الظروف التي كان يعيشها لم تكن بالتي تجيز له المقاومة المسلّحة ضدّ العدوان الاُموي الأرعن؛ لأنّ معاوية كان يعالج الأمر بالمكر والخدعة، ويخدّر أعصاب الاُمّة بالأموال الطائلة من ثروة الدولة التي إنْ لَمْ تُعطِ الفائدة فهناك شيء كان يُسمّيه بجنود العسل، ويقصد به الغدر بحياة الشخصيّات عن طريق السّمِّ يديفه في مطعمه أو مشربه، كما فعل ذلك بالإمام الحسن عليهالسلام بواسطة زوجته الغادرة، وكان يستعمله دائماً ضدّ اُولئك العظماء الذين لا يخضعون لسلطان المال والمنصب.
أمّا إذا استعصى عليه الإغراء بالمال أو القضاء بالسّمِّ، فيأتي دور القوَّة التي كان يستعملها بدون رحمة في مناسبة وغير مناسبة. وبهذه الوسيلة الأخيرة قضى على الصّحابي الكبير والزعيم الشيعي القدير: حِجْر بن عَدي، حيث استدعاه هو وأصحابه إلى الشام، وقبل أنْ يصلوا إلى العاصمة أرسل سَريّة من شرطته، فقتلت بعضهم ودفنت بعضهم أحياءً بغير جرم إلاّ أنّهم كانوا أصحاب عليٍّ عليهالسلام وقوّاد جيشه.
وكان مقتل حِجْر هذا مُنبِّهاً فعّالاً للشعب الإسلامي الذي دعا إلى إعلان التمرّد حتّى من بعض أصحاب الاُمويّين، كوالي خراسان ربيع بن زياد الحارثي؛ حيث جاء المسجد ونادى بالنّاس ليجتمعوا، فلمّا اكتمل اجتماعهم قام خطيباً وذكر المأساة بالتفصيل، وقال: إنْ كان في المسلمين من حميّة شيء، لوجب عليهم أنْ يطالبوا بدم حِجْر الشهيد.
وحتّى من مثل عائشة التي كانت بالأمس في الصفِّ المخالف لعليٍّ عليهالسلام؛ فإنّها لما سمعت الفاجعة، قالت: أما والله، لقد كان لجمجمة العرب عزّاً ومنعةً. ثمّ أنشدت:
ذهبَ الذينَ يُعاشُ فِي أكنافِهمْ *** وبقيتُ في خَلَفٍ كجلدِ الأجرِبِ
ومشت في الأوساط السياسيّة رجّة تبعتها اضطراباتٌ جعلت معاوية يندم من سوء فعله لأوّل مرّة.
ولكن لَمْ يكن مقتل حِجْر بالوحيد من نوعه، فقد رافقه مقتل الصّحابي الكبير، المعترَف به لدى سائر المسلمين، عمرو بن الحمق، الذي حُمل رأسه على الرمح لأوّل مرّة في تاريخ الإسلام؛ حيث لم يُحمل فيه قبل ذلك اليوم رأسُ مسلمٍ قط.
وتبع حادثة حِجْر وأصحابه الستّة عشر حوادث مُرعبة نشرت على دنيا المسلمين التوتّر والاضطراب.
ويُمكننا أنْ نكشف عن بعض مظاهر هذا التوتّر بما يلي:
لقد سيطر زياد ابن أبيه على الكوفة والبصرة، ولقد كان مُتشيّعاً قبل أنْ يُلحقه معاوية بنسبه، فكان يعرف أسرار الشيعة وخباياهم، وزعماءهم وقادتهم. فلمّا استتبّ له الأمر، راحَ يلاحقهم تحت كلّ حجر ومدر، ويُمعن فيهم القتل والتنكيل حتّى ليَقول الرجل: أنا كافر لا اُؤمن بنبيٍّ. خيرٌ له من أنْ يقول: إنّي شيعي اُؤمن بقداسة الحقِّ، وأكفر بالجبت والطاغوت.
فلمّا ضبط العراقيّين إرهاب بني اُميّة، رفع زياد كتاباً إلى البلاط الملكي، هذا نصّه بالحرف: إنّي ضبطت العراق بشمالي، ويميني فارغة، فولّني الحجاز أشغل يميني به. ولما اُذيع نبأ هذه الرسالة في المدينة المنوّرة، اجتمع المسلمون في المسجد النّبوي وابتهلوا إلى الله ضارعين: اللهمّ، اكفنا يمين زياد.
ولسنا بصدد بيان أنّه كفّ الله عنهم يمين زياد فعلاً، حيث أصابه الطاعون فمات ذليلاً، إلاّ أنّنا بصدد أنْ نعرف مدى الإرهاب المخيّم على الأوساط السياسيّة حتّى أنّ النّاس يجتمعون للدعاء ضدّ والٍ واحد؛ رهيب الجانب، مُرعب السّلطة.
وإذا سألتَ عن موقف السّبط عليهالسلام، فنحن لا يهمّنا من هذا الاستعراض الخاطف للأوضاع السياسيّة في عهد معاوية إلاّ لنعرف موقف الإمام الحسين عليهالسلام منها.
ونستطيع أنْ نلمس موقفه بصورة إجماليّة إذا مضينا نُفكّر في هذه القضايا الثلاث التي سنتلوها تباعاً:
1 – كانت الأنباء تتوالى على المدينة بنكبات فجيعة، نزلت على رؤوس المسلمين بسبب مدحهم للإمام عليٍّ عليهالسلام، وبسبب تشيّعهم لأهل البيت عليهمالسلام، تماماً بعد إعلان معاوية حكمه الصارم: كلُّ مَن نقل فضيلة عن عليٍّ فقدَ الأمان على نفسه وماله. وكان ذلك في مستهلّ السّنَة الواحدة والخمسين بعد الهجرة النبويّة.
فدبّر الإمام عليهالسلام خطّة جريئة نفذّها بنفسه؛ فجمع النّاس في محفلٍ ضمّ من بني هاشم رجالاً ونساءً، ومن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله، ومن شيعته أكثر من سبعمئة رجلٍ، ومن التابعين أكثر من مئتين، فقام فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: « أمّا بعد، فإنّ هذا الطاغيةَ (يعني: معاوية بن أبي سفيان) قدَ فَعلَ بنا وبشيِعَتِنا مَا قَدْ عَلمتُمْ وَشهدتُمْ، وإنّي اُريدُ أنْ أسألَكُمْ عَنْ شيءٍ، فإنْ صدَقتُ فصدِّقونِي، وإنْ كذَبتُ فكذِّبونِي، وأسألكُمْ بحقِّ اللهِ عليكُمْ وحقِّ رسولِ اللهِ وقرابَتي منْ نبيِّكُمْ لمَا سترتم مقامِي هذا، ووصفتُمْ مقالَتي، ودعوتُمْ أجمعينَ في أمصارِكُمْ مِن قبائِلِكُمْ مَن أمنتُمْ من النّاس.
اسمَعُوا مقالتي واكتُبوا قَولِي، ثمّ ارجعوا إلى أمصارِكُمْ وقبائلِكُمْ، فمَنْ أمنتُمْ مِنَ النّاسِ ووثقتُمْ بهِ فادعوهُمْ إلى ما تعلمونَ مِنْ حقِّنا؛ فإنِّي أتخوّفُ أنْ يُدرسَ1 هذا الأمرُ، ويذهبُ الحقُّ ويُغلب،﴿ … وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ 2.
ثمّ مضى الإمام عليهالسلام في الخطبة القويّة الهادرة، يُذكِّر الجمع بعليٍّ عليهالسلام، وفي كلّ مقطوعة يصبر هُنيئة فيستشهد الأصحاب والتابعين على ذلك، وهم لا يزيدون على اعترافهم قائلين: اللهمّ نعم، اللهمّ نعم.
حتّى ما ترك شيئاً ممّا أنزل الله فيهم من القرآن إلاّ تلاه وفسّره، ولا شيئاً ممّا قاله الرسول صلىاللهعليهوآله في أبيه وأخيه واُمّه، ونفسه وأهل بيته، إلاّ رواه، وفي كلّ ذلك يقول أصحابه: اللهمّ نعم، لقد سمعنا وشهدنا. ويقول التابعي: اللهمّ قد حدّثني به مَن اُصدِّقه وأئتمِنه من الصّحابة3. أما وقد أشهدوا الله على ذلك، قال: « اُنشدكُمْ اللهَ إلاّ حدّثتُمْ بهِ مَنْ تثقُّونَ بهِ وبدينِهِ… ».
وكانت هذه خطَّة مناسبة للحدّ من طغيان معاوية في سبّ علي عليهالسلام، بل كانت خطّة معاوية لسياسة بني اُميّة قاطبة، الذين ارتأوا محو سطور في التاريخ هي أسطع ما فيه وأروع ما يحتويه، ألا وهي مآثر أهل بيت الرسالة.
ولَم يكتفِ بنو اُميّة في محوها بالقوّة فقط بل لعبت خزينة الدولة دوراً بعيداً في ذلك أيضاً؛ فقد كان الحديث يُشترى ويُباع كأيّ متاع آخر، وكان المحدِّثون أوسع النّاس ثروة أو أنكاهم نقمة؛ إنْ رضوا فلهم كلّ شيء، وإنْ أبوا فعليهم كلّ شيء.
ربّما كان معاوية، وهو الداهية المعروف، ينتظر من الإمام الحسين عليهالسلام ذلك الاستنكار البالغ، بَيد أنّه لَم يكنْ يُفكّر في أنّ الأمر سوف يُدبّر على هذا الشكل المرعب، وعلى أيّ حالٍ فقد كان الأمر مُرتقباً، ولكن حدث بعد هذا التظاهر الصارخ أمرٌ لَم يكُنْ معاوية يحلم به أبداً.
2- إنّ عيراً لوالي اليمن كانت مُحمّلة بأنواع الأمتعة إلى البلاط الملكي لتُوزَّع على أصحاب الضمائر المستأجرة، ومرَّت هذه العير بالمدينة فاستولى عليها الإمام عليهالسلام وامتلكها حقّاً شرعيّاً له؛ ليصرفه في مواقعه اللازمة. وكتب إلى معاوية رسالة أرغمت أنفه وأطارت لبّه، وهذا نصّ الرسالة: «مِنَ الحُسينِ بنِ عليٍّ إلى معاوية بنِ أبي سفيان. أمّا بعد، فإنّ عيراً مرَّتْ بِنا مِنَ اليَمنِ تَحْملُ مالاً وحُلَلاً، وعَنْبًراً وطيباً إليك؛ لتُودَعَها خزائنَ دِمشقَ، وتَعلُّ بها بعد النَّهلِ ببَني أبيكَ، وإنّي احْتجتُ إليها وأخذتُها، والسّلامُ».
وأوّل ما لفت نظر معاوية من هذه الرسالة تقديم الإمام الحسين عليهالسلام اسمه واسم أبيه على ذكر معاوية، ثمّ دعاؤه له باسمه الشخصي دون أنْ يشفعه بلقب (أمير المؤمنين) ويعتبر ذلك -في منطق القرون الاُولى- تحدّياً بليغاً لسلطة معاوية، بل يؤكّد هذا في أنّ الكاتب قد خلع عن نفسه الرضوخ لسلطان الدولة الباطلة. ثمّ جلب انتباهه موضوع أخذ اليد، وفيه أبلغ دليل على التمرّد على السّلطة الحاكمة.
بَيد أنّ معاوية بدهائه عرف أنّ الظروف لا تقتضي إلاّ الإغماض عن أمثال هذه الأعمال، ولَم يكن الإمام عليهالسلام يُريد أنْ يبتدئ بإعلان التمرّد المسلّح؛ لأنّه كان حريصاً على حفظ دماء المسلمين كحرصه على نشر الحقيقة؛ فكتب إليه معاوية في منطق مستعتب، وبيّن أنّه عارف بمكانته وجليل شأنه، وإنّه لا يُريد أنْ يمسّ ساحته بسوء، بَيد أنّ خلَفه من بعده سوف يكون له بالمرصاد.
ومضى الحسين عليهالسلام في توطيد دعائم الحقيقة؛ ببثّ الوعي، وجمع الأنصار، ولازالت الأنباء تتوارد على البلاط الملكي بشأن الإمام عليهالسلام، وأنّه يعدّ العدّة لثورة فاصلة، بَيد أنّ معاوية كاد يتمّ الأمر بالخدعة قبل أنْ يدبّر النقمة لعدم مؤاتاة الظروف للسّاعة المرتقبة، فكتب رسالة اُخرى إلى الإمام عليهالسلام يستعتب ويؤنّب، ويُذكّر بالصلات الوديّة بينه وبين الإمام عليهالسلام، ولكنّ الإمام الحسين عليهالسلام كان يعلم بالفجائع التي كانت تنقضّ على رؤوس الشيعة من مُحبّي آل الرسول صلىاللهعليهوآله في كلّ بلد.
3 – فكتب إليه برسالة اُخرى يسرد فيها أعماله واحداً تلو الآخر: «أمّا بعد، فقَدْ بلغَنِي كتابٌ تَذْكرُ فيهِ أنَّهُ انْتَهتْ إليكَ عنّي اُمورٌ أنتَ لي عنها راغبٌ، وأنا بغَيرِها عنكَ جديرٌ، وإنَّ الحَسناتِ لا يَهدي لهَا ولا يُسدِّدُ إليهَا إلاّ اللهُ تعالى. وأمّا ما ذَكرتَ أنَّهُ رُقيَ إليكَ عنِّي، فإنَّهُ إنَّما رقَّاهُ إليكَ الملاّقونَ المشَّاؤونَ بالنَّميمةِ، المفرِّقونَ بينَ الجَمعِ، وكَذِبَ المعادونَ، ما أردْتُ حَرْباً ولا عليك خِلافاً، وإنِّي لأخشَى اللهَ في تَرْكِ ذلكَ مِنكَ ومِنَ الأعذارِ فيهِ إليكَ، وإلى أوليائِكَ القاسِطينَ الملحدينَ، حزبِ الظَّلمَةِ وأولياءِ الشَّياطين.
ألستَ القاتلَ حِجْرِ بنِ عَدِي أخا كندة، وأصحابِهِ المصَلِّينَ العابِدينَ، كانوا يُنكرُونَ ويَستفْظِعُونَ البِدَعَ، ويأمرونَ بالمعرُوفِ وينهَونَ عَنْ المنكَرِ، ولا يخافونَ في اللهِ لومةَ لائمٍ، ثُمّ قتلتَهُمْ ظُلماً وعُدواناً مِنْ بعدِ ما أعطيتَهُمْ الأيمانَ المغلَّظَةَ، والمواثيقَ المؤكَّدةَ؛ جرأةً على اللهِ واستخفافاً بعهده؟!
أوَلستَ قاتلَ عمرِو بنِ الحَمقِ صاحبِ رسولِ اللهِ صلىاللهعليهوآله، العَبدِ الصَّالحِ الذي أبلتُهُ العِبادَةُ فنحلَ جسمُهُ واصفرّ لونُهُ، فقتلتَهُ بعدَ ما أمَّنْتَهُ وأعطيتَهُ من العُهُودِ ما لو فَهِمَهُ الموصمُ لزلَّتْ قَدمُهُ مِنْ رُؤوسِ الجِبالِ؟!
أوَلستَ بمُدَّعي زيادَ بنَ سُميَّة المولودَ على فِراشِ عُبيدِ ثَقيفٍ، فَزَعمتَ أنَّهُ ابنُ أبِيكَ، وقدْ قالَ رسولُ اللهِ صلىاللهعليهوآله: الولدُ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرِ. فتركتَ سُنَّةَ رَسولِ اللهِ صلىاللهعليهوآله تَعمُّداً، وتَبعْتَ هَواكَ بغيرِ هُدىً مِنْ اللهِ، ثُمَّ سَلَّطتَهُ على أهلِ الإسلامِ يقتلُهُمْ، ويقطعُ أيديهمْ وأرجُلَهُمْ، ويَسملُ أعيُنَهُمْ، ويَصلِبُهُمْ علَى جُذُوعِ النّخلِ، كأنَّكَ لستَ منْ هذهِ الاُمَّةِ وليسُو منكَ؟!
أوَلستَ قاتلَ الحَضرَميِّ الذي كتبَ إليكَ فيهِ زيادُ أنَّهُ على دينِ عليٍّ (صلوات الله عليه)، فكتبتَ إليه: أنْ اقتُلْ كلَّ مَنْ كانَ على دينِ عليٍّ. فقَتَلَهُمْ ومثَّلَ بِهِمْ؟!…». إلى آخر الكتاب الذي كان سوطَ عذابٍ يُلهبُ متنَ معاوية، ومَنْ دارَ في فلكه من المنحرفين.
وهكذا عاش الإمام عليهالسلام الصوت الوحيد الذي غدا يرعد أمام كلّ بدعة، والسّوط الفارع الذي بات يُسوِّي كلّ تخلّف أو تطرّف في المجتمع، فلطالما حرّض ذوي الفكر والجاه، وأثارهم على حكومة الضالين، بَيد أنّهم فضّلوا مصالح أنفسهم على مصالح الدِّين، ولَم يحفظوا ذممهم، في حين راحت ذمّة الإسلام ضحيّة كلّ فاجر.
ولطالما خاطر الإمام الحسين عليهالسلام بوقوفه أمام اعتداءات بني اُميّة على مصلحة الاُمّة الإسلاميّة، وعلى مقدّسات الدِّين ونواميسه.
والواقع أنّنا لو أردنا أن نتصوّر الوضع الدِّيني في عصر الإمام عليهالسلام خالياً عنه وعن جهاده، لكنَّا نراه أحلكَ عصر مرّ به المسلمون، وأقساه وأعنفه. ولو كنَّا نتصوّر الإسلام وقد مرّ به ذلك العصر بدون أبي عبد الله عليهالسلام لكنَّا نراه أضعف دينٍ، وأقربه إلى الانحراف.
فلَم يكنْ هناك من قوّة تستطيع الوقوف أمام المدّ الاُموي الأسود، إلاّ شخص أبي عبد الله عليهالسلام ومَن دار في اُفُقه من الأنصار والمهاجرين؛ لأنّ الحروب التي سبقت عصر الإمام عليهالسلام أعلنت عن تجارب سيئة جدّاً، واختبارات فظيعة لقوى الخير في المسلمين، وما كان من شتيتها موجوداً لفّته زوابع الترهيب، وأعاصير الترغيب، فراحت مع التي راحت أوّلاً.
وبقي المحامي والنّصير الأوّل والأخير للإسلام، وهو الإمام الحسين عليهالسلام، الذي استطاع بسداد رأيه ومضاء عزمه، وسبق قِدَمه وسموّ حَسبه ونسبه، وما كان له من مُؤهّلات ورثها من جدّه رسول الله وأبيه عليٍّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليهما) استطاع بكلّ ذلك أنْ يُشكّل جبهة قويّة نسبيّاً أمام الطغيان الاُموي الوسيع.
وكان ذلك شأنه في عصري معاوية ويزيد.
وها نحن قد استعرضنا جانباً موجزاً من عصر معاوية، وسوف أستعرض شيئاً قليلاً عن عصر يزيد في الفصل الأخير، وسوف لا نذهب في سرد القضايا تفصيلاً، بل نجعلها موجزةً لسببين:
أولاً: اشتهار نهضته العظيمة في عهد يزيد حتّى كاد يعيها كلُّ شيعيٍّ مؤمن.
وثانياً: لأنّ ذلك يحتاج إلى موسوعة علميّة كبيرة تُحلّل القضايا السياسيّة والدينيّة التي رافقت نهضة الحسين عليهالسلام، ليظفر من ذلك بأروع أمثلة الجهاد وأرفعها.
وهكذا يحقّ لنا أنْ ندع البحث أبتراً لندخل بحوثاً اُخرى، نتكلّم فيها حول السّمات الشخصيّة لسيّد الشهداء، الحسين عليهالسلام، تاركين جانب الدِّين والسّياسة لمجال أفسح، وفي بحث أوسع4.