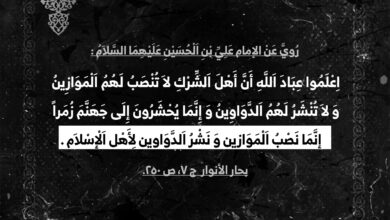على الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاماً على اختفاء الإمام موسى الصدر وغيابه عن ساحات الحياة إلا أن حضوره اليوم ما زال مُبَرراً بقوة، وكلماته ومواقفه وحركته ما زالت مطلوبة بشدة، لأن الإنسان يحتاج على الدوام إلى نور الهداية والرشد في منطقه وحجته، ويحتاج إلى نار الجهاد والمقاومة في دأبه وكدحه. لغته العلمية الرصينة التي أطلَّ بها على ميادين الفلسفة والاقتصاد والفقه والتفسير، ولغته الشعبية البسيطة التي وظفها لتغيير واقع الناس وحال الأمة ساد بهما على العقول والقلوب ليجعل كل عقل مشرعاً أمام حركة الفكر والتأمل ومشاغل الأسئلة، الكلية الهموم والقضايا والأحلام. وليجعل كل قلب يُضيء بالحب والخير والجمال في سبيل احتواء عناصر الاختلاف والتنافر في النظرة إلى الوجود والإنسان.
تعادلية حركته كانت تقوم على إحداث التوازن بين ما تتطلبه الثورة على العدوان والاحتلال والظلم والحرمان والفساد من حماسة وصوت عال، وما تستدعيه الدعوة إلى الحوار لبناء الوطن والوحدة الداخلية من هدوء وتطامن ويُسر ورويّة ولين كلمة. بحيث نجده في موقف يتحدث بصراحة صارخة، ونراه في موقف آخر يستعمل المداراة مع الأصدقاء والرفق الذي لم يُوضع على شيء إلا زانه ولا نُزع من شيء إلا شانه.
يُعبىء القوى وينظم الصفوف ويحشد الجماهير ويعسكر مع المقاومين ويضع معهم الخطط ويقود الحملات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ثم يعود إلى محرابه يصلي ويدعو ويناجي وينادي ربه بصوت حزين، ويغدو إلى أبناء ملته مُتفقداً أوجاعهم وحرمانهم وآخذاً بقلوبهم إلى الحق وملهماً إيّاهم الصبر والثبات.
ثم ينتقل إلى مدن الوطن وقُراه ودساكره يحقن الدماء ويصلح ذات البين ويحاور الأخصام ويحتج عليهم بالعقل والدليل ليحملهم على الطريق الواضح الذي يوافي فيه كل لبناني العزة والكرامة والشرف.
في الحقيقة كان الإمام بالنسبة إلى الوطن ككل كالزهرة التي تفتحت بالأمل. الوطن الذي كان يعيش أشد الأوقات محنة وتجهُّماً وسوداوية مع قلة اجتماع قلوب اللبنانيين الذين استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
فكاد الوحل الطائفي والمذهبي أن يسقط اسم لبنان من خريطة الجغرافيا، وكادت مخالب العدو الصهيوني أن تُحوّل كل بقعة منه مستنقعاً للدماء والأحقاد. فجاءت حركته المباركة لتقيم الوطن على أعمدة الصحة والعافية والوحدة. ينهض ذائداً عن الحرمات والمقدسات والأعراض والنفوس البريئة بجبَّته وعمامته رافضاً كل تقاتل مذهبي وطائفي وحزبي رغم اصواتٍ أجشة رأت في القتل والإلغاء والإرعاب أفعالاً مشروعة للظفر بوطن خاص ولو كان شائهاً وأسوداً ينزّ بالقيح والصديد.
كانت يده حاضرة لتمتد إلى الأيادي البعيدة للمصافحة ولتمسح عن جبين الوطن كل ندوب وحروق العداوات الدموية ولتعالج كل أمراضه وأسقامه السياسية والاجتماعية والثقافية. وبالقدر نفسه كانت يده حاضرة على الزناد للدفاع عن لبنان بشعبه وأرضه ومائه، بجنوبه وجبله وشماله وبقاعه، بعاصمته المشرعة أمام الثوار والأحرار والمناضلين والمقاومين والمجاهدين الذين يجتمعون فيها لاستنقاذ شعوبهم من براثن المستعمرين والمستكبرين.
الإمام الذي كان صاحب إضافات وإبداعات في المنهج الحركي والجهادي والحواري والنهضوي على مستوى الوطن والأمة، كان جسر تواصل وعبور بين الطائفة الشيعية والوطن وبين الوطن والطائفة الشيعية، وبين لبنان والعرب والعرب ولبنان وبين الشعب الإيراني الذي كان يستعد لاستلام السلطة والعرب وقضيتهم الأساس القضية الفلسطينية، بين الشرق والغرب، بين الإسلام والمسيحية بين الإنسان وأخيه الإنسان في سبيل الارتقاء بالوجود والحضارة والأخلاق والقيم إلى مستوى الحياة المحسوسة والمسؤولة. إن ما يحصل في العالم وفي المنطقة وفي لبنان أكثر من ابتئاس وأكثر من خطى في مجرى التراجع. إنها الفوضى في الحيرة، الانحراف عن الهدف، الغرق في التفاصيل المميتة، تلاشي القيم وحضور الباطل في شكل الحقيقة، انعدام المعايير، وشحّ الإيمان. وأيضاً وأيضاً ازدهار متعاظم للظلم والحيف والجور والفساد والغبن، وترسخ ثقافة الاستحواذ والعصبيات والجماعات والتقسيمات في مراوغات عقلية وسياسية ودينية أحياناً لتبرير ما هو سلبي وهجين وخطأ.
الإمام موسى الصدر حاجة اليوم للبنان والأمة والعالم في فكره ومنهجه وأسلوبه، في تواضعه وشجاعته، في هدوئه وحماسته، في عقلانيته وروحانيته، في إيمانه المنفتح على تعددية الرؤى ووسائل المعرفة، على التجارب والأشخاص، على المذاهب والبيئات المتنوعة من أجل الإنسان الذي يفتقد في عصر العلم والآلة والحضارة إلى إنسانيته1.
- 1. المصدر: جريدة السفير 28-8-2010، سماحة الشيخ عفيف النابلسي حفظه الله.