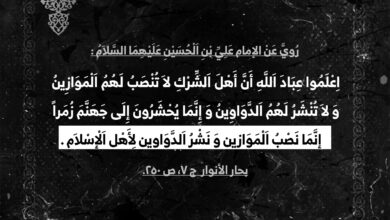” من ملك نفسه إذا رغب و إذا اشتهى و إذا غضب .
” حرم الله جسده على النار”
الإمام الصادق ( عليه السلام )
علمنا ان الخلق الكريم من كل قوة هو التوسط فيها ، وان الإفراط في تلك القوة والتفريط فيها رذيلتان خلقيتان تعملان على هدم تلك الفضيلة ، وعاملان نفسيان يحاولان سد تلك الباب الموصل إلى الخير والمشير إلى طريق السعادة ، ولا يستطيع الإنسان ان يستمر في خلقه الكريم إلا بمحاربة هذين العدوين اللدودين وأشد هما تأثيراً عليه هو أقر بهما إلى نزعاته وأكثرهما موافقة لميوله ، والإنسان في الكثير من أفراده ميّال في نزعاته إلى أحد الجانبين ، وهو في الأكثر من هذا الكثير يميل إلى جانب الإفراط والزيادة .
أما المعتدلون بغرائزهم ، المتوازن في نزعاتهم ، فهم قليل وأقل من القليل .
ولعل هذا وأمثاله يكشف لنا حكمة مستورة في بعض الأحاديث الواردة عن الأئمة من أهل البيت ( عليه السلام ) في الحث على الفضائل التي تقرب بظاهرها التفريط ، فهي تحث على الزهد والقناعة لتقابل الإفراط في بهيمية الشهوة ، وتدعو إلى الحلم والرفق لتحد من وحشية الغضب ، وكم لأمناء الشرع في هذا وأمثاله من كلمة جامعة .
وقد عرفنا أن الاعتدال الخلقي يقوم بملكات أربع يعدها علماء الأخلاق أصولاً للأخلاق الفاضلة ورؤوساً للملكات الصحيحة الفرعية ، فمن الجدير أن نشير إلى بعض خواص هذه الأصول ، ونستعرض جانباً من فروعها لنلم بعض الإلمام بآراء الإمام الصادق ( عليه السلام ) في ذلك .
الحكمة
التوازن العادل في القوة الفكرية هو الحكمة ، والرذيلة التي تقابل الحكمة من جانب التفريط هي الحمق والبلادة ويعنون بها تعطيل القوة الفكرية عن العمل ، وكبت مالها من مواهب واستعداد ، والخسيسة التي تضادها من جانب الإفراط هي المكر والدهاء ويريدون منه التجاوز بالفكر عن حدود البرهان الصحيح ، واستخدام قوة العقل في ما وراء الحق فقد تثبت نتائج ينكرها الحس وقد تنفي أشياء تثبتها البداهة .
ولست أرى أن لفظ المكر والدهاء يدلان على هذا المعنى لأنهما بمعنى الاحتيال والخداع ، وهو شيء آخر وراء الحكمة الباطلة التي يقصدها هؤلاء المفسرون ، أما الدهاء بمعنى جودة الرأي فهو يقرب من معنى الحكمة ، وإذن فلنسم هذه النقيصة الخلقية ( بالحكمة الباطلة ) كما يسميها علماء الأخلاق .
ونحن إذا فحصنا الفضيلة العقلية ( الحكمة ) وجدناها تتألف من عنصرين أساسيين لا غِنَّي لهما عن أحدهما :
- قوة فكرية في طريقها إلى التوازن
- وعلم يرشد هذه القوة إلى طريق الاعتدال
ليس التوازن في القوة الفكرية من الأشياء التي تمنحها المصادفة ، ويكونها الاتفاق ، وليس بالأمر السهل الذي تكفي في حصوله للإنسان خبرة قليلة وتجربة نادرة ، لأنه توازن في كل ما يعتقد ، وتوازن في كل ما يقول ، وتوازن في كل ما يعمل ، وأنى للقوة الفكرية بهذه الاستقامة التامة إذا هي لم تستعن بإرشاد العلم الصحيح ، وأنّى للعقل بمفرده ان يبصر هداه في الطريق الشائك والمسلك الملتوي .
كلنا نتمنى التوازن العادل في طبائعنا والاستقامة التامة في سلوكنا ، وأي أفراد البشر لا يتمنى الكمال لنفسه ولكن الجهل يقف بنادون الحد ، وميول النفس تبعدنا عن الغاية ، والعقل هو القوة الوحيدة التي يشيع فيها جانب التفريط بين أفراد الإنسان ، وذلك من تأثير الجهل ، فالجهل أول شيء يحاربه علم الأخلاق ، لأنه أول خطر يصطدم به الكمال الإنساني ، وأول انحطاط تقع فيه النفس البشرية ، وأول مجرّئ لها على ارتكاب الرذيلة ، بل هو أول خطيئة وآخر جريمة .
يرتكب الجاهل أخطاء خلقية تعود بالضرر على نفسه وقد يعود ضررها على أمة وشعبة أيضاً ، وعذره في ذلك أنه جاهل ، وإذا كان الفقيه لا يعد الجهل عذراً في مخالفة النظام الشرعي ، فإن الخلقي أجدر أن لا يقبل ذلك العذر لأن الفقه اسلس قياداً والفقيه أكثر تسامحاً أما العالم الخلقي فإنه يطبق نظامه بعنف ، ويقرر نتائجه بدقة ، ولا يجد في المخالفة عذراً لمعتذر ، ولا سيما إذا كان ذلك العذر أحد المحظورات الخلقية كالجهل .
وإذن فمن الرشد أن يكون العلم أول شيء يفرضه علم الأخلاق ، ومن الحكمة ان يقول النبي العربي ( صلى الله عليه و آله ) ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) وأن يقول وصيه الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إِني لست أحب أن أرى الشاب منكم إِلا غادياً في حالين : أما عالماً أو متعلما ، فإن لم يفعل فرًط ، فإن فرَّط ضيّع ،فإن ضيّع أثم ، فإن أثم سكن النار والذي بعث محمداً بالحق ) .
الشباب دور القوة والعزيمة ، وعهد الطموح والرغبة ، وزمان الجد والعمل والشباب دور تكامل القوى ، وتوثب النزعات ، وبعد ذلك كله فالشباب هو الدور الأول الذي يتسلم فيه الإنسان قيادة نفسه ، ويختص به تهذيب خلقه وتثقيف ملكاته ، ولعل المربي قد أساء الصنع بتربيته فأنجد في الطريق وأتهمت الغاية ، ولعل البيئة أعدت غرائزه لما لا يحمد فأضافت إلى النقص نقصا ، وجمعت النار حطباً ، وللنفس في ظل الشباب أماني وأحلام ، وللشاب دافع من الشهوة ومحفز من الطموح وقائد من العزيمة ، والقوة كما قيل مبدأ شرور أو مصدر خيرات .
القوة أداة عاملة تثمر الخير وتنتج السعادة إذا دبرتها الحكمة ، وقادتها المعرفة ، وهي على الضد من ذلك إذا قادها الجهل ، وحركتها العاطفة واستخدمتها الميول ، أما العقل الذي عهد إليه بإتباعه فهو لا يزال في عهد فتوة جديدة ، وفي ابتداء سياسة مستحدثة ، وهو في هذه الحكومة الفتية قليل الأنصار والجند ، قليل التجربة والحنكة ، وضعف الحاكم عامل قوي يتخذ منه الطائش مبرراً لعلمه ، وينتهزه القوي فرصة لتحكماته ، فكيف تكون نتيجة هذا الشاب المسكين ، وما الذي ينتهي إليه أمره .
سيقسط في أخلاقه ثم يسقط ، وسيخسر أعز شيء عليه في الحياة من حيث لا يشعر بألم هذه الخسارة لأنه يجهل وبالأخرى لأنه لا يحس .
والحل الوحيد لهذه المشكلة أن يجعل لعقل ذلك الشاب من العلم الصحيح مسعداً ؛ ومن الحكمة الصالحة معيناً ليصبح قوياً بعد ضعف ، وكثيراً بعد قلة ، وعاملاً بعد خمود ، على أن التجربة والوجدان ومقررات علم النفس تشهد بأن التعلم في السن الباكر أبلغ في التأثير وأعظم في الاستفادة .
ويقول الإمام الصادق( عليه السلام ) أيضاً : ( لا يفلح من لا يعقل ولا يعقل من لا يعلم وبين المرء والحكمة نعمة العالم والجاهل شقي بينهما ) وهذه الكلمة على قصرها تتضمن نتيجة البحث وصفوة القول في المورد ، ويقول أيضاً : ( لوددت أن أصحابنا ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا ) أرأيت كيف يفرض العلم على أصحابه فرضاً ، ثم يتمنى أن يستعمل القوة في تطبيق ذلك الفرض ، ولكن العلم الذي يفرضه على أصحابه هو العلم الذي يأخذ بيد الإنسان إلى السعادة ، ويرقى به إلى الكمال النفساني ، ويقول في حديث آخر : ( كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل ) .
شجرة كريمة المنبت ؛ طيبة الإنتاج ، نمت جذورها وزكت تربتها, ولكنها لا تأتي بالثمر الطيب إذا لم تسعف باللقاح المناسب؛ تلك الشجرة هي العقل ؛ وثمارها هي الأخلاق الفاضلة والسلوك الحسن ، أما لقاحها فهو كثرة النظر في الحكمة؛ هكذا يقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في هذا الحديث ، وهكذا يكون العلم هو اليد الأولى في تأسيس الفضيلة الأولى والساعد القوي الذي يمهد قاعدة الخلق الكامل .
ومن الجهل ما يسمونه بالجهل المركب وهو جهل يشبه العلم في الصورة وشؤمه على الإنسان أشد من الجهل البسيط ، لأنه مؤلف من جهلين والجهل رذيلة كبرى إذا كان مفرداً فكيف إذا كان مكرراً والجاهل المركب عالم في اعتقاده و عمله صحيح في رأيه ولذلك فهو يرتكب الأخطاء ويعمل القبائح ولا يسمع نصح ناصح ولا يصده عذل عاذل .
ليقل القائلون ما شاؤوا وليخطئوه في عمله إذا أرادوا ، وماذا عليه من نصح الناصحين وعذل العاذلين إذا هو أرضى عقيدته ، وأقنع ضميره ، أنهم هم المخطئون فيما يقولون .
بهذا يعلل الجاهل المركب أعماله وأخطاءه من حيث لا يعلم ان على عينيه منظاراً يلون له الحقائق وعدسة تقلب له الصورة ،من أين له بالمرشد الخبير الذي يعرفه ان هذا اللون الذي يراه هو للمنظار لا للحقيقة ، وان الانقلاب إنما هو في العدسة لا في الصورة ، لينكشف له الحق على صورته أوـ على الأقل ـ ليعلم أنه لا يعلم .
ويحدثون عن أحد الخبثاء أنه أشترى حماراً متأنقاً لا يأكل غير النبات الطري وان يبلغ به الجهد وأمض به الجوع ، فأعيى صاحبه منه ذلك لأنه لا يجد النبات الطري في كل وقت فاحتال على الحمار وألبسه منظاراً كبيراً أخضر ثم قدم له مقداراً من التبن المبلول ، فشرع الحمار يأكل واخذ صاحبه يضحك .
ليأكل الحمار من النبات الأخضر الطري في عقيدته وماذا عليه إذا رآه الآخرون تبناً أصفر مادام هولا يرى ذلك . أنهم واهمون وأنهم مخطئون .
لا يلام الإنسان إذا ارتكب عملاً فاسداً وهو يعتقد بأنه عمل صالح إذا هو لم يقصر في البحث ، ولكن هذا لا يكفي لتثقيف نفسه وتهذيب ملكاته ، وإذن فالعلم الذي يكون مصدراً للأخلاق الفاضلة هو الذي يوافق الواقع المعلوم ، هو اليقين واليقين فقط .
نعم هو اليقين ( الذي يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب ) كما يقول الإمام الصادق( عليه السلام ) وهو النور الذي قال فيه : ( فإن كان تأييد عقله من النور كان عالماً وحافظاً ) وهو الحكمة التي يقول فيها : ( كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل ) .
ومن آثار هذا اليقين اطمئنان نفس الإنسان وخلوده إلى السكون ، والرضا في كل ما يعطى وفي كل ما يمنع ، فإن : ( من صحة يقين المرء المسلم أن لا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم بما لم يؤته الله ) .
العدل
قوة العمل مبدأ كل سلوك ومصدر كل خلق وقد تكرر في الفصول السابقة ان العدل هو مشايعة قوة العمل لقوة العقل وان العادل هو الذي يتبع إرشاد العقل في كل ما يقول وفي كل ما يعمل .
وقد علمنا أن قوة العمل هذه لا تختص بها ملكة معينة من الأخلاق ولكنها تكون جميع الملكات التي تنسب إلى القوى الأخرى حتى سلوك العقل نفسه ، وان التوازن في قوة العمل توازن في جميع الملكات والانحراف فيها انحراف في سائر الأخلاق ، والإمام الصادق( عليه السلام ) يقدر هذه النتيجة بعينها حين يسأل عن صفة العدل في الإنسان فيقول : ( إذا غض طرفه عن المحارم ولسانه عن المآثم وكفه عن المظالم ) . لا يكون الإنسان عادلاً حتى يخضع الشهوة لحكم العقل فيغض طرفه عن المحارم ، ويلجم الغضب بلجام الحكمة فتترفع نفسه عن المظالم ، وصفة العدل هذه هي التعفف بمعناه العام ، وضبط النفس الذي يقول فيه : ( من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا غضب حرم الله جسده على النار ) وأكثر أخلاقيات الإمام الصادق ( عليه السلام ) تشير إلى هذا المعنى ولو من ناحية خفية .
لكل واحدة من قوى النفس وغرائزها حقوق يجب أن توفى إليها كاملة غير منقوصة ، ولكل منها ميول شاذة يجب أن يضرب من دونها ألف حجاب ، وضبط النفس هو تعادل هذه القوى في السلوك وتساويها في الحقوق فتأخذ كل قوة ما يجب لها وتمنع عما يحظر عليها .
وأكثر الملكات المعتدلة ـ إِن لم نقل جميعاً ـ إِنما تكون بتعاون جميع القوى النفسانية . فالتوازن في قوة الشهوة مثلاً يفتقر إلى قوة العمل في تكونه ، ويحتاج إِلى قوة الفكر في تحديده وتمييز غايته ، وإلى الشجاعة في الثبات عليه وتحمل الآلام في سبيل الحصول عليه ، العفة كبنت الميول المتطرفة من قوة الشهوة ، وقمع الرغبات الشاذة منها إلا أنها لا تحصل للشخص إذا لم يكن له من الشجاعة ما يتحمل به ألم ذلك الكبت ، ومن الثبات وقوة الإرادة ما يستمر به على تلك الاستقامة ، فضبط النفس في الأكثر مزيج من قوى متعادلة في الحقوق ، متفاضلة في التأثير ، وبعض هذه القوى إيجابي وبعضها سلبي وإنما قلنا في الأكثر لأن بعض الملكات العقلية لا يحتاج إلى قوة الشهوة مثلاً .
بقي علينا أن نعرف معنى هذا الاختصاص الذي يذكره علماء الأخلاق ، ويصرون عليه كثيراً ، فإن الاستقامة في الخلق إذا كانت لا تحصل إلا بمساعدة أكثر من قوة واحدة فلماذا يختص بعض الفروع ببعض القوى ؟ ولماذا تعد العفة من ملكات قوة الشهوة فقط ؟ ويكون الحلم من فروع قوة الغضب خاصة ؟
والسر في ذلك أن الملكة الخلقية هي تلك القوة التي تنسب إليها بعد أن يدخل عليها التهذيب ، فالعفة شهوة مهذبة , والشجاعة غضب متوازن ، والحكمة فكر مستقيم .
ومن هذا التعاون النفساني المتقدم يظهر لنا معنى قول الإمام الصادق( عليه السلام ) في بعض وصاياه لأصحابه : ( عليكم بالورع وصدق الحديث وأداء الأمانة وعفة البطن والفرج تكونوا معنا في الرفيق الأعلى ) . ملكات خمس يوصي الإمام أصحابه بالمحافظة عليها ليكونوا معه في الرفيق الأعلى من الجنة ، وإذا نظرنا إلى هذه الملكات رأيناها تنتهي إلى قوة واحدة ، أو إلى قوتين لا غير ، فإن الورع ينتهي إلى الشجاعة إذا كان ورعاً عن نزغات الغضب ، وإلى العفة إذا كان ورعاً عن ميول الشهوة ، وصدق الحديث أيضاً قد ينتهي إلى هذه وقد ينتهي إلى تلك؛ أما الملكات الثلاث الباقية فهي من فروع العفة لا غير ، ولكن الإمام يضمن لأصحابه أن يكونوا معه في الرفيق الأعلى إذا اعتدلوا في هذه الملكات الخمس .
هو توازن في قوة الشهوة ولكنه يلازم اعتدالاً في قوة الغضب ، واستقامة في قوة الفكر ، يستحيل على المتهور أن يكون ورعاً ، وعلى الجبان أن يلتزم صدق الحديث . أما العقل ـ وهو المرشد إلى ذلك التوازن ـ فلا بد وان يكون معتدلاً أيضاً . على أن الورع الذي يبتدئ به هذه الكلمة قريب المعنى من التعفف وضبط النفس والأخلاق التي يعددها ملكات عامة تظهر آثارها في جميع الأعمال والأقوال فإذا استقامت هي كان الإنسان مستقيماً في أقواله وأعماله ، ومن أولى من الإنسان المستقيم بالرفيق الأعلى .
العدل وضع جميع القوى تحت نفوذ العقل فيعطي كل واحدة من هذه القوى حقوقها كاملة فإذا عمل الإنسان ذلك مع الناس الآخرين سميت هذه الصفة منه إنصافاً وعدلاً بمعناه الخاص .
وهذا العدل هو أساس الملك العادل ومحور المدينة الفاضلة والمجتمع المثالي ، وهو قد ينتهي إلى العفة وقد يكون من الشجاعة ويقابله من جانب الإفراط الجور على الغير والتعدي على حقوقه ، ومن جانب التفريط إهمال الحقوق المحترمة للنفس وكلاهما جرثومة لكثير من الأخلاق الفاسدة .
والعدل يكون صفة للفرد ويكون صفة للمجتمع .
العدل الفردي
للعدل الذي يوصف به الفرد مرتبتان تظهر أحدا هما في سلوك الشخص مع الناس الآخرين ومعاملاته معهم ، فإذا أخذ الإنسان حقه كاملاًً وأعطى الغير حقه موفوراً سمي عند الخلقيين عادلاً ومنصفاً ، وفي هذه الصفة يقول الإمام الصادق( عليه السلام ) : ( سيد الإعمال ثلاثة : إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضي بشيء لنفسك إلا رضيت لهم بمثله ) .
ومن الناس من يتشاءم إلى حد بعيد من التشاؤم فيعد العدل في الإنسان مستحيلاً أو هو شيء يشبه المستحيل ، فالإنسان وحش متمدين .
والظلم من شيم النفوس ، فإن تجد *** ذا عفة ، فلعلة لا يظلم
ويذهب بعض هؤلاء المتشائمين إلى أكثر من هذا ، فيقولون : ( الظلم سر كامن في الطبيعة ، فالنبات يعدو قويه على ضعيفه والحيوان يفتك كبيرة بصغيره والإنسان يستبد حاكمه بمحكومة ) وهذه الفكرة وليدة عن القول بأن الإنسان شرير بالطبع والفلاسفة منقسمون حول هذا الرأي ، والشرع يؤيد المذهب المعتدل في ذلك ، ويجد الباحث المتتبع شواهد كثيرة على ذلك من أقوال الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
لا ينكر المتشرعون شيوع الظلم بين أفراد الإنسان ، ولكنهم يقولون : مصدر ذلك هو إهمال الغرائز النفسانية حتى تستبد بالحكم ، وإعطاء النفس قيادها لتسير مع الأهواء بلا رقيب ولا حسيب ، أما نفس الإنسان وغرائزه فهي مهيأة للمسير في طرق الخير وطرق الشر حسب ما يرتضيه له سلوكه وترسمه له أرادته واختياره ، ولو تعاهد الإنسان غرائزه بالتهذيب والإصلاح لسارت نفسه على الهدى ، وحقيقت له العدل بجميع معانيه ، ولعل الحكيم العربي لا يريد أكثر من ذلك في بيته المتقدم .
والمرتبة الثانية من العدل الفردي تظهر في الفصل بين المتخاصمين بإعطاء الحق لصاحب الحق من غير حيف ولا تحيز, وعدالة القاضي هذه عند الإمام الصادق( عليه السلام ) مظهر من مظاهر العدل النفساني لأنه يقول : ” من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره ” وهذا أفضل ما يوصف به الحاكم العادل والقاضي المصلح ، وهل يتصور التحيز في الحاكم إذا أنصف الناس من نفسه ، وهل ينسب إليه الحيف إذا كان أحب الناس إليه وأبغضهم عليه أمام عدله بمنزلة واحدة ؟ وإذا علمنا أن العدل في المعاملة يلازم العدل الخلقي العام وجدنا أن العدل في رأي الإمام ( عليه السلام ) سلسلة واحدة يتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً لا تفكك بين أجزائه .
أقول : إن العدل في رأي الإمام سلسلة واحدة ، لأنه يشترط في الحاكم أن ينصف من نفسه قبل أن ينتصف من غيره ، ثم يقول إن الإنصاف من النفس أشد الأعمال أو هو من أشدها ، ويحدثنا عن أبيه النبي ( صلى الله عليه و آله ) : ” من واسى الفقير وأنصف الناس من نفسه فذلك هو المؤمن حقاً ” وقد عرفنا فيما تقدم أن المؤمن حقاً هو الإنسان الكامل الذي توازنت ملكاته واعتدلت أخلاقه ، على أن اشتراط العدالة الشرعية في القاضي من المقررات الواضحة في المذهب الجعفري .
ثم هو يوضح ذلك إيضاحاً لا يقبل التشكيك حين يقول : ” اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ” الحكومة حق خاص للولي العام ، العالم بالقضاء والعادل الأول في المسلمين ، فلا تجوز لغير العالم بالقضاء ، ولا لغير العادل من المسلمين ، هكذا يقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في صفة الحاكم ، وهكذا يجب أن يكون .
الحاكم هو المثل للعدل الديني أو المدني في الحقوق والدماء ، ومن الممتنع أن يمثل العدل جائر ، والحاكم أمين الأمة على مقدراتها وأمين السلطة على رعاياها ، ومن القبيح أن يؤتمن خائن ، وإذا عجز الإنسان أن ينتصف لنفسه من نفسه ، فهو عن إنصاف من غيره أعجز ، وإذا كانت نفسه أول رافض لحكمه فإن غيره أولى برفضه وأحق برده ، ولأمر ما حذرت الشريعة الإسلامية أن يصدر القاضي حكمه وهو غاضب .
ويقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) ” لسان القاضي وراء قلبه ، فإن كان له قال وان كان عليه أمسك ” أجل إن لسان القاضي من وراء قلبه ، والله من وراء قلبه ولسانه ، وكم يهدم القاضي من صرح ، وكم يقوض من دعامة بكلمة يقولها غافلاً أو يصدرها غاضباً ، وفي هذا الحديث تحذير شديد من التسرع والاستعجال ، فإن الحكم الجائر يكون على الحاكم قبل ان يكون على المحكوم . والحكم العادل يكون له قبل أن يكون للمنتصر .
أما الرشوة على الحكم . . . ، أما بيع الضمير . . . والدين . . . ، والقانون ، واحترام النفس . . . ومقدرات الأمة . . . واعتماد السلطة ، أما سحق جميع المقدسات بالقدم بإزاء ثمن حقير يسمى بالرشوة فهو الدناءة في الهمة ، والحقارة في النفس ، والحياة للمجتمع ، وهو السحت المحرم في كل نظام وعلى لسان كل مشرع ، وهو الكفر بالله العظيم في قول الإمام الصادق( عليه السلام ) .
وللعدل عدو جائر قد يلبس ثوب الصديق ، وهو التحيز والممالاة ، فقد يجور المحاكم من حيث أنه يظن العدل ، ويظلم من حيث أنه يعتقد الرحمة ، وللحب القلبي والمظاهر الخارجية في ذلك أعظم الأثر .
من السهل على النفس إذا أجبت ان ترتكب ثم تعتذر ، وان تفعل ثم تتعلل ، لترضي الوجدان المكبوت ، وتسلي العدل المرغم ، وقد يخادع الضمير بتلك المعاذير فيقبل ، ولكن العدل يسجلها صحيفة سوداء في ديوان الخائنين ، والحاكم مسؤول عنها أمام الله ، وأمام القانون الأدبي .
ومن هذه الناحية نجد فرقاً كبيراً بين عدل القضاء وعدل المعاملة ، فإن الحب والميل القلبي قد ينافيان عدل القضاء لأنهما يثمران التحيز والمحاباة . أما العدل في المعاملة فإنه يزكو على الحب, ويتكامل على الود لأن المحب لا يجور على حبيبه ، والصديق لا يظلم صديقه ، وكثيراً ما بعث الحب على إيثار ، ولعل هذا هو السر الأول في الحث على الحب الذي بالغت فيه الشريعة الإسلامية ، وندب إليه أمناء الوحي ، والذي يقول فيه الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ” هل الإيمان إلا الحب” ، ويقول : ” إن المسلمين يلتقيان فأفضلهما أشدهما حباًَ لصاحبه” وللحب والصداقة بحث سيأتي .
العدل الاجتماعي
يولد الإنسان وينمو ، ويترعرع ويشب ، ويتقلب في أدواره ، ويتنقل في أطواره ، وهو في جميع هذه الأحوال جزء من المجتمع الذي أحاط به ، والإنسان مدين للمجتمع في أكثر صفاته وشيمه ، فهو الذي حدب عليه وليداً ، و غذاه طفلاً وتعاهده بالتوجيه يافعاً ، وهو الذي لقنه اللغة في طفولته ومهد له طريق التعلم في صباه ، وهيئة أسباب المعيشة في شبابه ، وهو الذي علمه كيف يفكر وكيف يعمل ، وكيف يأخذ ، وكيف يعطي .
أكثر خصال الإنسان عادات يكتسيها من بيئته ، وأكثر غاياته ميول يرثها عن أسلافه ، وأكثر علومه نتائج يقتبسها من مرشديه ، والاجتماع هو الصلة المتينة التي تجعل المجتمع كالجسم الواحد الحي ، وتجعل الأفراد كالأعضاء لذلك الجسم ، يقوم كل عضو منها بما يخصه من الأعمال التي تصلح المجتمع ، ولذلك فالأفراد مشتركون في الغاية ومتماثلون في الحقوق والواجبات ، ورقي الفرد في شخصيته الاجتماعية بمقدار ما ينتج لهذا المجتمع من خير ، وما يؤدي إليه من ثمرة طيبة ، وسقوطه فيها بمقدار ما يأتيه من شر وعمل فاسد ، وقد يتمادى عمل السوء ببعض الأفراد فيكون كالأعضاء الموبوءة التي يجب فصلها عني الجسم وقاية له من شرها .
المجتمع جسم حي مدرك ، له حياته الخاصة ، ولحياته نظامها الخاص ، وهو يتصف بالتوازن والانحراف في سلوكه كما يتصف الفرد الواحد من الناس ، والنظام الاجتماعي العادل هو الذي يكفل للمجتمع ولإفراده على السواء جميع الحقوق والواجبات من غير تعد ولا تقصير ، فإذا سار المجتمع على ذلك النظام العادل ، وطبقه على سلوكه وسلوك أفراده سمي ذلك التوازن منه عدلاً اجتماعياً .
العدل الاجتماعي أن تسير الأمة إلى المثل الأعلى في الحياة وفي الأخلاق ، وان تسعي ما أمكنها السعي إلى السعادة العامة والكمال المطلوب ، وان تعد للإفراد طرق الوصول إلى الخير ، فتنشئ المؤسسات الكافلة لخير البلاد والحافظة لخيراتها وتؤسس المعاهد الصالحة لأعداد الرجال وتثقيفهم بالثقافة الصحيحة ، وان تتمسك بالأنظمة الشرعية الموجبة لحفظ الحقوق وسلامة النفوس ، على أن تسير في جميع ذلك وفق النظام الصحيح ، والحكمة الرشيدة التي يأمر بها العقل ، ويقرها الشرع .
وتعاون أفراد الأمة وتضامنهم أعظم موجب لتحقيق هذا العدل وأبلغ مؤثر فيه ، ويقول المتأخرون من الخلقيين إن المسؤول عن تحقيق هذه الغاية هي الحكومة التي تسيطر على الأمة وتتحكم في مقدراتها . أما أفراد الأمة فيقعون في الدرجة الثانية من هذه المسؤولية ، ووظيفة الفرد هي مساعدة الحكومة في تحقيق الغاية بما يمكنه من الوسائل .
وهذا الرأي بين النقص لأن العدل الاجتماعي هو التوازن التام في سلوك المجتمع وسلوك أفراده ، وتعاون الجميع على العمل في سبيل الخير واكتساب الصفات الخلقية المثلى ، ونيل السعادة العامة ، وهذا كله من مختصات المجتمع نفسه ومختصات أفراده ، أما ما تقوم به الحكومة من إنشاء المؤسسات والمعاهد الصالحة فهم أحد مقدمات العدل الاجتماعي .
والإمام الصادق( عليه السلام ) يرى ان الوسيلة الوحيدة لإنشاء هذا المجتمع المثالي هو إصلاح الأفراد وأعدادهم لأن يكونوا أعضاء صالحين ، وتزويد كل فرد منهم بما يجب عليه للأسرة وللمجتمع ، فإذا صلح الفرد وتهذبت الأسرة صلحت الأمة ، وتوجهت إلى سبيل الخير والسعادة ، وإذا أحتاج المجتمع بعد ذلك إلى شيء كان العدل الثابت للإفراد دافعاً لهم إلى التعاون والتضامن ، وهذا هو المنهج الذي سلكه القرآن لإصلاح البشر و تهذيهم .
يقول الإمام ( عليه السلام ) : ( يحق للمسلمين الاجتهاد في التواصل والتعاون على التعاطف والمساواة لأهل الحاجة ، وتعاطف بعضهم على بعض حتى تكونوا كما أمركم الله رحماء بينكم متراحمين مغتمين لما غاب عنكم من أمرهم ) ويقول : ( ما قدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها غير متعتع ) .
وقد سمعنا الكثير من إرشاداته للفرد ، وسيأتي ما هو أكثر ، وقد قال في ذلك أيضاً : ( إن استطعت أن تخالط أحداً من الناس إلا كانت يدك العليا عليه فافعل ) والبلد العليا هي التي تبتدئ بالمعروف وتسدي الإحسان ، وتؤدي حقوق الغير إليه كاملة ، وقد سمعنا قوله : ( سيد الأعمال ثلاثة : إنصاف الناس من نفسك حتى لا ترضى بشيء لنفسك إلا رضيت لهم بمثله ) .
ويقول في تهذيب الأسرة : ( إذا لم تجتمع القرابة على ثلاثة أشياء تعرضوا لدخول الوهن عليهم وشماتة الأعداء بهم وهي ترك الحسد فيما بينهم لئلا يتحزبوا فيتشتت أمرهم ، والتواصل ليكون ذلك حادياً لهم على الألفة ، والتعاون لتشملهم العزة ) وهو يتدرج في حديثة عن تآلف الأسرة تدرجاً طبيعياً ، فأول مراحله هو نبذ التحزب والتفرق ، وأهم أسباب التحزب هو الحسد ، ولاسيما إذا كان الأقوياء فيجب نبذه لأنه يشتت الأمر ويفل الحد ، والمرحلة الثانية هي التواصل والبر لأن التواصل يسبب الألفة والمحبة ، وهذه هي المرحلة الثالثة وهي الأخيرة وواجب الأسرة فيها هو التعاون بين الأفراد في كل مهمة ليعيشوا أعزاء في جماعتهم وأفرادهم .
أما الحكومة وممثلها التام في عصر الإمام الصادق ( عليه السلام ) هو السلطان فإن الإمام يفرض عليه في إدارته : ( حفظ الثغور وتفقد المظالم واختيار الصالحين لا عمالهم ) ويلزمه لرعيته : ( بمكافأة المحسن ليزداد رغبة في الإحسان ، وتغمد ذنب المسيء ليتوب ويرجع عن غيه وتألفهم جميعاً بالإحسان والإنصاف ) وللإمام فيما يشبه هذا كلمات كثيرة تحدد واجبات السلطان ، ووظائف الأمراء وفروض الرعية .
وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذه الكلمات وأمثالها إنها نصائح من الإمام( عليه السلام ) يرشد بها خلفاء عصره ومن يشابههم في الحكم ، ولا يسعنا أن نعتبرها رأياً للإمام في الحكومة المثالية التي ينشدها للمجتمع المثالي .
أما الحكومة المثالية في رأي الإمام فهي فكرة كبيرة ضعف قلب الزمان عن تحقيقها ، وصغر الزمان عن احتمالها فطواها في مهدها يوم لف النبي ( صلى الله عليه و آله ) في أكفانه ، وبقيت أمنية مكبوتة في قلب الإمام الصادق ( عليه السلام ) وفي قلوب زعماء الإنسانية من آبائه وأبنائه ، هي حكومة أسسها الله يوم أسس الدين ، وشرع نظامها يوم أنزل القرآن ، وسمى خلفاءها يوم بعث محمداً بالرسالة ، وهي حكومة غرس النبي بذرتها يوم غرس التوحيد ، وتعاهدها يوم تعاهد الأمة بالوصايا ، ولست أقول إنه أثم العهد للخليفة الأول يوم الغدير ، فهذا شيء قد لا يسيغه بعض القراء فقد تجاهله التأريخ من قبل هذا ، وتجاهلته الأمة من قبل التأريخ ، فقلبت النظام يوم انقلابها ، وأسقطت من القائمة أسماء لتثبت مكانها أسماء .
نحن لا نتنكر للتأريخ حين يثبت ما كان وحين ينفي ما لم يمكن ، ولكننا ننكر عليه حين يمده المؤرخ من وراء العقيدة وحين يمده من وراء السياسة ، وكم لعبت السياسة في التأريخ أدواراً في عصوره الأولى ، وتبعتها العقيدة على الأثر تمحو ما تمحو وتثبت ما تثبت ، ولو قدر البقاء للدعاية الأموية الأولى بعد يوم الحسين( عليه السلام ) ويوم الحرة لعفيِّ أثرهما في التأريخ .
لتبق هذه الحكومة المثالية أمنية مكبوتة في قلب الإمام الصادق( عليه السلام ) وليسدل ستار الكتمان على عهد النبي الأخير ، ولتتحول الخلافة الإسلامية ملكاً عضوضاً بعد عهد الخلفاء الراشدين فإن هذا لا يقلل من سعي الإمام في تهذيب الأمة ، ولا يضعف من دعوته إلى إنشاء المجتمع العادل .
العفة
يقول القدماء من علماء الأخلاق : الشهوة أول قوة يعرفها الإنسان في حياته ، والغضب هو القوة الثانية ، ويسمون الأولى قوة الجذب ، والثانية قوة الدفع ، وهم يؤسسون على هذا الترتب الوجودي بين القوتين نتيجة علمية لها أثرها في تهذيب الملكات وإصلاحها . يقولون ان الشهوة أول قوة يعرفها الإنسان ، فيجب أن تكون هي أول قوة يباشر الإنسان في تهذيبها ، ويقررون ان إصلاح الملكات على هذا الترتيب أسرع في الأثر وأسهل في الإنتاج .
ونحن نجد الإمام الصادق ( عليه السلام ) في بعض أخلاقياته يقدم ملكات قوة الشهوة على ملكات الغضب عند التعداد فقد سمعناه يصف لنا العدل فيقول : ” إذا غض طرفه عن المحارم ولسانه عن المآثم وكفه عن المظالم ” ويقول : ” المؤمن من طاب مكسبه ، وحسنت خليقته وصحت سريرته ، وأنفق الفضل من ماله ، وامسك الفضل من كلامه ، وكفى الناس شره ، وأنصف الناس من نفسه” وسمعناه يقول ما يشبه هذا في كلمات أخرى ، فهل يصح لنا أن نعد هذا تقريراً من الإمام لهذه النتيجة ؟
ليس من الحق ذلك لأن التقديم في التعداد غير وجوب التقديم في التهذيب . على أن الإمام ( عليه السلام ) قد يقدم فروع الغضب في بعض أخلاقياته الأخرى .
الرذائل الخلقية جرائم فتاكة يجب دفعها عن النفس مهما أمكن الدفع وسموم قاتلة يلزم الحذر منها ما أمكن الحذر وجميع النقائص الخلقية في هذا الحكم على السواء ، ولا فرق بين القوى منها والضعيف ، والأول والآخر ، والحكمة في تقديم بعضها على البعض مختلفة جداً .
من الناس من يكون قوي الإرادة حازم النفس ، ومن الخير لهذا الصنف من الناس ان يبتدئ بإصلاح ملكاته القوية لأن تأخيرها مظنة للفساد الخلقي العام . هذا إذا لم يتمكن من إصلاح جميع ملكاته دفعة واحدة .
ومن الناس من يكون ضعيف الإرادة واهن النفس ومن الصواب له أن يبتدئ بإصلاح الضعيف من صفاته ليثمرِّن به على جهاد القوي . وهذا الرأي وان لم نجد فيه قولاً صريحاً للإمام الصادق( عليه السلام ) إلا أن النظرة الفاحصة في أقوله تؤكد لنا أن هذا خلاصة مذهبه في تهذيب الأخلاق .
قد تستبد الشهوة وتشذ وتتمرد على حكم العقل ، وتسيطر على قوة العمل فتسمي هذه الشهوة المتمردة شراهة ، ويكون تمردها هذا انحرافاً في الخلق ، ويتكون من إهمال الغريزة وإعطائها الحرية الكاملة فتصنع ما تريد ، وللسعي وراء الملذات التافهة والشهوات الرذيلة أثر بالغ في تنمية هذا الشذوذ وتربيته ، فإن حرية الشهوات تجعل الحر عبداً مملوكاً ” ومثل الدنيا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشاًَ حتى يقتله” والمراد من الدنيا في هذا الحديث هي شهواتها وملذاتها .
ومن البهائم قسم يشبه الإنسان في الصورة ، ويلحق به في التعداد ، وهو يناقضه في العمل ويباينه في السلوك ، يرتكب مالاً ترتكبه البهيمة ، ويعمل ما يخجل الإنسانية ، ويعلل إعماله بأن الإنسان خلق ليكون حراً فليحطم كل قيد وليكسر كل غل ، وليثر في وجه كل عادة ودين . الدين يقف في وجه الحريات فلينبذ ، والعادات نجدد سلوك الإنسان فلتسقط ، وأخيراً هي عادات غريبة يجب على المتمدين ان يسايرها وفقا للتطور ونبذاً للقديم .
مساكين هؤلاء قد سرى الاستعمار الغربي حتى إلى نزعاتهم ، وأثر المستعمرون حتى في مجاري تفكيرهم ، والمستعمرون دهاة مكرة يعرفون كيف يغزون عقول الضعفاء من طريق الشهوة ومظاهر الحرية ليأخذوا من قلوبهم كما أخذوا من رقابهم وأموالهم ، وأنى لهؤلاء المساكين بأن ينقلوا عادات الغرب إلى الشرق ، وأنى لهم أن يسايروا المتمدين في كل ما يعمل ، وإذا كان في الغرب ساقطون يعملون مثل هذه الأعمال ، فأن فيه عقلاء يترفعون عن الدنايا ويتنزهون عن الخسائس .
خلق الإنسان ليكون حراً في الفكر حراًَ في الحقوق ، لا ليعبد الشهوات باسم الحرية ، ويقلد البهيمة باسم نزع التقليد ، ولا أقول أكثر من هذا لأنه لا يدخل في منطقة الباحث الخلقي .
وهنا لون من إفراط الشهوة ، ولكنه لون أحمق ـ إذا صح ان نصف الألوان بالحماقة ـ أقول هو لون أحمق لأنه مشوه الغاية ، مضطرب النتيجة ، ولكنه رغم جميع ذلك شائع جداً ، ولا سيما في الطبقة المترفة التي تدعي الرفعة ، وتتولى رعاية الأمور ، وهذا اللون هو تعاطي المسكرات .
أرأيت الإنسان بشحمه ولحمه يدخل الحانة ليهب عقله بلا ثمن ، ويشتري الجنون منها بالمال ؟ أرأيت من يساوم على مقدساته ومقدراته بهلة من الكأس ورشفة من العقار ؟ أرأيت الإنسان يتمعك كما يتمعك الحمار ، وينبح كما ينبح الكلب ، ويعربد كما يعربد المجنون ، ثم يدعي بعد ساعة أنه من رؤوس العقلاء ومن قادة المفكرين ، وقد يتصدى لمهمات الأشياء ويتسلم مقاليد الأمور ؟
هو في نشوة من سكره ، ولذة من خياله ، وماذا عليه إذا سلم ثمنها مضاعفاً من عقله ، وماله وبدنه وراحته ودينه ، فإنه يبيح جميع ذلك لنفسه ، وماذا عليه إذا تمتم في كلماته ، وتخاذل في حركاته ، فإنها بعض نواحي اللذة ، وأحد مظاهر الحرية التي ينشدها المتدينون من أمثاله ، وليكن منزله جحيماً مستعراً للأسرة ، فإن الحانة جنة له وارفة الضلال ، وبعد فإنه يريد أن يتخلص من أرتاب الحياة فليتخلص من كل شيء يتصل بها .
ساعة شهية يستقبل فيها أحلامه وأوهامه ثم يفرغ ما في بطنه من خمر وما عقله من سكر ، ثم يزاول أتعاب الحياة من جديد ، وللعقلاء عليه أن ينظف ثيابه إذا علق بها شيء من أوساخ الطريق فماذا يريدون منه بعد ذلك . يتعلل المجانين بنظائر هذه العلل ، وهل تكون علة الخيال إلا خيالاً ، وهل يعتذر عن الجنون بغير الجنون ؟
ومن هؤلاء من يترفع عن الحانات ، ولكنه يتخذ من داره ماخوراً خاصاً لنفسه ولندمائه ، فيشرب ويشربون بمنظر من فتاه وبمسمع من فتاته ، ولعل فتاه هو الساقي ولعل فتاته هي المغنية ، إنه فن . . . وإنه تسلية نفس . . . يا للسوء والجفاء . . . ويا للدناءة الخلقية ، وإذا رضى الإنسان لنفسه بالنقيصة فكيف لا يقبل لعرضه بالدنية ، وهل تبقي الخمرة فيه بقية من شعور ليميز بين الحسن والقبيح ، والصحيح والفاسد . . . ؟
عد على الفقراء من أمتك ببعض هذا الإسراف ، وخصص شيئاً منه لمشاريع الخير ، واحتفظ بالباقي ليومك العسير ، وأفعل ما يفعله الرجل العظيم في نفسه القوي في إرادته ، فستنال الذكر الجميل في الدنيا إذا كنت ممن لا يثق بالجزاء في الآخرة ، كم رأيت من ثروة كبيرة دمرتها الخمرة ، وجاه عريض لعبت فيه الكأس ، وإذا كنت لم تشاهد شيئاً من هذا فإنك قد سمعت منه الشيء الكثير .
ومن هذه الألوان الحمقاء التي تغلب الغاية ، وتعكس النتيجة تظاهر الشباب بمظاهر الأنوثة ، وتصنع الفتى كما تتصنع الفتاة . هذا هو الداء الفاتك وهذا هو السم القاتل ، ولو كان مختصاً بالشباب الفارغ الذي تعده الأمة كلاً ثقيلاً عليها لهان الأمر وسهل الخطب ، لأن هذا النوع من الناس عار على المجتمع ، ولكن . . . ولكن الداء استعضل ، والنقص استفحل حتى عمّ الشباب المثقف الذي تعده البلاد ليومها الآتي ، وتدخره الأمة لسعادتها المرجوة .
أقول ان الداء استفحل لأنه يهدد مستقبل النهضة ، ويزعزع كيان الأمة ، وهل تنهض الأمة بالمساحيق والمعاجين ؟ وهل ينهض بالأمة شباب قتل الترف ما فيه من طموح وأمات السرف ما فيه من جد ، وأخمد التأنث ما في دمه من جذوة ؟
إيه أيها الشاب الناهض . إيه يا عدة اليوم القريب ، و غرة و طرة ، وخد وقد ، و سحر و فتون ، كل هذه الأشياء خلقت لغيرك أيها الناشئ العزيز ، وإذا كانت الطبيعة قد منحتك شيئاً منها فهي تؤهلك لمقام أسمى ، ومحل أرفع ، لا لتجعلك متعة وفتنة .
خلقت لتكون محل إعجاب وثقة ، لا لتكون مثار عاطفة وحب ، ولتكون موضع غزل وتشبيب . . . وأخيراً فقد خلقت لتكون رجلاً .
هل تعلم كم في العيون التي ترنو إليك من نظرة خائنة ، وكم في الابتسامات التي تستقبلك من ابتسامة مربية ، وكم في الناس الذين يحومون حولك من قلب عابث . وأخيراً فهل تعلم أنك أنت الذي تجني بذلك على حاضرك الزاهي ومستقبلك الباسم . والشباب زهرة العمر ومستهل الحياة فهو أثمن من أن يقتل بتصفيف الطرة وصقل الغرة ، وماذا يجنيه الشاب من تزجيج الحاجب وحلق الشارب غير إضاعة الوقت وتهديد المستقبل ، فإلى السعي يا رجل الغد القريب ، ويا أمل الأمة المنشود . إلى السعي فإن الرجل بثقافته وأعماله والرجل بسيرته وسريرته والرجل بجهاده في ميادين الحياة .
ولو أردنا ان نستعرض جميع الفروع التي تتصل بإفراط الشهوة لاحتجنا إلى مجلد ضخم ، والإمام الصادق ( عليه السلام ) يذكر أكثر هذه الفروع في كلماته .
يشتد إفراط الشهوة فيتولد منه الحرص ، ويقوى الحرص فيكون تهالكا في حب المال والجاه ، وينتج منه التكبر ، والرياء والتحاسد و . و . و . . . ، والإمام الصادق ( عليه السلام ) يعرض جميع هذه الأدواء عرضاً إجمالياً حين يقول : ( حب الدنيا رأس كل خطيئة ) أما الطمع الذي يثمر أكثر هذه النتائج فهو الذي يخرج الإنسان من الإيمان في رأي الإمام الصادق ( عليه السلام ) وهي المذلة التي يقبح بالمؤمن ان تكون فيه .
ويقول ( عليه السلام ) ( من كثر اشتباكه الدنيا كان أشد لحسرته عند فراقها ) الشهوات مصادر الآلام ، وهي أسباب تؤدي إلى التعب وفقد الراحة ، فالشهوة سبب للألم قبل حصولها لأن تحصيل الرغبات يستدعي من الإنسان طويلاً من السعي وكثيراً من الجهد ، وهي سبب للألم بعد وجودها لأن حصول الرغبة يثير الحرص في الإنسان على طلب نظائرها فيسلبه الراحة ويفقده الطمأنينة ، والشهوة سبب للألم بعد فراقها لأن فراق المألوف يبعث الأذى ويسبب الألم ، وكلما كانت الرغبة أكثر ملائمة للإنسان كان فراقها أشد ألماً في قلبه ، وأكثر مضاضة في نفسه ، وقد تعرض الإمام الصادق ( عليه السلام ) لهذه الناحية في حديثه المتقدم ، أما الناحية الأخرى فإنه يقول فيها : ( من تعلق قلبه بالدنيا تعلق قلبه بثلاث خصال : هم لا يفنى ، وأمل لا يدرك ، ورجاء لا ينال ) .
وإذا توازنت قوة الشهوة في ميولها ، وخضعت للعقل فيما يحكم ، وأتبعت إرشاده في كل ما يشير كانت عفة وحرية ، والإمام الصادق ( عليه السلام ) يسميها عفة حين يقول : ( أي الاجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج ) ويسميها حرية حين يصف صاحب الدين فيقول : ( ورفض الشهوات فصار حراً ) ثم هو يحدد بها معنى الزهد بقوله : ( أزهد الناس من ترك الحرام ) ، وحين يسأله بعض أصحابه عن الزهد فيقول له : ( ويحك حرامها فتنكبه ) وهذه هي الدرجة الأولى من الزهد التي يشترك فيها عامة الناس ، وللزهد درجات أخرى متفاوتة يختص بها قوم من المخلصين ، أما الرهبانية وإرهاق النفس بالتعذيب المتواصل وحرمانها من الحقوق المحترمة فهي أمور ليست من الزهد . بل وليست من الدين في قليل ولا كثير .
القناعة و الاقتصاد
يحد الإنسان من شهواته ورغباته فيضمن لنفسه الراحة من العناء ، ويوفر عليها كثيراً من الزمن ، ويقتصد في المعيشة ويعتدل في حب المال ، ويسمى الاعتدال في حب المال قناعة ، ويسمى الاقتصاد في المعيشة رفقاًَ ، ويقول فيه الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( الرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال ) ويقول أيضاً : ( ما زوي الرفق عن أهل بيت إلا زوي عنهم الخير ) ويقول : ( ضمنت لمن أقتصد أن لا يفتقر ) وليس بين البخل وبين الاقتصاد صلة ، ولكن من البخلاء من يعلل عن إمساكه بأنه نوع من الاقتصاد الذي يأمر به العقل ، وهي علة يتعلق بها المذنب وعذر يسوقه إليه شعوره بالجريمة ، الاقتصاد تنظيم معيشة الإنسان على ما يفرضه العقل الصحيح ، وتتحمله المقدرة المالية فيعطى في موضع الإعطاء ويمسك في موضع الإمساك بلا سرفٍ ولا تقتير ، والبخل هو المنع في موضع وجوب الإعطاء .
الاقتصاد هو التوازن العادل وطرفاه هما الإسراف والتقتير ، أما الكرم والإيثار فهما لا ينافيان الاقتصاد إذا اقتضتهما الحكمة ، وتحملتهما المقدرة ، المقتصد سخي لأنه ( يؤدي واجب الشريعة ، وواجب المروءة ، وواجب العادة ) والبخيل هو ( الذي يمنع واحداً من هذه الواجبات ) .
والقناعة صفة تقارب الاقتصاد في الأثر ، وتقابله في المعنى ، والفرق بينهما هو الفرق بين الخلق والسلوك ، القناعة ملكة في الإنسان تكسبه الرضا بالقليل ، والاكتفاء بما يسد الحاجة ، والاقتصاد تنظيم المعيشة على ما تفرضه الحكمة وتدعو إليه الضرورة وأثر كل منهما اطمئنان النفس بما يحصل لها من القوت ، والاقتصاد محتاج إلى مناعة قناعة في وجوده ، والقناعة محتاجة إلى الاقتصاد في ظهورها في العمل ، فيكون بين الوصفين تضامن في العمل واتحاد في الأثر .
خلق الإنسان وخلقت معه الحاجة والوسائل التي يسد بها تلك الحاجة ، لابد للإنسان من القوت لأنه يريد أن يعيش ولابد له من الملبس لأنه يريد أن يجتمع ، ولابد له من المسكن لأنه يريد أن يستقل ، إذن فالإنسان محتاج إلى هذه الضرورات وإلى أمثالها من وسائل الحياة ، وهو محتاج إلى مال يبلغه تلك الغايات ، وإلى مكسب يوصله إلى المال ، وكيف يحصل على الكسب بغير الاجتماع .
حلقات من الحاجة يتصل بعضها ببعض ، ولا ينفك بعضها عن بعض ، والمال بعض الحلقات المتصلة ، ولا ينكر أحد أهميته في الحياة ، ولكن الشيء الذي يستنكره العقل أن يجعل المال هو الغاية الأولى والأخيرة تحطم في سبيله كل غاية ، وتستخدم في تحصيله كل وسيلة ، وينبذ كل تشريع ونظام .
النفس ميالة إلى الشهوات ، والمال يسهل لها طريق الحصول على هذه الغاية ، هذا هو مبدأ الشر وهذه هي جرثومة الداء ، هذا هو الذي يفسر لنا المبالغة التي نجدها في ذم المال والتحذير منه فإن التخلص من الأدواء التي يسببها جمع المال عسير جداً .
( إن الشيطان يدبر أبن آدم في كل شيء ، فإذا أعياه جثم له عند المال فأخذ برقبته ) هذه كلمة يقولها الإمام الصادق ( عليه السلام ) في التحذير من المال وبالأحرى في التحذير من النقائص التي يسببها جمع المال ، والشيطان يجثم لأبن آدم عند المال إذا أعياه في كل شيء ، إذن فالمال أعظم شباك الشيطان وأكبر مصائده ، والإنسان مفتقر إلى المال لأن الحاجة تدعوه إلى طلبه ، وإذن فلا بد أن يلتقي الخصمان على مجزرة المال ، ولابد أن يغلب المتيقظ منهما الغافل ، ويظفر الجاد بالهازل ، فإن المال باب الشهوات ومفتاح المطامع ، والإنسان رهين أطماعه وعبد شهواته ، وهكذا يستعبد الحر ويبلغ الشيطان أمنيته من عدوه فيأخذ برقبته رضي الإنسان بهذه النتيجة أم أباها .
وللشريعة الإسلامية نظرة معتدلة إلى المال ، فهو خادم أمين يبلغ به الإنسان حاجته ، وللخادم الأمين منزلته وله مقامه ، على أن يبقى السيد سيداً ، ويظل العبد عبداً ، والمال وسيلة محبوبة توصل الإنسان إلى الخير ، وتحصل له السعادة ووسيلة الخير خير ، وسبب السعادة سعادة ، على أن تبقى الوسيلة وسيلة والغاية غاية ، وأما تحصيل المال بالسرقة والخيانة ، والظلم في المعاملة والتعدي على الحقوق ، و . . فهو أشد المحظورات عند الشرع والعقل ، ومن أعظم المنكرات في العلم الأخلاق ، لأنه يميت الغاية قبل الحصول على الوسيلة ، وينقض الأساس قبل ان يتم البناء ، ولست بحاجة إلى ذكر الشواهد على ذلك من كلمات الإمام الصادق ( عليه السلام ) لأن تحريم هذه الأشياء من ضروريات الدين الإسلامي .
ولست أذكر الربا والمرابين إلا بخير ، فإن الربا اختلاس يبيحه النظام المدني ، والمرابين سراق يحترمهم القانون ، وماذا على المسلم إذا أكل الربا هنيئاً مادام القانون يثبت له هذا التجاوز ، وما دامت المعاملات الربوية شائعة بين الناس, فليغتصب أموال الناس باسم النظام ، وليموه على جريمة بإسم التأويل ، وليكن بعد هذا محارباً لله ولرسوله في رأي القرآن ، وليكن الربا أشد حرمة من الزنا في رأي الإمام الصادق ( عليه السلام ) ، فإنه يتأول قبل ان يرتكب ، وليس عليه بعد التأويل شيء . . وبعد فإن تحريم الربا فكرة يحب على المسلم أن يعترف بها في مقام الاعتقاد ، وليس عليه ان يطبقها في مقام العمل .
والفقير قد يكون آمناً من أكثر هذه الجرائم التي تتعلق بالمال ، ولكنه قد يتعرض لما هو أشد منها جرماًَ وأكبر أثماً .
قد يحمله الإعواز على أن يسرق ، وقد يدعوه الفقر إلى ان يخون ، أو يستدين ثم ينكر ، وقد . . . وقد . ، والفقير إلى جانب اليأس أقرب منه إلى طرف الرجاء ، وإلى الجزع أكثر ميلاً منه إلى الصبر ، وأكثر ما يقترفه من الذنوب نتيجة ذلك اليأس والثمرة ذلك الجزع ، وأحاديث الأئمة من أهل البيت ( عليه السلام ) قد تنوعت للفقير بأنواع البشائر لتحيي فيه ميت الرجاء ، وتبعث في قلبه روح الأمل ، ثم أمرته بالكسب ورغبته في الاقتصاد ، وللأمام الصادق ( عليه السلام ) كلمات تتصل بهذا البحث يجب ان تتخذ قواعد عامة في باب الاقتصاد ، ومن هذه الكلمات قوله :
” لا تكسل في معيشتك فتكون كلاً على غيرك” .
” ضمنت لمن أقتصد أن لا يفتقر” .
” أنظر من هو دونك في المقدرة ، ولا تنظر إلى من هو فوقك ” .
” السرف أمر يبغضه الله حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء ” .
” من كان رفيقاً في أمره نال ما يريد من الناس ” .
” تَعَوَّذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال ” .
الشجاعة
أبرز صفات الرجولة ، واعز ملكاتها ، وأكثرها أثراً في تهذيب الأخلاق ، وتنظيم الأعمال ، لأن تهذيب الملكات جهاد ، والمحافظة على الملكات المهذبة جهاد آخر ، والمجاهد مخذول إذا لم تناصره الشجاعة ولم يرافقه الصبر ، وبالثبات تنجح المساعي وتبلغ المقاصد ، وتتم الإعمال ، والشجاعة بنفسها إحدى الملكات التي لا تحصل إلا بالمجاهدة ، لأنها توازن في قوة الغضب ، وكيف يتوازن الغضب من غير كفاح ، وكيف ترد عاديته بغير جهاد ، وإذن فلا بد للإنسان من قوة أخرى تضرب الغضب بالغضب وتمزج اللين بالقوة لتركب من المجموع مزيجاً معتدلاً يسمى بالشجاعة ، وتلك القوة هي الحكمة ، وجنديها المكافح هو قوة الإرادة .
( الغضب ممحقة لقلب الحكيم ) بهذه الكلمة القصيرة يصف الإمام الصادق ( عليه السلام ) آثار الغضب ثم يقول بعدها : ( من لم يملك غضبه لم يملك عقله ) الحكمة دليل الخير ورائد الإصلاح ، وقلب الحكيم مصدر هذه الدلالة ومشرق ذلك النور ولكن ماذا يجدي هذا الدليل إذا هاج الغضب ، وماذا ينفع هذا إِذا احتدم الغيظ .
قد يسترشد الأعمى فيرشد ، وقد يستدل الحائر فيهتدي والغاضب لا يقبل الإرشاد ولا يسمع النصح ، لأن الغضب جنون والمجنون لا يسمع نصح الناصحين ، دليل هذه الدعوى ظاهر في عيني الغاضب ، وعلى تجاعيد وجهه ، واحتباس أنفاسه ، وتزاحم الكلمات على شفتيه ، ثم هو قد يعتذر بعد ذلك عن أعماله بأنه غاضب ، إذن فهو يعترف على نفسه بالجنون ( ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله ) .
وتهذيب الغضب يكون قبل حصوله ، وطريقه هو التفكير في أسباب الغضب والتأمل في عواقبه وما يجره على النفس وعلى الغير من أضرار وأخطار . وليس من الصلاح ان يتعرض المرشد للإنسان في ساعة غضبه ، لأنه قد يضيف بإرشاده إلى الغضب غضباً ويجمع إلى النار حطباً ، ولكن من الخير أن يتمهله في النتيجة ، وان يصرفه عن الفكرة صرفاً تدريجياً ، لأن الغضب ثورة في دم القلب هم كما يقولون وبالتماصل وصرف الفكر تسكن هذه الثورة ويخلد الإنسان إلى السكون ، ويقول بعض علماء النفس ( إذا غضبت فعد العشرة ) وهو يشير إلى هذا المعنى لأن تعداد العشرة يستدعي فرصة ولو قصيرة ويسبب تغيراً في وجهة النظر لو قليلاً .
( الغضب مفتاح كل شر ) يزول الغضب عن الإنسان ببطء أو بسرعة ، ويبقى في النفس ما تبقى النار في الهشيم ، وإذا خلقت النار أثراً واحداً أو أثرين ، فإن الغضب يبقي آثاراً كثيراً لا يضبطها حساب ، فالحقد ، وحب الانتقام والقسوة وسوء الخلق ، والبغي ، والعجب ، والكبر ، و . . .و . . . كل هذه من ثمرات التهور والإفراط في قوة الغضب .
ويقابله من جانب التفريط الجبن ، وإذا كان التهور خروجاً عن حدود الإنسانية إلى حد الجنون ، فإن الجبن ضعة في صفات الرجولة إلى حد السقوط .
يعيش الجبان في جو من الاضطراب ،ويخلق لنفسه مشاكل من الذعر . لأنه يفقد أعز شيئين يحتاج إليهما الإنسان ، وهما : الثقة بالنفس ، وقوة الإرادة ، وعدوه الأول والأخير : الخوف والشعور بالنقص ، ولو فكر قليلاً لعلم ان جميع ذلك من نسيج الوهم ، وان الاحتياط الذي يتخذه لنفسه هو أشد ظلمة من الواقع الذي يحذر منه ، لأن عاقبة هذا الخوف معلومة الخطر أما الواقع الذي يفر منه فهو خطر محتمل ، ويحدثنا التاريخ ان كثيراً من الجبناء قتلهم الخوف من حيث أنهم يجتنبون مواضع الخوف .
وللجبن أثر سيئ على الصفات والأعمال ، فهو يطبع الأخلاق بطابع الذعر ، ويسم الإعمال بسمة التردد ، وقد يكون من المستحيل على الجبان ان يتم عملاً واحداً صحيحاً حتى في هذه الأعمال التي يتحصن بها من الخوف من غير وجود سبب يوجب الخوف ، والعجز عن احتمال ما يجب تحمله من الأمور ، وضعة النفس وقصور الهمة ، وفقدان الغيرة .
أما الشجاعة فهي أول فضيلة للقوة الغضبية ، ولها مظهران : ثبات في مقام الدفاع . وإقدام في محل الجهاد .
والشجاعة لا تتميز بلون واحد ، ولا تختص بسمة خاصة ، فالغضب للحق شجاعة لأنه مما يأمر به العقل ، والحلم عن الجهل الجاهل شجاعة لأنه مما يدعو إليه الرشد والثورة على الباطل شجاعة لأنها مما تقتضيها الحكمة ، يتقدم الشجاع في موضع التقدم على الباطل شجاعة لأنها مما تقتضيها الحكمة ، يتقدم الشجاع في موضع التقدم ، ويتأخر في محل التأخر ، وهو في كلتا الحالتين شجاع لأنه ثابت القلب أمام المخاطر ، شجاع لأنه يدبر حركاته بالحكمة . ويقسمها المتأخرون من الخلقيين إلى شجاعة بدنية ، وشجاعة أدبية .
الشجاعة البدنية
( جبلت الشجاعة على ثلاث طبائع ، لكل واحدة منهن فضيلة ليست للأخرى : السخاء بالنفس ، والأنفة من الذل ، وطلب الذكر ، فإذا تكاملت في الشجاع كان البطل الذي لا يقام لسبيله والموسوم بالإقدام في عصره ، وإذا تفاضلت فيه بعضها على بعض كانت شجاعة في ذلك الذي تفاضلت فيه أكثر وأشد أقداماً ) .
عناصر الشجاعة ثلاثة على ما يقرره الإمام الصادق ( عليه السلام ) في هذا الحديث ، يجب توفرها في الشخص ليسمى شجاعاً بالاستحقاق ، والذي يفقد واحداً منها لا يستحق هذه الصفة لأنه يفقد ركناً من أركان الشجاعة .
( 1 ) السخاء بالنفس ، وهذا هو العنصر الأول في الأهمية أيضاً ، وإذا عرفنا ان السخاء بالشيء هو بذله عن طيب نفس علمنا الذي يتكلف بذل نفسه لبعض الدواعي لا يستحق ان يسمى شجاعاً ، وان اجتمعت فيه العناصر الأخرى للشجاعة ولكن قد يتكرر هذا التكلف من الإنسان حتى يصبح معتاداً عليه ، ويعود سخياً ويستحق صفة الشجاعة إذا استكمل بقية عناصرها .
( 2 ) و ( 3 ) الأباء والشمم ، وهما خلقان نفسيان متلازمان في الأكثر ، وأثر الأباء احتفاظ الإنسان بكرامة نفسه وترفعه عن الدنيء من الأمور ، وأثر الشمم ، طلب الرفعة والتوجه إلى المراتب الجليلة ، وهما قريبان في المعنى من عزة النفس ، وعلو الهمة ، وسنذكرهما فيما يأتي . وهذه العناصر الثلاثة المتقدمة قد تجتمع في الشخص بأرقي مراتبها فيصفه الإمام ( عليه السلام ) بالشجاع الكامل وبالبطل الذي لا يقام لسبيله . وقد يضعف فيه بعض العناصر فيفقد من الشجاعة الكاملة بمقدار ذلك النقص .
أما الشرط الأول للشجاعة وهو إخضاع قوة الغضب لقوة العقل فيقول فيه : ثلاثة تعقب مكروها . حملة البطل في الحرب في غير فرصة ، وان رزق الظفر .النفس أثمن شيء يجده الإنسان ، ونفس البطل أعز ذخيرة يحتفظ بها ليومها الأكبر ، فيجب عليه ان لا يخاطر بهذه النفس إلا إذا أحرز الفرصة ووثق بالفوز ، وإلاّ فإنه يبيع نفسه من غير ثمن ، والعقل يعد مجازفاً وإن رزق النصر ، لأن نصره هذا وليد المصادفة ، والمصادفات لا تدخل تحت مقياس .
والشجاعة لا تختص بالجندي يقدم نفسه فداء للدين ، أو يبذل دمه لنصرة الوطن فإن للشجاعة البدنية أنواعاً كثيرة, لأن شدائد الحياة لا تدخل تحت حساب ، وملاقاة هذه الأهوال شجاعة متى كان الإقدام فيها بإشارة العقل وإرشاده فالشجاعة تكون في الجندي وفي القائد ، والطبيب ورجال الإنقاذ على سواء إذا اجتمعت في هؤلاء عناصر الشجاعة التي ذكرها الإمام في حديثه السابق .
الشجاعة الأدبية
قد يصوب الإنسان رأياً من الآراء أو يعتنق مبدءاً من المبادئ ، فيعتقد أنه الحق ، ثم يجهر بهذه العقيدة وان كلفة الجهر بها غالياً ، وأدى ثمنها مضاعفاً فيسمى جهره هذا شجاعة أدبية عند الأدباء المعاصرين .
والشجاعة الأدبية خطة كبيرة يقوم عليها أساس نشر الحق وإعلان المبادئ السامية ، وهي خطة المصلحين العظماء الذين اضطهدوا في إسعاد البشر وما توا لإحيائهم ، والذين تنكرت لهم البشرية أحياءًٍٍ ثم خلدت لهم الذكر أمواتاً ، ومن هؤلاء جنود مجهولون خدموا الناس فأنكرهم الناس وجهلهم التاريخ ، ولكن أعمالهم مدونة في سجل هو أرفع من التأريخ ، وإذا شكر الحق أعمالهم ، ورفع لهم منازلهم فماذا يصنعون بتقدير الناس .
والشريعة الإسلامية تجعل هذا المبدأ من أهم فروضها ، وأكبر واجباتها وتسميه ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ، ويقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في بيان وجوبه : ( ويل لقوم لا يدينون الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ويقول في الحث عليه : ( مروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر ، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقربا أجلاً ولم يباعداً رزقاً ) .
مرت على الإمام الصادق ( عليه السلام ) أيام مختلفة تبدلت فيها سياسات وتقبلت فيها أمور ، وقد شاهد الإمام ( عليه السلام ) فيها أنواعاً من الحكم ، وكانت الأيام تبتسم له مرة وتعبس مرة أخرى ، وكان الحكم يقسو تارة ، ويلين تارة ، والإمام بين هذه الأحوال ينتهز الفرصة لنفسه ولأصحابه في نشر الدعوة إلى المذهب ، فيأمرهم بالإعلان حين تبسم لهم الأيام ، ويحذر هم عنه حين تعبس ، وهذا الحذر والتكلم أثران من آثار التقية التي عرفت في المذهب الجعفري ، والتي شرعها الله في كتابه .
وأسرف بعض المذاهب التي تنتسب إلى الشيعة في التكتم بعقائده وأحكامه حتى بعد ارتفاع الشدة وانتهاء أيام الجور ، وتمسك المذهب الإسماعيلي بذلك مشهور في التاريخ ، ولإيضاح معنى التقية وبيان أسرارها وأحكامها كتب أخرى وباحثون آخرون ، والذي نقوله هنا : ان الأمر بالمعروف في رأي الإمام الصادق يكون واجباً ومن أهم الواجبات حين يكون موجباً لتأييد الحق وتعزيز دعوته ، وهو حرام إذا عرض بالدماء الزكية ، وخاطر بالنفوس المحترمة ، وهو من أشد المحرمات حين يكون سبباً لإهانة الحق وإذلاله ، ولذلك فهو يقول : ( المذيع علينا كالشاهر سيفه علينا ، رحم الله عبداً سمع بمكنون علمنا فدفنه تحت قدمه ) ويقول أيضاً : ( من روى علينا حديثاً فهو ممن قتلنا عمداً ولم يقتلنا خطأ ) هكذا يأمر أصحابه بالكتمان في أيام الشدة :
عزة النفس ، و علو الهمة
معرفة الإنسان بقيمته تستدعي طويلاً من التأمل ، كثيراً من التيقظ والانتباه ، فقد يسرف به حب الذات فيعطي نفسه أكثر مما تستحق من القيمة ، وقد يسف به الصغار فيظلمها أقبح الظلم ، وعزة النفس تتطلب من الإنسان شيئين :
1ـ ان يحدد قيمة نفسه تحديداً صحيحاً .
2ـ ان يحدد منازل من يتصل بهم من الأصدقاء ، وقيمة ما يباشره من الأعمال ، فيضع نفسه في موضعها الذي يليق بها بمن يناسبه من الأصدقاء ويباشر ما يليق بشأنه من الأعمال ، والتعدي عن ذلك إذلال للنفس وتعريض بكرامتها إلى الانتقاص ، وفي ذلك يقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( ان الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه ان يكون ذليلاً ) ويقول : ” لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ” وسأله الراوي عن معنى إذلاله لنفسه فقال : ” يدخل فيما يعتذر منه ” .
أما علو الهمة فهو استشراف الإنسان إلى المعالي ، ونزوعه إلى الرفعة والسمو .
خلق الإنسان مجبولا على حب السعادة ، والحصول على الكمال ، ولكن الوصول إلى هذه الغاية دونه عقبات ومصائب ، ولذلك فالذين يجتهدون في طلب الكمال قليلون ، والذين يصلون إلى الغاية أقل هذا القليل ، وعلو الهمة وحده هو الذي يسهل هذه العقبات ، ويذلل هذه المصاعب .
أما قاصر الهمة فقد يقعد به العجز عن السعي وقد يرجع إلى الوراء من منتصف الطريق وفي ذلك يقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) ” ثلاثة يحجزن المرء عن طلب المعالي : قصر الهمة ، وقلة الحيلة ، وضعف الرأي ” .
كثيرون أولئك الذين يفهمون من عزة النفس معنى الكبرياء ، ومن علو الهمة معنى العظمة الزائفة ، وهي نظرة خاطئة ترسل من غير تدبر ، عزة النفس ترفعها عن الدنايا والنقائص ، وعلو الهمة هو طموح الإنسان إلى شريف الأعمال والأخلاق ، وهما أساسان لرقي الفرد ورقي الأمة .
يقدم الإنسان غيره عند تساوي الحقوق فيسمى مؤثراً ، ويتسامح في بعض شؤونه فيكون متواضعاً ، ويتغاضى عن جهل الجاهل فيسمى حليماً وهو عزيز النفس عالي الهمة في جميع ذلك ، من عزة النفس ان يؤثر في موضع الإيثار ، ومن علو الهمة ان يحلم في موضع الحلم ، وعلو الهمة أداة ينال بها الإنسان ما لا يناله بالثروة ، ويدرك بها ما لا يدرك بالمناصب ، المنصب عادية والثروة زائلة ، وعلو الهمة ثروة نفسية باقية ما بقى الإنسان ، وتظل أنظر إلى من هو فوقك في الكمال ، وثق بنفسك قبل المسير ، وإذا سرت فضع قدمك يتثبت وانقله بجزم فستجد اللذة عند أول قدم تضعها ، وستفوز بعد قليل بالغاية ، ستعترضك في الطريق أشباح وأوهام يسميها العامة من الناس مصاعب فلا تعرها التفاتا ، ولا تلق لها بالا ، فإن السلم لا بد له من المدارج . تقدم ولو خطوة فإنها تمهد سبيل الخطوة الثانية ولا تقف في مسيرك إلا حين يأمرك العقل بالأناة فإن الوقوف تضييع للفرصة وتبذير في الزمن ، ولتكن العقبات بعد ذلك ما كانت ، فإن العقبات لا تصد الحر عن قصيده ، ولا تضعف من إرادته ” ومن انتظر بمعالجة الفرصة مؤاجلة الاستقصاء سلبته الأيام فرصته لأن من شأن الأيام السلب وسبيل الزمن الفوت ” .
الأناة و الحلم
كل عمل يباشره الإنسان بإرادته واختياره لابد له من غاية ولا بد له من طريق يوصله إلى تلك الغاية ، والإنسان الكامل هو الذي يفكر في الغاية قبل الشروع في العمل فلعل هذه الغاية غير شريفة في نظر العقل وان وافقت هوى في القلب ، ولعلها لا تناسب علو الهمة وان كانت شريفة في نفسها فإن بعض الغايات يعد شريفاً ولكنه يحدد من قيمة الرجل العظيم ، ولعل الاستيلاء على تلك الغاية يزاحم حقوق آخرين من أفراد الإنسان فيكون في عمله هذا ظالماً أو مستأثراًً أو العظيم أعلى همة من أن يظلم أو يستأثر .
ثم ينظر إلى الطريق فعلّها أبعد سبيل إلى الغاية فتضيع عليه طويلاً من الزمن ، وليس عليه أن تكون أسهل الوسائل فإن صعوبة الجهاد تضاعف لذة الانتصار .
تهون علينا في المعالي نفوسنا *** ومن خطب الحسناء لم يغله المهر
على الإنسان أن يتفكر في أسباب النجاح قبل الشروع في العمل ، وعليه ان يتثبت في تطبيقها حين العمل ، وجميع هذا يستدعي أناة في الطلب وتروياً في الفكر لئلاً يخفق في السعي ويبعد عن المقصود ، وفي ذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام : ( قف عند كل أمر حتى تعرف مدخله من مخرجه قبل أن تقع فيه فتندم ) . ويقول أيضاً : ( العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق فلا تزيده سرعة السير إلا بعداً ) .
ويقول بعض الحكماء : ( الحلم والأناة توأمان نتيجتهما علو الهمة ) .
الأناة هي التثبيت في إنجاز العمل حذراً من الإخفاق ، والحلم هو التثبت في إمضاء القدرة عند الغضب ترفعاً عن الظلم أو رغبة في التكرم والصفح ، فالأناة والحلم توأمان متشابهان كما يقول هذا الحكيم ، وأما ان نتيجتهما علو الهمة فهو حكم ليس بإمكاننا أن نصدقه في جميع الناس .
من الناس من يكتسب علو الهمة بالحلم والأناة ، ومن الناس من يكتسب الحلم والأناة بعلو الهمة ، والحكم الذي لا يقبل الشك ان الحلم والأناة يصحبان علو الهمة صحبة دائمة .
ويقول ( عليه السلام ) : ( من لم تكن فيه ثلاث خصال لم ينفعه الإيمان : حلم يرد به جهل الجاهل ، و ورع يحجزه عن المحارم . وخلق يداري به الناس ) .
الحلم مناعة في النفس يتحصن بها الإنسان عند هجوم الغضب وحب الانتقام ، والحلم عدة الإنسان في أشد مزالقه وأخطر حالاته .
يجهل الجاهل فيحلم عنه العاقل فيكون حلمه هذا تحديداً لكبرياء النفس ، وإشادة بعظمتها في الصفات وترفعاً عن مقابلة الدنيِّ من الخصال ودرساً عالياً لخصمه في الأخلاق ، وتحديداً لجهل ذلك الخصم عن الزيادة ، وفي التأريخ والأمثال أناس خلدهم الحلم ليكونوا مثالاً عالياً للناس .
والعرب القدماء يسودون الحليم ويذكرون في سبب ذلك : ان الحليم سيد على نفسه ومن ساد على نفسه كان جديراً بالسيادة على غيره . ويقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ” لا يعد العاقل عاقلاً حتى يستكمل ثلاثاً : إعطاء الحق من نفسه على حال الرضا والغضب ، وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه ، واستعمال الحلم عند العثرة ” . ويقول : ” كفى بالحلم ناصراً ، وإذا لم تكن حليماً فتحلِّم ) ) والتحلم هو التشبه بالحلماء في التغاضي عن الهفوات ، والترفع عن المقابلة والتكلف لتهدئة الغضب ، ويسمى في لسان الشريعة ” كظم الغيظ” ، وأثر التحلم رد عادية الغضب بعد الثورة ، وأثر الحلم منع النفس عن الغضب ، وصدها عن الانتقام إذا غضبت ، فالتحلم أقل شأناً من الحلم ، ولكن الاستمرار عليه يكسب الإنسان صفة الحلم .
الكبرياء و التواضع
يتقابل الهران المتنافسان ، فينتفش كل واحد منهما وينتفخ ويتطاول ويرتفع ليثبت لخصمه أنه أعظم قدرة وأشد صولة فإذا وقعت المصادمة خفيت المظاهر الكاذبة وظهرت الحقائق وشغل الخصمان بالواقع عن الخيال ، وكانت الغلبة للقوة ، فجرثومة التكبر ثابتة في غريزة الحيوان والإنسان ، وإذا كان بينهما فرق من جهة فهو ان الحيوان يتخذ الكبر سلاحاً عند لقاء العدو والإنسان العاقل ينتفش وينتفخ لغير سبب يوجب ذلك ، فالحيوان أعرف من أخيه بمواضع التكبر .
” ما من أحدٍ يتيه إلا من ذلَّةٍ يجدها في نفسه ” لماذا يتكبر الإنسان إذا كان كبيراً في نفسه ، ولماذا يتعاظم إذا كان عظيماً في صفاته ، أنه ـ من دون ريب ـ يجد في نفسه نقصاً محسوساً وضعة بيّنة ، وهو يريد ان يتم ذلك النقص ويسد ذلك الفراغ بهذه العظمة المكذوبة ، ولكنه بعمله هذا يضيف إلى نقصه الأول نقصاً أكبر منه ، ويضم إلى ضعته الأولى ضعة أشد منه وإذا كان حب الذات يحجب عينيه عن ان تبصر شيئاً من ذلك فإن للناس الآخرين عيوناً غير محجوبة . ولعل في المساكين الذين يترفع عن القرب منهم ويأنف من النظر إلى أسمالهم من هو أشرف منه نفساً وأزكى عملاً وأطيب ذكراً .
ويتحدث الإمام الصادق عن المتكبر أيضاً فيقول : ” لا يزال أعظم الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس ” يعيش المتكبر ثقيل الظل على الناس جميعاً حتى على المتكبرين من نظرائه وإذا شك في ذلك فلينظر مقت الناس للمتكبرين الآخرين ، وليتأمل في نفسه فإنه يجدها في عداد الماقتين لهم أيضاً ، وليجعل ذلك مقياساً له ان كان ممن يعقل أو ممن يحب أن يكون عاقلاً ، وإلا فليفقد العزة من حيث أنه يريد العزة ، ومن نازع الله في ردائه فهو جدير بهذه العاقبة .
ليثق أن الناس لا يهمهم من أمره قليل ولا كثير ، أما هؤلاء المتملقون الذين يظهرون له الانقياد والخضوع فهم دهاة مكرة ، يقتنصون من ماله بهذا الخضوع ثم يسخرون من عقله ومن كبريائه ، ولو تعاهد المسكين نفسه بغير طريق التكبر لبلغ العظمة النفسية الصحيحة ببعض هذا العناء .
الكبر مبدأ سلسلة من الجرائم ، وفاتحة سجل من الآثام ، وأية جريمة خلقية أو قانونية يتوقف المتكبر عن اقترافها إذا هي وافقت أمنيته ، وأية فضيلة يسعى إلى اكتسابها إذا كانت تصادم رغبته أو تزاحم سلوكه ، وبذرة الكبر ليست محدودة النتائج ، ولا مأمونة العاقبة ، فقد تثمر أشد أنواع الكبر وتوصل إلى أبعد مراحله إذا صادفت نفساً مرنة وجهلاً محفزاً .
يتكبر الإنسان على أخيه الإنسان لأنه فقير فيجره ذلك إلى التكبر على الله وقد يجره إلى الجحود والكفر وهي المرحلة الأخيرة من الكبر ، ويقول فيها الإمام الصادق ( عليه السلام ) ” لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر” والكبر هو الخلق النفساني الذي يتصف به المتكبر ، والتكبر هو الأعمال التي تنشأ عن هذه الصفة النفسانية ، وكما ان الكبر سبب لسقوط الفرد في الأخلاق فإنه سبب لانحطاط الأمة في الحضارة ، لأن المتكبر يجد نفسه فوق كل أحد ، ويرى أن مصلحته الخاصة مقدمة على كل شيء ، وهو يحقد على الغير إذا أنكر عليه ذلك . فإذا شاع التكبر في الأمة نشأت الضغائن بين الأفراد ، ودبَ الخلاف بين الجنود ، وبعدت الشقة بين القادة ، وأصبحت الأمة أمما متعددة بتعدد المتكبرين من أبنائها ، وتفرقت كلمتها إلى غير اجتماع .
يغالط المتكبر إذا ادعى انه يحترم القانون ، لأنه يعتقد ان إرادته أسمى من جميع مواده وفصوله ، ولعه يحترم النظام حين يكون وسيلة لحفظ حقوقه الخاصة ، ولعله يرى أن واجب النظام ذلك لا غير .
والفضيلة التي تقابل الكبر هي التواضع ، وهي ان يحترم للناس حقوقهم ويعرف لهم منازلهم ومراتبهم ، وأن يحتفظ لنفسه بمنزلتها الخاصة ، فلا يجحد فضيلة لفاضل ، ولا يحتقر شرفاً لشريف ولا يدعي لنفسه صفة كاذبة ، فإن في الحقيقة غنى عن الخيال ،وليس عليه وراء هذا ان يتنازل عن شيء من حقوقه لأحد من الناس .
من التواضع الممدوح أن يتسامح الإنسان في بعض الحقوق التي لا يضر فواتها بشرفه ، ولكنه ليس يواجب . أما الحقوق الواجبة للنفس والتي يكون فوتها قادحاً في الشرف ونقصاً في المروءة فإن التنازل عنها ذلة يجب على الإنسان ان يتنزه عنها ، وهي الرذيلة الثانية التي تقابل التواضع من جانب التفريط .
( من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس ، وان تسلم على من تلقى ، وأن تترك المراء وان كنت محقاً ، ولا تحب أن تحمد بالتقوى ) وهذا الحديث يعرض أمامنا نوعين من التواضع :
1 ـ التواضع في السلوك والأعمال وهو علاج التكبر .
2 ـ التواضع في النفس وهو يقابل صفة الكبر فيها ، وعلامة هذا التواضع أن لا يحب أن يحمد بالتقوى . قد يستعظم الإنسان نفسه ، ، أو يستعظم صفة من صفاتها ، فيسمى معجباً ، ويتطور العجب فيقيس المعجب نفسه بغيره ، ويحكم لنفسه بالتفضيل ويطمئن إلى هذا الحكم فيكون كبراً ، فالكبر تطور في العجب ، وقد ينشأ الكبر أو التكبر من أسباب نفسية أخرى ، ولكن العجب أهم مصادره وأعظم ينابيعه ، والعلاج الصحيح لهذا الداء أن تستأصل البذرة ، وأن تقتل الجرثومة وعلامة ذلك : ( أن لا تحب أن تحمد بالتقوى ) .
الصدق و الكذب
وصفان يقعان على القول ، ويضافان إلى القائل ، وقد يتعديان إلى غير القول من الأعمال والصفات ، والباحث الخلقي يريد منهما الخلقين النفسانيين الذين يصدر عنهما ذلك السلوك .
الصدق والكذب صفتان للقائل أو للقول ، ولكن الاعتياد عليهما يغرس في النفس ملكة الصدق أو الكذب ، وهي التي يقصدها الخلقي في بحثه .
وإذا اختلف علماء العربية في تعريف الصدق والكذب فلا ينبغي وقوع مثل هذا الاختلاف بين علماء الخلاق لأن غاية العالم الخلقي أن يصل الإنسان إلى الكمال ، والكمال في القول أن يطابق الحقيقة والاعتقاد معاً ، ولأن الاعتدال الذي يبحث عنه علم الأخلاق هو خضوع الإنسان في سلوكه للحكمة ، والحكمة هي : ( معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه ) فالصدق الذي يبحث عنه الخلقي ، والذي يعده من رؤوس الفضائل لا بد له من مطابقة الواقع ، ولابد له من مطابقة الاعتقاد .
قد يعتقد الإنسان بشيء وهو مخطئ في ذلك الاعتقاد ، فإذا أخبر بما يوافق عقيدته هذه كان قوله صادقاً عند بعض علماء العربية ،وقد يكون معذوراً عند الفقيه ، لأنه لم يعتمد المخالفة والكذب ، ولكنه ليس من الصدق الذي يعد في علم الأخلاق فضيلة .
وليس الصدق من فروع قوة معينة ، فقد يضاف إلى الشجاعة ، وقد يكون من العفة ، وقد ينتسب إلى الحكمة ، وقد يشترك في إنتاجه أكثر من قوة واحدة ، والكذب نظيره في ذلك .
الصدق فضيلة ، ومن الوهن بالكاتب أن يدل على كون الصدق فضيلة ، وإذا كان فضل الصدق مفتقراً إلى الإثبات فأي شيء بعده يستغني عن الدليل ، الصدق فضيلة وكفى ، حكم لم يختلف في صحته عقل ، ولم يخالف فيه نظام ، أما الشرائع السماوية فإن وجوب الصدق هو الحكم الأول من أحكام كل شريعة : ( إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ) .
والصدق أهم القواعد التي يقوم عليها بناء المجتمعات ، وتنتظم بها وحدات الأمم ، وأي بناء يبقى للمجتمع ، وأية وحدة تبقى للأمة إذا انهارت دعامة الصدق بين الأفراد ، وفقدت الثقة من كل قائل ، وكيف يعامل التاجر في تجارته ، والطبيب في عيادته بغير الصدق, وكيف يوثق بعلم العالم وعدل الحاكم, وإنصاف الراعي ووفاء الرعية ، وكيف يتم كل شيء بغير الصدق .
وعلى هذا الأساس يمكننا أن نجعل الالتزام بالصدق دليلاً على رقي الأمة, وان مقدار رقيها بمقدار التزام أفرادها بالصدق في أعمالهم وأقوالهم وانحطاطها بمقدار ما يفشو بينهم من الكذب ، يستحيل على الأمة أن تتقدم في حضارتها ومعارفها إذا كانت متأخرة في الأخلاق ، وأشد الأخلاق تأثيراً في ذلك هي الأخلاق العامة التي تؤلف بين الإفراد وتربط بين الجماعات ، والصدق من أهم هذه الأخلاق .
وللصدق أقسام عديدة ، وكل واحد من هذه الأقسام فضيلة ويقابله الكذب في جميع ذلك .
1ـ الصدق في القول
اللسان ترجمان النفس ، وخطيب الجوارح وأمين الإنسان على تبليغ آرائه وأفكاره ، واللسان هو السفير بين الفرد وبين الأمة ، وهو الصلة التي تربط بين المجتمعات ، وتصل بين الأمم ، واللسان دليل شرف الإنسان ورائد عقله ومروءته ، ومن الجدير بهذه الجارحة العظيمة ان تعرف مالها من الكرامة فتؤدي أمانتها بإخلاص ولا يحصل لها الإخلاص في الأداء إلا بالصدق .
يقول الإمام ( عليه السلام ) ” من صدق لسانه زكى عمله ” ويقول : ” لا مروءة لكذوب ” الكذب ملق في اللسان يستبيحه الجاهل لقضاء حاجة وبلوغ مقصد, والكذب تلون في الحديث تسببه ضعة في النفس ، وضعف في الإرادة ، فلا يمكنه ان يلتزم بالحق فيما يقول ، لا مروءة لكذوب ، وأي مروءة للإنسان إذا أساء إلى شرف نفسه ، وأي ثقة للغير به إذا خان أمانة نفسه ، وحسب الكاذب جهلاً أن تكون حاجته أعز عليه من شرفه ، وحسبه ضعة أن يتعرض للعنة الله ولعنة القانون الأدبي .
أما الذي يكذب هازلا فقد يكون أشد جهلاً وأكبر جريمة لأنه يهزأ بحرمات الله وحرمات الأخلاق ، والكاذب الجاد قد يتخّفى بجريمته فلا يطلع عليها السامع ولا تسلب ثقته من النفوس ، أما الهازل فهو مهتوك الحرمة لأنه متجاهر بالإثم و” المؤمن لا يخلق على الكذب ولا على الخيانة ” وسأله رجل ان يعلمه ما ينال به خير الدنيا والآخرة ولا يطيل عليه فقال له : ” لا تكذب “
2ـ الصدق في العزيمة و يقابله التردد
ويسمى هذا النوع من الصدق قوة الإرادة ، وقد سبق البحث عنها في فضيلة العدل ، وسمعنا قول الأمام الصادق ( عليه السلام ) في ذلك .
3ـ الإخلاص
وهو الصدق في وجه العمل ويقابله الرياء .
لكل عمل من الأعمال غاية يقصدها الناس العقلاء حين يصدرون ذلك العمل فالذي يشرب الماء مثلاً يقصد بعمله رفع أذى العطش ، والذي يكتسب يهدف إلى تحصيل المال ، والذي يتعبد لربه يقصد التقرب منه ، والزلفى لديه ، والمخلص في عمله هو الذي يطلب بالعمل غايته الصحيحة التي يطلبها العقلاء ، ويمكن ان يكون لبعض الأعمال غايات متعددة فيكون الإتيان بالعمل لإحدى هذه الجهات إخلاصاً إذا كانت كل واحدة من الجهات تعد غاية صحيحة ، والمرائي هو الذي يغير وجه العبادة فيجعلها ذريعة لتحصيل الجاه ويطلب بها المنزلة عند الناس فهو يعبد الناس بعبادة الله ، ويجعل الدين سلماً لا هوائه وأغراضه ، وقد قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) في تفسيره قوله تعالى . ليبلوكم أيكم أحسن عملاً : ” ليس يعني أكثركم عملاً ، ولكن أصوبكم عملاً ، وإنما الإصابة خشية الله ، والنية الصادقة والخشية ، ثم قال الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل ، والعمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه أحد إلا الله ، والنية أفضل من العمل ” النية الصادقة هي الغاية الصحيحة التي يقصدها الإنسان عند العمل ، وهي التي حكم الإمام بتفضيلها على العمل في آخر الحديث ، والعمل الخالص في رأي الإمام ( عليه السلام ) هو ما كان الله غايته الأولى والأخيرة ، وعلامة هذا الإخلاص ان لا يريد أن يحمد على عمله من أحد سوى الله .
والإخلاص لا يقبل المزاحمة في الغاية حتى بعد إتمام العمل ، فإذا أحال الإنسان وجه النية فقد أحال وجه العبادة وغير صفة الإخلاص ، ولذلك كان الإبقاء على العمل حتى يخلص أشد من العمل ، ويقول ( عليه السلام ) : ” كل رياء شرك ، أنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله ” ويقول : ” الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنما يطلب تزكية الناس ، يشتهي أن يسمع به الناس فهذا الذي أشرك بعبادة ربه ” ثم قال : ” ما من عبد أسر خيراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له خيراً ، وما من عبد يسر شراً فذهبت الأيام أبداً حتى يظهر الله له شراً ” .
المرائي مشرك لأنه يعبد أكثر من معبود واحد ، والمرائي منافق لأنه يظهر مالاً يبطن ويلبس السيئة ثوب الحسنة ، والمرائي ممقوت عند الله لأنه يجعل الله ذريعة لجرم ووسيلة لأثم ، وهو ممقوت عند الناس لأنه يخادعهم بما لا يعلمون . ولابد وأن يكشف الحجاب يوماً ويبرز المستور .
ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا التحفت به فإنك عاري والمرائي كاذب حتى عند نفسه وان غالطها بالعلل ، ومنّاها بالأمل : ” ما يصنع أحد كم ان يظهر حسناً ويسر سيئاً أليس يرجع إلى نفسه فيعلم أنه ليس كذلك ” .
4ـ الصدق في العمل
ويريدون به أن يكون ظاهر الإنسان موافقاً لباطنه ، فلا يقول ما لا يعمل ، ولا يعمل ما لا يعتقد ، ولا يعتقد غير الحق فيكون للحق سره وجهره ، وللفضيلة قوله وعمله ، وهذا المعنى أرفع شأناً من الإخلاص المتقدم ، وفيه يقول الإمام ” ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن الإيمان ما خلص في القلوب وصدقته الأعمال ” .وهذا النوع من الإخلاص يشمل الصراحة ويقابل النفاق في القول والعمل . والنفاق يكون على أقسام :
( 1 ) النفاق في العقيدة : فالمنافق في عقيدته هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر .
( 2 ) النفاق في العمل ، وقد روى الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن جده النبي ( صلى الله عليه و آله ) قوله : في ذلك : ” ما زاد خشوع الجسد على ما في القلب فهو عندنا نفاق ” .
( 3 ) النفاق في الصداقة والمعاشرة . وقد قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) فيه : ” ولا خير في صحبة من لم يَرَ لك مثل الذي يرى لنفسه ” .
5 ـ الوفاء
ليس أيسر على الإنسان من أن يتخذ الصديق أو يعد الوعد ، وليس أعسر عليه من أن يفي بهذه الصداقة أو ينجز ذلك الوعد مهما تقلبت الأحوال أو تغيرت الحوادث .
كلنا نرغب أن يكثر أصدقاؤنا وأصحابنا ، والابتسامة باب الحب والكلمة الطيبة مفتاح القلب ولكن القيام بشؤون الصداقة غير الرغبة فيها .
وكلنا نود أن نعد غيرنا بالجميل ففي الوعد لذة وفي الشعور باحتياج الغير إلى الإنسان متعة .ولكن إنجاز هذه العدة غير النطق بها .
وفاء الإنسان برهان ثباته على المبدأ . ودليل ثقته بنفسه؛ لأن ضعيف الإرادة ووضيع النفس لا يمكنه أن يفي بشيء والإمام الصادق ( عليه السلام ) يقول في وفاء الصديق : (( إذا أردت أن تعرف صحة ما عند أخيك فأغضبه فإن ثبت لك على المودة فهو أخوك وإلا فلا )) ويقول : في الوفاء بالوعد : (( لا تعدن أخاك وعداً ليس في يدك وفاءه )) ويقول : ” عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض ” يعد الإنسان عدة فيرهن شرفه بهذا الوعد ويحس مروءته بهذا الميثاق ، فإذا أخلف بوعده فقد عرض شرفه للثلم ومروءته للانتقاص ، وقد ينتحل الأعذار الكاذبة ليسد بها هذا النقص فيضم إلى الجريمة جريمة . والوفاء باب عظيم من الأخلاق يكفل للإنسان النجاح في أعماله والفوز في معاملاته ويكسبه الثقة في النفوس والثقة بالنفس ، ومن أجتمع له هذان الوصفان فقد جمع الدنيا إلى الآخرة .
6ـ الصدق في مقامات الدين
لأهل الدين في طريقهم إلى الله مراحل يجتازونها بالمجاهدة ويفوزون بعدها بالقرب و الزلفى السالكون في هذه المراحل قليلون والواصلون إلى الغاية بعض هذا القليل ، والسالك يصل إلى غايته حين يعين السبيل ويجتهد في المسير . ولكن قد يخطئ الساعي في السعي وقد يضل السالك عن الطريق فيبعد عن الغاية من حيث أنه يتوهم القرب . ويضل من حيث أنه إنه يعتقد الهدى وقد قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ” العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق فلا تزيده سرعة السير إلا بعداً ” . وللطريق الذي يوصل إلى هذه الغاية علامات وللسعي فيه حدود والإنسان الصادق هو الذي عرف السبيل بعلاماته ثم أجتهد في السعي بحدوده . وغيره حاطب ليل وخابط عشواء .
وللإمام الصادق ( عليه السلام ) في هذا الصدق كلمات كثيرة فهو يقول في مرحلة الخوف والرجاء : ” لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً . ولا يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو” .ويقول في مرحلة الحب : ” الحب أفضل من الخوف ” ويقول : ” من حب الرجل دينه حبه أخوانه”ويقول في مرحلة اليقين : “ان العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله من العمل الكثير على غير يقين ” وأقوال الإمام الصادق ( عليه السلام ) في هذا الموضوع كثيرة نكل البحث عنها لمن يكتب في عرفان الإمام الصادق ( عليه السلام ) .
الحب و الصداقة
نرى الشيء الجميل أو الشيء الجيد فنجد في أنفسنا صدى انفعالياً لذلك الجمال أو لتلك الجودة ، وهذا الشعور النفسي الذي نجده هو الاستحسان ، وقد نحس في أنفسنا بعد هذا الشعور انجذاباً رفيقاً أو عنيفاً إلى ذلك الشي . وهذا الانجذاب هو المحبة ، فالاستحسان انفعال النفس عند شعورها بالجمال للنفس إذا شعرت به . والمحبة هي رد ذلك الانفعال والاستحسان دعوة الجمال للنفس إذا شعرت به . والمحبة استجابة النفس لتلك الدعوة .
والمحبة في أولى درجاتها ميل إلى الشيء المرغوب ، إذا كانت الرغبة فيه لا تكلفتنا ان نتحمل المشاق في تحصيله ، فإذا اشتدت الرغبة إليه ، وكلفتنا أن نتحمل بعض المشاق سميت “وداً ” وإذا بلغت أكثر من ذلك الحد سميت “حباً ” وهو أسمى درجات هذا الإحساس . والعرفانيون يتجاوزون في المحبة هذا الحد فيجعلون لها درجات أخرى متفاضلة ، ولكل واحدة من هذه الدرجات مراتب متعددة .
يقول الفيلسوف : الحب ميل طبيعي إلى المحبوب الملائم ، ويقول الاجتماعي : الحب صلة نفسانية متبادلة بين أليفين ورابطة متعادلة بين قلبين ، ويقول العارف : الحب قوة خفية تصير المعشوق جزءاً من العاشق . وقد تحيلهما شيئاً واحداً لا يقبل التجزئة . ويقول الأديب : الحب إشراقة الروح على الروح ومصافحة القلب مع القلب .
أما الإمام الصادق ( عليه السلام ) فإنه يسميه الإيمان حين يقول : ” وهل الإيمان إلا الحب ” .وقد علمنا أن الإيمان الصحيح عند الإمام ( عليه السلام ) هو معنى الإنسانية الكاملة . والحديث على وجازته يدلنا على منزلة عظيمة للحب في رأي الإمام الصادق ( عليه السلام ) ولكن علينا ان نعرف هذا الحب القدسي الذي يفسر الإمام به الإيمان .
من الأحكام التي لا تقبل التشكيك ان دوام كل عمل أو صفة يكون بمقدار ما لغاية ذلك الشيء من الدوام . والاهتمام به بمقدار ما لغايته من الأهمية . فالذي يطلب رجلاً لحاجة ينتهي طلبه إذا حصل منه على تلك الحاجة . والذي يقرأ كتابا ليفهم معناه تنتهي قراءته إذا حصل منه على الغاية, والحب أحد هذه الأشياء التي تطلب لغاياتها ، وتدوم بدوامها ، وتكون شريفة أو وضيعة بشرف الغاية أو ضعتها . فالذي يحب أحداً لماله ينفد حبه إذا نفد المال ، والذي يحب شخصاً لغاية غير شريفة ينتهي حبه إذا حرم منها وقد ينقلب الحب بغضاً .
والإسلام دين المحبة الصادقة ، والاخوة الدائمة . لا يعجبه هذا اللون المشوه من الحب ، وبالأحرى هذا التدنيس لطهارة الحب . حب الشهوة الوضعية والغايات السافلة .
الحب شريف لأنه علاقة بين أرواح فيجب أن يكون شريف الخاتمة ، والشريعة الإسلامية مثالية في جميع أحكامها فيجب أن تكون مثالية في حبها . على ان هذا اللون محدود الغاية فلا يلتئم مع الألفة الدائمة التي يدعو إليها دين الإسلام .
الحب هو الصلة الأولى بين العبد وبين ربه ، وهو العلاقة المتينة بين الإنسان وبين دينه . فيلزم أن تكون الصلة بين المسلمين ظلاً لذلك الحب وقبساً من ذلك النور فإن ” من حب الرجل دينه حبه أخاه ” . كما يقول الإمام الصادق عليه السلام و” من حب الشيء حبّ جميع آثاره” كما تقول الفلاسفة . وليس الحب شيئاً يكال جزافاً بالمكاييل ، ولا ينشأ مصادفة من غير سبب ، يحب الإنسان ربه لأنه المنعم الذي أوجده بعد العدم . ثم كمله بعد النقص وهداه من الضلالة . ولأنه الكامل المطلق الذي يجب ان يحب لأنه كامل . ويحب الإنسان دينه لأنه الطريق الذي يصل به إلى السعادة والوسيلة التي تضمن له الفوز بالخير الأعلى . ويحب الإنسان أباه لأنه سبب وجوده وهو الكافل لتربيته . ويحب المسلم أخاه المسلم أخاه لأنه عديله في الدين وشريكه في الكمال ، ويحب الإنسان أخاه الإنسان لأنه مثيله في الحقوق ، ونظيره في استحقاق السعادة ، هكذا ينظر الدين الإسلامي إلى الحب ، وهكذا يجب أن يكون ، ” وهل الإيمان إلا الحب ” والعلاقة بين المتحابين إذا أقيمت على هذا الأساس تحطمت دونها كل غاية وسهلت في سبيلها كل وسيلة ، وكانت متعادلة بينهما فيحس أحدهما لصاحبه بما يحس به الآخر لأنه صلة بين نفسين وبالأحرى بين عقلين . أما حب الشهوة فلا تكون له هذه الخاصة لأنه صلة بين غريزة وجسد والجسد لا يحس بما يحس به القلب .
على أن حب الصديق لكماله يكون أكبر لذة وأكثر اتصالاً وبقاءً ، لأنها لذة عقلية . والقوه العقلية أكبر لذة أكبر لذة لأنها أقوى إدراكا وأسمى غاية . ويدلنا على هذا أنا نجد القلوب مجتمعة على حب الكمال أينما وجد وعلى تعظيم الكامل أينما حل وان فصلت بيننا وبينه عشرات القرون ، فالذي يحب ” عنترة ” لشجاعته أو يحب ” حاتما ” لجوده لم يحبهما لغرض يرجع إلى قوة الغضب أو إلى قوة الشهوة ، ولكنه يحبهما لأنهما متصفان بصفتين من صفات الكمال ، وهو يلتذ بهذا الحب كلما خطرت هذه الناحية في قلبه .
والصداقة مادة من مواد الأخلاق ، والصديق صورة ترسم للإنسان مستقبلة وتحدد له سعادته وكماله ، وقد قال الشاعر العربي :
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه *** أفكل قرين بالمقارن يقتدي
ينشأ الإنسان وتنشأ معه غريزة التأسي وحب المحاكاة ، وهو يعلل بها كثيراً من أفعاله ، ويبنى عليها كثيراً من عاداته . يرتكب الإنسان الجريمة لأن نظيره قد أرتكب مثلها أو أشد منها . ويعمل الإحسان لأن أمثاله يعملون ذلك . حتى الطفل فإنه يصدر كثيراً من إعماله لمجرد الاقتداء وحب المحاكاة وكم لهذه الغريزة من مظهر ، وكم لها من نتيجة حسنة أو قبيحة ، وبديهي أن هذه الغريزة إذا قارنت الحب والصداقة كانت أشد تأثيراً في الإنسان .
وقد أثبت التجربة ان المجاورة والاتصال يؤثران حتى في الجمادات .
كالريح آخذة مما تمر به *** نتناً من النتن أو طيباً من الطبيب
فمن الجدير بالإنسان أن يختار موضعاً لصداقته ، لأنه يختار مادة لأخلاقه ويضع رسماً لمستقبلة وحدّاً لسعادته . من حقوق الحب على الإنسان ان يختار له موضعاً ، ومن حقوق النفس ان يختار لها مهذباً . وقد قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : “من لم يجتنب مصادقة الأحمق أو شك أن يتخلق بأخلاقه ” . و قال : ” لا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره ” وللإمام الصادق ( عليه السلام ) كلمات تتضمن قواعد مهمة في الصداقة نذكرها من غير تعليق :
” لا خير في صحبة من لم ير لك مثل الذي يرى لنفسه” ، “إياك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا تؤدي إلى خير” ، ” أحب الأخوان على قدر التقوى” ، ” لا تعتد أحد حتى تغضبه ثلاث مرات ” ، ” عليك بإخوان الصدق فإنهم عدة عند الرخاء ، وجنة عند البلاء” ، ” صحبة عشرين سنة قرابة ” ، ” ضع أمر أخيك على أحسنه ، ولا تطلبن بكلمة خرجت من أخيك محملاً ” ، ” الصفح الجميل أن لا تعاتب على الذنب ، والصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى ” ، ” لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك وأبق منها ، فان ذهاب الحشمة ذهاب الحياء وبقاء الحشمة بقاء المودة ” ، ” أحب أخواني إلى من أهدى إلى عيوبي ” ، ” إذا أحببت رجلاً فأخبره بذلك فإنه أثبت للمودة بينكما ” ” أنظر قلبك فإذا أنكر صاحبك فإن أحد كما قد أحدث” 1 .
- 1. كتاب : الأخلاق عند الامام الصادق ( عليه السلام ) : العنوان رقم (7) للعلامة الشيخ محمد أمين زين الدين .