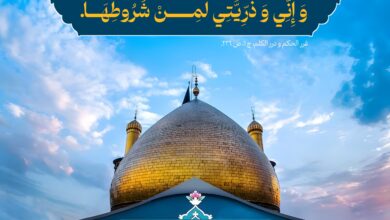في الطريق إلى كربلاء كان اللقاء وكأنّهما على موعد، الحسين (عليه السلام) متوجّه إلى الكوفة استجابةً لطلب أهلها لكي يقاتلوا معه الظلم الأموي المتسلّط على رقاب المسلمين، وزهير بن القين ومعه جماعة من أصحابه في تلك البيداء، جمعتهما هناك الحاجة إلى الماء الموجود لكي يكمل كلّ منهما طريقه المحدّد قبل اللقاء.
ذلك اللقاء الذي تمّ من غير تحضيرٍ مسبق، غيَّر من اتجاه السير عند زهير بن القين، بل أبدل نمط حياته العادي بنمطٍ آخر بعيد ما كان يخطر على باله أو تهفو إليه نفسه قبل ذلك.
لم يكن زهير في مجريات حياته العادية قريباً من الحسين (عليه السلام) وأهل البيت عموماً كما تذكر المصادر التاريخية، وكان أقرب إلى عثمان في المودة، ولهذا كان يكره أن يجتمع مع الإمام (عليه السلام) في مكانٍ واحد، حتى في ذلك المكان الذي التقيا فيه لم يشأ زهير إجابة الدعوة التي وجّهها إليه الإمام (عليه السلام) عبر رسولٍ خاص إليه، ولولا تشجيع زوجته له لما أجاب الدعوة ولبّى.
فما الذي حصل عندما اجتمع مع الإمام (عليه السلام) حتّى صار مريداً ومحباً وولياً وناصراً، بشكلٍ أثار الإستغراب ممّن كانوا في صحبته، إذ كيف يتحوّل إنسانٌ بمثل هذه السرعة ويبدِّل موقفه، لكنه سرعان ما أجاب عن تساؤلاتهم واستغرابهم بقوله: (غزونا بلنجر ففتحنا وأصبنا الغنائم وفرحنا بذلك، ولمّا رأى سلمان الفارسي ما نحن فيه من السرور قال: “إذا أدركتم سيد شباب آل محمد صلى الله عليه وآله فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم من الغنائم)، ثمّ استودع أصحابه وزوجته فقالت له: (خار الله لك وأسألك أن تذكرني يوم القيامة عند جد الحسين (عليه السلام)).
ولا شكّ بأنّ سلمان رضي الله عنه لا ينطق من تلقاء نفسه، بل هذا ممّا تلقَّاه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي لا ينطق عن الهوى، وزهير يعرف ذلك جيداً للمكانة القريبة التي كانت لسلمان عند النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو المقول فيه: (سلمان منّا أهل البيت).
وبذلك أدرك زهير “رض” أنّ الحق مع الحسين (عليه السلام) فلا يَعدُوه، ولا يمكن للإمام (عليه السلام)، إلّا أن يكون مع الحق كما كان أبوه (عليه السلام) كذلك، كيف لا؟ وهو ربيب النبوة وسبط النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولم يكن عند زهير شكٌ عندئذٍ بأنّ الذين هم في الموقع المقابل للإمام الحسين (عليه السلام) هم أهل الضلال والباطل والنفاق، وهو الذي يعلم من هو يزيد وابن من، ويعلم ما هي الصفات القبيحة واللئيمة المجتمعة في ذلك الشخص الذي يحمل حقد آبائه وأجداده الذين أنزلهم الإسلام وأسقطهم عن زعامتهم التي كانوا عليها في الجاهلية.
فالقضية كما أدركها زهير عندئذٍ أنّ المسألة المتنازع عليها لم تعد مسألة من يحكم أو لا يحكم؟ بل المسألة أصبحت متعلّقة ببقاء نفس الإسلام كدين والمسلمين كأمة موحّدة، ولم تعد الأمور قابلة لأن يقف الإنسان عند الآراء الشخصية والمواقف المتشنّجة التي يتمكّن الإنسان من خلال التفكير الهادىء والعقلانية الواضحة أن يرى الفارق بين المسألة المبدئية والمسألة الشخصية ويُقدِّم ما هو الأهم والأخطر في نظره، ولهذا سرعان ما فكَّر واتّخذ القرار ليكون إلى جانب الإمام الحسين (عليه السلام) رفيقاً له في الدرب والشهادة.
إنّ ذلك الموقف المشرّف من زهير لجدير بالكثير من المسلمين قراءته بوضوح والتأمّل فيه برويّة وتبصّر، لأنّه موقف الإنسان الذي لا يترك القضايا الصغيرة تأكل في نفسه وحركته المواقف الكبيرة، ولا يمكِّن آراءه الخاصة في بعض المسائل والقضايا من أن تسيطر على قلبه وعقله لتمنعه من الوقوف إلى جانب الحق وأهله، وهو يعلم تمام العلم من هو الإمام الحسين (عليه السلام) ومن يُمثِّل عند الله وفي الإسلام، فكيف يترك تلك الفرصة في أن يكون إلى جانبه دفاعاً عن الدين وعن الأمة التي يتحكّم بالعباد والبلاد فيها الدعي ابن الدعي يزيد بن معاوية كما قال عنه الإمام الحسين (عليه السلام).
ولم يكن هذا الموقف هو الوحيد من زهير، بل عمل يوم المعركة على إرشاد وهداية أولئك الضالّين الخارجين لقتال الإمام (عليه السلام) لعلّ كلامه وموعظته تؤثر فيهم فتروّعهم عن غيِّهم وضلالتهم وتعيدهم إلى جادة الحق والصواب، فوقف أمام ذلك الجيش رافعاً صوته: (… إنّ الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لينظر ما نحن وأنتم عاملون إنَّا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد فإنّكم لا تدركون منهما إلّا سوء عمر سلطانهما…)، فما كان من أولئك الذين أعمى النفاق قلوبهم إلّا أن سبّوه وشتموه وامتدحوا عبيد الله بن زياد، إلّا أنّه أجابهم: (عباد الله إنّ ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم فخلّوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنّه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين (عليه السلام)) فرماه الشمر حينها بسهم وهدّده بالقتل مع الإمام الحسين (عليه السلام)، فردّ عليه زهير ردّ الموقن بربّه الثابت على ما نوى عليه من نصرة الحسين (عليه السلام) وأهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقال له: (أفبالموت تخوّفني؟ فوالله للموت معه أحبّ إليَّ من الخلد معكم، ثمّ أقبل عليهم قائلاً برفيع صوته: (عباد الله لا يغرنَّكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) قوماً هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذبَّ عن حريمهم).
وهكذا نجد أنّ ذلك الإنسان الرقيق الإحساس قد أجاب الإمام (عليه السلام) بمجرّد أن دعاه للقتال معه، وكانت كلمات سلمان هادية له إلى معرفة الحق والصواب، ولهذا نجد أنّه بالغ في النصيحة لأولئك القوم، إلّا أنّ الإمام (عليه السلام) عندما رأى من أجوبتهم له وهو يدعوهم إلى الهدى أنّها لن تردّهم عن الردى أرسل بطلبه للعودة إلى المعسكر وقال (عليه السلام) مع من بعثه لإعادته: (أَقْبِلْ، فلعمري لئن كان مؤمن آل فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ).
وبذلك ذاب زهير بن القين في حبّ الحسين (عليه السلام) بعد أن أزال من أمام ناظريه الغشاوة التي كانت تقف بينه وبين كونه مع الحق وأهله مع أهل البيت (عليهم السلام) ونرى هذا واضحاً عندما استأذن الإمام (عليه السلام) لقتال القوم بقوله: (أقدم هديت هادياً مهدياً فاليوم ألقى جدك النبيا
وحسناً والمرتضى علياً وذا الجناحين الفتى الكميا وأسد الله الشهيد الحيَّا)، فأجابه الإمام (عليه السلام) حينها جواب من يريد تثبيت توجّهه وقراره، فقال له: (وأنا ألقاهما على أثرك).
فقاتل حتى سقط شهيداً مضرّجاً بدمه، فوقف الإمام (عليه السلام) عند جسده وقال: (لا يبعدنَّك الله يا زهير ولعن الله قاتليك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير).
وهكذا يعلّمنا زهير بشهادته أنّ الإنسان قادر في اللحظات التي تحتاج إلى اتّخاذ القرار الجريء لأن يكون مع الحق بأن لا يجعل للشبهات طريقاً إلى قلبه وعقله يمنعه من أن يكون مع الحق وأهله، فرحم الله زهيراً وجزاه خير جزاء المحسنين1.
- 1. نقلا عن الموقع الرسمي لمساحة الشيخ محمد توفيق المقداد حفظه الله