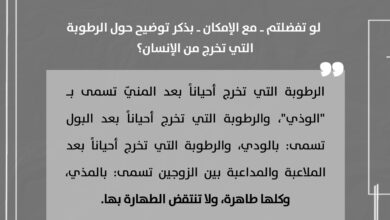يتطرق القرآن الكريم إلى شرح محاورة نبي الله إبراهيم (عليه السلام) مع أبيه آزر – والأب هنا إشارة إلى العم، فإن كلمة الأب، ترد أحياناً في لغة العرب بمعنى الأب، وأحيانا بمعنى العم فيقول: (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا). إن هذا البيان القصير القاطع من أحسن أدلة نفي الشرك وعبادة الأوثان، لأن أحد بواعث الإنسان في معرفة الرب هو باعث الربح والخسارة، والضر والنفع، والذي يعبر عنه علماء العقائد بمسألة «دفع الضر والمحتمل». فهو يقول: لماذا تتجه إلى معبود ليس عاجزا عن حل مشكلة من مشاكلك وحسب، بل إنه لا يملك أصلا القدرة على السمع والبصر. وبتعبير آخر: إن العبادة يجب أن تكون لمن له القدرة على حل المشاكل، ويدرك عباده وحاجاتهم، سميع بصير، إلا أن هذه الأصنام فاقدة لكل ذلك.
إن إبراهيم يبدأ في دعوته العامة بأبيه، وذلك لأن النفوذ في الأقربين أهم وأولى، كما أن نبي الإسلام (عليه السلام) قد أمر أولا بدعوة عشيرته الأقربين.
بعد ذلك دعاه – عن طريق المنطق الواضح – إلى إتباعه، فقال:(يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا)(1) فإني قد وعيت أموراً كثيرةً عن طريق الوحي، وأستطيع أن أقول بإطمئنان: إني سوف لا أسلك طريق الضلال والخطأ، ولا أدعوك أبدا إلى هذا الطريق المعوج، فإني أرد سعادتك وفلاحك، فاقبل مني لتنجو وتخلص من العذاب وتصل بطيك هذا الصراط المستقيم إلى المحل المقصود.
ثم يعطف نظره إلى الجانب السلبي من القضية بعدما ذكر بعدها الايجابي ويشير إلى الآثار التي تترتب على مخالفة هذه الدعوة، فيقول: (يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا).
من الواضح أن العبادة هنا لا تعني السجود والصلاة والصوم للشيطان، بل بمعنى الطاعة واتباع الأوامر، وهذا بنفسه يعتبر نوعا من العبادة.
ثم يذكره وينبهه مرة أخرى بعواقب الشرك وعبادة الأصنام المشؤومة، ويقول: (يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا)(2).
لأرجمنك يا إبراهيم:
مرت كلمات إبراهيم (عليه السلام) التي كانت ممتزجة باللطف والمحبة في طريق الهداية، والآن جاء دور ذكر أجوبة آزر، لكي تتضح الحقيقة والواقع من خلال مقارنة الكلامين مع بعضهما. يقول القرآن الكريم: إن حرص وتحرق إبراهيم، وبيانه الغني العميق لم ينفذ إلى قلب آزر، بل إنه غضب لدى سماعه هذا الكلام، (وقَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا)(3).
اللافت للنظر، أن آزر لم يكن راغبا حتى في أن يجري إنكار الأصنام أو مخالفتها وتحقيرها على لسانه، لا إنه قال: أراغب أنت عن هذه الآلهة؟ حتى لا تهان الأصنام! هذا أولا.
ثانيا: إنه عندما هدد إبراهيم، هدده بالرجم، ذلك التهديد المؤكد الذي يستفاد من لام ونون التوكيد الثقيلة في »لأرجمنّك« ومن المعلوم أن الرجم من أشد وأسوأ أنواع القتل.
ثالثا: إنه لم يكتف بهذا التهديد المشروط، بل إنه اعتبر إبراهيم في تلك الحال وجودا لا يحتمل، وقال له (اهجرني مليا) أي ابتعد عني دائما، وإلى الأبد. وهذا التعبير المحقر جداً لا يستخدمه إلا الأشخاص الأجلاف والقساة ضد مخالفيهم.
لكن، ورغم كل ذلك، فقد سيطر إبراهيم على أعصابه، كبقية الأنبياء والقادة الإلهيين، ومقابل هذه الغلظة والحدة وقف بكل سمو وعظمة، إن هذا السلام يمكن أن يكون سلام التوديع،
وأن إبراهيم بقوله: (سَلَامٌ عَلَيْكَ) وما يأتي بعده من كلام يقصد ترك آزر. ويمكن أن يكون سلاماً يقال لفض النزاع، كما نقرأ ذلك في سورة القصص: (لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ)(4).
ثم أضاف: (سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا). إن إبراهيم في الواقع قابل خشونة تهديد آزر بالعكس، ووعده بالإستغفار وطلب مغفرة الله له.
ثم يقول: (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ) أي الأصنام (وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا)(5).
تبين هذه الآية من جهة أدب إبراهيم في مقابل آزر الذي قال: »اهجرني« فقبل إبراهيم ذلك. ومن جهة أخرى فإنها تبين حزمه في عقيدته، فإن ابتعادي هذا عنك لم يكن من أجل حيادي عن إعتقادي الراسخ بالتوحيد، بل لأنك لا تملك الأهلية لتقبل الحق، ولذلك فإني سأثبت على إعتقادي.
ويقول بصورة ضمنية بأني إذا دعوت ربي فإنه سيجيب دعوتي، أما أنتم المساكين الذين تدعون من هو أكثر مسكنة منكم، فلا يستجاب دعاؤكم مطلقاً، بل ولا يسمع كلامكم أبداً.