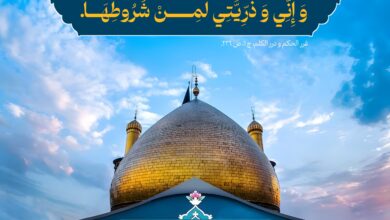{ د. السيد حاتم البخاتي }
كثيراً ما تُختزل أهداف الثورات والنهضات وحركات التحرر والانعتاق التي تُثار في وجه الظلم والجور والانحراف، في لون خاصّ ونمط مُعيّن من الأهداف والغايات التي تُعلَن عِبْر الشعارات المرفوعة والنداءات الموجّهة، وتظهر من خلال ممارسات القائمين عليها وأفعال المتصدِّين لها، وكثيراً ما تكون هذه الأهداف المُعلَنة أو المرفوعة محدودة من حيث الزمان والمكان، ومنصهرة بإطار نظرات وأُفق تفكير مَن يرفعها، وهذا ما تفرضه الظروف الموضوعيّة المرتبطة بحدود إمكانات قادتها وأُفق تصوراتهم، فتأتي أغلب هذه النهضات والانتفاضات ـ فيما لو نجحت ـ قليلة التأثير ومحدودة الفاعليّة، لاسيما إذا ما تقادم عهدها وامتدّ بها عمود الزمان، فتظل حينئذٍ من ذكريات التاريخ وتراثه القَيّم التي لا تخلو من فائدة لمَن اطّلع عليها ودرس تاريخها.
لكنّ هذا التصوّر والانطباع السالف الذكر عن الثورات وحركات الرفض لا ينسحب أبداً على النهضة الحسينيّة المباركة التي قادها الإمام الحسين عليه السلام ، من حيث أهدافها ونتائجها ومعطياتها، وخروجها عن قيود الزمان والمكان، وهذا لا غروَ به؛ لأنّ قائد النهضة سامي المقام وعالي الهمّة كجده النبي الأعظم محمد عليهما السلام ، كما قال الشاعر:
له هممٌ لا منتهى لكبارها *** وهمّتها الصغرى أجلّ من الدهر
أهداف النهضة الحسينيّة ودوافعها
إنّ المتّتبع لفصول النهضة الحسينيّة ومواقفها، وما بعثته من رسائل من بداية انطلاقها وتحركها من المدينة المنوّرة بعد موت معاوية، ومروراً بمكة، وانتهاءً بكربلاء، لا يسعه إلاّ أن يقرّ بأنّها نهضة شاملة، ذات نظرة بعيدة وأُفق واسع، وأهداف متعددة الأبعاد والأغراض والغايات الاجتماعية، والدينية، والأخلاقية والسياسية، حارت في معرفة كنهها ألباب المفكّرين، وعجزت عن الإحاطة بها عقول الألمعيّين.
ولعل أوضح شاهد على اللافتة العريضة لأهداف النهضة الحسينيّة هو ما أطلقه الإمام الحسين عليه السلام في واحد من شعارات نهضته ـ حينما قال في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية ـ: ((وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدي صلى الله عليه وآله، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر))[1]، فعنوان الإصلاح ينطبق على كلّ هذه الأبعاد والأشكال المتعددة لأهداف النهضة الحسينيّة، فيشمل كلّ مظاهر الإصلاح الاجتماعي والديني، والسياسي والأخلاقي والتربوي، وغير ذلك.
ولسائل أن يسأل: لماذا حملت النهضة الحسينيّة كلّ هذه الأهداف؟ ما الذي حصل في الأُمّة؛ لكي يضطلع الإمام الحسين عليه السلام بهذه المهمّة الجسيمة ويدفع هذا الثمن النفيس؟
وفي معرض الإجابة عن التساؤل نقول: من وجهة نظر الشيعة الإمامية ـ وقد يُشاركهم غيرهم من المسلمين ـ إنّ مسيرة الأُمّة الإسلاميّة قد أُصيبت بخلل كبير وانحراف خطير بُعَيد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حينما وُضِعَتْ الأُمور في غير مواضعها التي أرادها الله تعالى لها، فجُعِلَت مقادير الأُمّة ومصائر المسلمين في أيدي أُناس أقلّ ما يُقال عنهم: إنّهم غير مؤهلين لذلك. ثمّ أخذت الهوّة تتسع والشرخ يزداد حينما أصبح طُلَقاء هذه الأُمّة رُعاة المسلمين وأمراءهم في عهد الخليفة الثالث[2]، ولم تسنح الظروف لأمير المؤمنين عليه السلام ـ عندما آلت إليه الأُمور ـ إصلاح ما فَسُد ورَتْق ما فُتِق؛ لأنّ الأيادي الأثيمة اغتالته ليمضي شهيد الحقّ والعدل، وتُمنى الأُمّة بأفدح خسارة في تاريخها، ثمّ تتعمّق الجراح وتزداد مأساة الإسلام بتولي معاوية بن أبي سفيان السلطة وقيادة الأُمّة الإسلاميّة، مع أنّها محرّمة على آل أبي سفيان، كما روي عن الإمام الحسين عليه السلام أنّه قال: ((ولقد سمعت جدّي يقول: الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان))[3]، ولم يكن يتصَّور أحد من عامّة المسلمين في العقدين الأولين للإسلام أن تقع الخلافة في أيدي أبناء أبي سفيان، ولكنّها سخرية القدر، ووهن الأُمّة وضعف إرادتها.
وليت الأوضاع وقفت عند هذا الحدّ، بل تعدّت إلى أن يصبح يزيد بن معاوية ـ الفاسق وشارب الخمر وقاتل النفس المحترمة ـ خليفة على المسلمين، عندها دقّ ناقوس الخطر بشدّة، وأصبحت جهود النبي صلى الله عليه وآله في مهبّ الريح؛ الأمر الذي حدا بالإمام الحسين عليه السلام أن يقول: (( إنّا لله وإنّا إليه راجعون، وعلى الإسلام السلام؛ إذ قد بُلِيت الأُمّة براعٍ مثل يزيد))[4]، ويقول: ((ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه؛ ليرغب المؤمن في لقاء ربّه حقّاً حقّاً؛ فإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إلاّ برماً))[5].
فهذه الحالة المتردّية التي وصل إليها وضع المجتمع الإسلامي على جميع الأصعدة ـ الاجتماعيّة والسياسيّة والدينيّة والأخلاقيّة ـ تحتاج بطبيعة الحال إلى نهضة إصلاحيّة متوازية وحجم الفساد والإفساد الذي أصاب الأُمّة جمعاء, نهضة تُراعي في أهدافها ورسالتها إصلاح كلّ أشكال هذا الانحراف، وتكون بمستوى المسؤولية وحجم المهمة؛ فلهذا كانت أهداف النهضة الحسينيّة بهذا الحجم الكبير والأبعاد المتعددة، وبه يتّضح جواب التساؤل المتقدِّم.
بقي أن نعرف الطريقة والأُسلوب الذي سلكه الإمام الحسين عليه السلام للوصول إلى هدفه الإصلاحي، وهو ما نشير إليه فيما يأتي.
أُسلوب الإمام الحسين عليه السلام وطريقته في تحقيق الإصلاح
يمكن أن تُذكر عدّة آراء ونظريات تفسّر الطريقة والأُسلوب الذي اتّبعه الإمام الحسين عليه السلام في حركته التغييريّة؛ للوصول إلى مبتغاه في الإصلاح العامّ الشامل، إلاّ أنّنا سنقتصر على رأيين رئيسين في مسألة الأُسلوب والآلية والطريقة التي اتّخذها الإمام، وهما أُسلوب الاستيلاء على الحكم، وأُسلوب التضحيّة والاستشهاد:
الأُسلوب الأول: الاستيلاء على السلطة وإقامة الحكم الإلهي
يذهب أصحاب هذا الرأي إلى إنّ الإمام الحسين عليه السلام إنّما سعى إلى تحقيق أهداف نهضته عن طريق استلام زمام الخلافة الإسلامية، وإصلاح ما أفسده غيره، وإعادة الأُمّة إلى رشدها ووضْعِها على جادّة الصواب، من خلال السيطرة على أجهزة الدولة ومفاصلها، واستغلالها في سبيل أسلمة المجتمع بعد أن فقد هويته الإسلاميّة الحقيقيّة.
ولم يكن سعي الإمام عليه السلام للحصول على السلطة والحكم هدفاً وغاية شخصيّة، بل كان وسيلة وطريقاً لتحقيق أهداف نهضته الكبرى[6]، وهذا ديدنهم في التعامل مع قضية الحكم والقيادة، وفي هذا الصدد يقول الإمام الحسين عليه السلام : ((اللهم، إنّك تعلم أنّه لم يكن ما كان منّا تنافساً في سلطان، ولا التماساً من فضول الحطام، ولكن لنُري المعالم من دينك، ونُظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك، ويُعمل بفرائضك وسننك وأحكامك))[7].
وبإمكاننا أن نقرِّب هذه الرؤية من خلال استعراض بعض المعطيات والشواهد التي تصبّ في صالح مَن يتبنّاها، وهي أنّه بعد أن نصّب معاوية ابنه يزيد ـ الذي لم يكن لائقاً بهذا المنصب ولو بالحدّ الأدنى ـ أميراً على المسلمين قبل موته وجدت هناك موجة من الاستياء العامّ في أوساط المسلمين، ورفض بعض زعماء المسلمين البيعة، فرأى الإمام عليه السلام أنّ الأجواء مهيأة لأخذ زمام المبادرة، وهو مَن يمتلك كل المقوّمات المطلوبة في الحاكم الإسلامي، فأعلن شعاره الأول الذي حمل دلالات واضحة على توجهاته ((وأنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مُفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في أُمّة جدّي صلى الله عليه وآله أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام ، فمَن قبلني بقبول الحقّ، فالله أوْلى بالحقّ، ومَن ردّ عليَّ هذا أصبر، حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ، وهو خير الحاكمين))[8].
وساعد على ذلك مكاتبة أهل الكوفة له ودعوتهم إياه إلى القدوم واستعدادهم للدفاع عنه ومبايعته بالخلافة؛ فبعث إليهم مسلم بن عقيل لتقويم الأُمور، والتمهيد للدولة الجديدة التي عاصمتها الكوفة، كما أنّه كان بالإمكان أن يضمن ولاء المدينة المنوّرة ومكة؛ فأخذ يدعو كلّ مَن لقيه إلى نصرته والالتحاق به، بل بعث كُتباً ورسائل إلى زعماء القبائل يدعوهم إلى الانضمام إليه في حربه ضدّ السلطة الظالمة، ومن كُتبه تلك ما أرسله إلى زعماء البصرة الذي جاء فيه: ((إنّي أدعوكم إلى الله وإلى نبيِّه؛ فإنّ السنّة قد أُميتت، فإن تُجيبوا دعوتي، وتُطيعوا أمري أهدِكم سبيل الرشاد))[9].
هذا، وممّا يدعم هذا الرأي ما كتبه الإمام الحسين عليه السلام في رسالته الجوابية عن كتاب مسلم بن عقيل، حين أخبره بأنّ الأُمور في صالح أهل البيت عليهم السلام وأنّ أهل الكوفة قد اجتمعت كلمتهم على نصرة الحسين وأهل بيته عليهم السلام ، فقال: ((أمّا بعد: فإنّ كتاب مسلم بن عقيل جاءني يُخبر فيه بحُسن رأيكم، واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب بحقّنا، فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع، وأن يُثيبكم على ذلك أعظم الأجر))[10].
بل بناءً على بعض الأخبار أنّ الإمام عليه السلام قد مارس صلاحيّاته كحاكم سياسي فعلي، حين صادر ـ وهو في الطريق ـ أموالاً بعثها إلى يزيد عامله على اليمن، قال السيد ابن طاووس: ((ثمّ سار حتى مرّ بالتنعيم، فلقي هناك عِيراً تحمل هديّةً قد بعث بها بحير بن ريسان الحميري عامل اليمن إلى يزيد بن معاوية، فأخذ الهدية؛ لأنّ حكم أُمور المسلمين إليه))[11].
وظل هذا الأمر نُصب عين الإمام عليه السلام حتى بعد أن انقلبت أوضاع الكوفة، واستُشهد مسلم بن عقيل، وتفرّق الناس الذين التحقوا به إلاّ ثلّة من خُلّص أصحابه، فما زال يذكّر الناس بأنّه أحقّ بالخلافة وأوْلى من يزيد بن معاوية، ويحثّهم على طاعته، وذلك حين خطب بجيش الحرّ عندما التقى به في الطريق على مقربة من كربلاء، فقال: ((أيها الناس، فإنّكم إن تتَّقوا الله وتعرفوا الحقّ لأهله يكن أرضى لله عنكم، ونحن أهل بيت محمد، وأوْلى بولاية هذا الأمر عليكم من هؤلاء المدَّعين ما ليس لهم، والسائرين فيكم بالجور والعدوان))[12].
بل إنّه لم ييأس من دعوة أهل الكوفة ـ ممّن كتبوا له ـ إلى نصرته وترك جبهة الباطل، فعندما وصل إلى كربلاء دعا بدواة وقرطاس، فكتب إليهم كتاباً جاء فيه: ((وقد علمتم أنّ هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان، وتولّوا عن طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطّلوا الحدود، واستأثروا بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرَّموا حلاله، وإنّي أحقّ بهذا الأمر؛ لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أتتني كتبكم، وقَدِمت عليّ رسلُكم ببيعتكم، أنّكم لا تسلموني ولا تخذلوني، فإن وفيتم لي ببيعتكم فقد أصبتم حظكم ورشدكم))[13].
ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ الإمام كان يرى بعلمه العادي أنّ هذا الشيء سوف يتحقق، فاندفع إلى ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يرى أنّه سوف ينتصر على الكفار في أُحد، وكذلك الحال في خروج الإمام علي عليه السلام إلى معركة صفّين، فالتصدّي والتخطيط لاستلام الحكم من قِبَل إمام ما، لا يعني بالضرورة أنّ ما خُطّط له سوف يتحقق؛ فالأئمة عليهم السلام لا يخرجون عن الجانب البشري في عملهم الاجتماعي والسياسي، ولا يستخدمون الوسائل الغيبيّة إلاّ في حالات خاصة[14].
وقد نجد هذا الرأي في كلمات السيد المرتضى في كتابه تنزيه الأنبياء، فإنّه ذكر عدّة تساؤلات حول نهضة الإمام الحسين عليه السلام ، وتحركه من المدينة حتى كربلاء، منها: أنّه ما المبرر لخروجه إلى الكوفة وهي بيد أعدائه، وهو يعلم صنيع أهل الكوفة بأبيه وأخيه؟ ولماذا لم يأخذ بنصيحة أصحابه بعدم الخروج، وإلاّ فسوف يُقتل؟ ثمّ لماذا لم يرجع بعد علمه بمقتل مسلم بن عقيل؟ وغير ذلك من التساؤلات. فيُجيب عنها بقوله: (( إنّ الإمام متى غلب في ظنّه يصل إلى حقّه والقيام بما فُوِّض إليه بضرب من الفعل؛ وجب عليه ذلك، وإن كان فيه ضرب من المشقّة يُتحمّل مثلها، تحمّلها، وسيدنا أبو عبد الله عليه السلام لم يَسر طالباً للكوفة إلاّ بعد توثُّق من القوم وعهود وعقود، وبعد أن كاتبوه عليه السلام طائعين غير مكرهين، ومبتدئيِن غير مجيبين… ورأى عليه السلام من قوّتهم على مَن كان يليهم في الحال من قِبل يزيد، وتشحّنهم عليه وضعفه عنهم، ما قوّى في ظنّه أنّ المسير هو الواجب؛ تعيّن عليه ما فعله من الاجتهاد والتسبُّب، ولم يكن في حسابه أنّ القوم يغدر بعضهم، ويضعف أهل الحقّ عن نصرته، ويتّفق بما اتّفق من الأُمور الغريبة…))[15].
وبغضّ النظر عمّا يُورَد على هذا الرأي من إشكالات؛ فنحن لسنا بصدد محاكمة الآراء بقدر ما نبتغي عرضاً لهاتين الرؤيتين فقط.
الأُسلوب الثاني: طريق التضحية والاستشهاد
هناك مَن ينظر إلى القضية من نافذة أُخرى، فيرى أنّ الإمام الحسين عليه السلام لم يكن له بدٌّ في تحقيق أهدافه العظيمة إلاّ ركوب الصعبة وسلوك طريق التضحية والاستشهاد؛ لأنّ ((الدنيا قد تغيّرت وتنكَّرت، وأدبر معروفها… حتى لم يبقَ منها إلاّ صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالكلاء الوبيل))[16]، فيزيد بن معاوية لا يمتلك ما عند أبيه من سياسة المراوغة والطرق الملتوية، وإنّما تغلب عليه الحماقة والغباء والغرور مع فقدانه الوازع الديني والأخلاقي، فقرَّر تصفية خصومه ومعارضيه جسدياً، فكتب إلى عامله على المدينة: ((فإذا أتاك كتابي هذا فعجِّل عليَّ بجوابه، وبيّن لي في كتابك كلّ مَن في طاعتي، أو خرج عنها، وليكن مع الجواب رأس الحسين بن علي))[17]، كما كان لا يتوانى في ارتكاب الفظائع والجرائم، وانتهاك الحرمات والمقدّسات إذا ما حال ذلك دون تربّعه على سدّة الحكم، هذا من جهة.
ومن جهة أُخرى، فإنّ المجتمع الإسلامي قد جفّت فيه القيم الإسلامية الأصيلة، وتغيّرت فيه المفاهيم، فأضحى المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والشريف مبعَّداً مهمّشاً، والدني مقرَّباً محترماً، كما وصف ذلك الإمام الحسين عليه السلام ((ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه؛ ليرغب المؤمن في لقاء ربّه حقّاً حقّاً))[18]، وفي قوله عليه السلام : ((فإنّ السنّة قد أُميتت))[19].
فخطط الإمام عليه السلام ـ ومن ورائه السماء ـ أن يقوم بعمليّة التغيير الشامل بتقديم نفسه وأهل بيته وأصحابه قرابين على مذبح الإصلاح، وحمله عياله وثقله ليلاقوا أهوال السبي ويقاسوا أنواع المصائب؛ ذلك ليحدث هزّة عنيفة تصعق وجدان الأُمّة، وصرخة مدويّة تصكُّ آذانها؛ لترجع عن غيّها وتستفيق من غفلتها، وتلتفت إلى ما وصل إليه حالها.
ولعلّ هذا ما كان يُلمح إليه قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الرؤيا التي رآها الإمام الحسين عليه السلام عندما زار قبر جده، قال صلى الله عليه وآله: ((يا بني، يا حسين، كأنّك عن قريب أراك مقتولاً مذبوحاً بأرض كرب وبلاء من عصابة من أُمتي، وأنت في ذلك عطشان لا تُسقى، وظمآن لا تُروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، ما لهم؟! لا أنالهم الله شفاعتي يوم القيام! فما لهم عند الله من خَلاق))[20].
ثمّ جاءت بياناته عليه السلام من بدايات تحرُّكه تُشير إلى تصميم على الشهادة، وبالكيفيّة التي أرادها وخطَّط لها، ولعل أوضح تصريح له بتلك الكيفيّة عند قوله عليه السلام لأُمّ سلمة حين همَّ بالخروج من المدينة: ((يا أُمّاه، قد شاء الله عزَّ وجل أن يراني مقتولاً مذبوحاً ظُلماً وعدواناً، وقد شاء أن يرى حرمي ورهطي ونسائي مشرَّدين، وأطفالي مذبوحين مظلومين، مأسورين مقيَّدين، وهم يستغيثون فلا يجدون ناصراً ولا معيناً))[21].
وهكذا حين أراد الخروج من مكة إلى العراق أكّد هذا المعنى في كتاب أرسله إلى محمد بن الحنفية وسائر بني هاشم ((أمّا بعد، فإنّ مَن لحق بي استُشهد، ومَن لم يلحق بي لم يدرك الفتح))[22]. وتوجد شواهد أُخرى كثيرة تعضد هذا المعنى.
من هنا؛ نرى أنّ الذين نصحوا الإمام بعدم الخروج أو الذين اقترحوا عليه أُموراً معيّنة، لم يفهموا مغزى قرارات الإمام عليه السلام وتصرفاته، كالتوجّه بكلّ إباء وشجاعة إلى الكوفة التي عُرفت بعدم الوفاء، وبهذا العدد القليل من الأنصار والأصحاب لملاقاة جيوش بني أُميّة، وكذلك حمل الأطفال والنساء؛ لأنّ أُولئك الناصحين والمشفقين أنى لهم معرفة هذا التخطيط الإلهي، وهذه النظرة الإلهية الواسعة الأُفق، التي لا تصدر إلاّ من إمام معصوم، وقائد مرتبط بالسماء.
ونحن سواء قلنا: إنّ الحسين عليه السلام ارتأى أن يُحقّق أهدافه بواسطة استلامه الحكم والسلطة، أم أنّه اختار سبيل التضحية والشهادة، فإنّ الإمام عليه السلام لا شك في أنّه سعى لوضع الإصلاح موضع التطبيق؛ عملاً بتكليفه الإلهي ووظيفته الشرعية؛ كونه إمام هذه الأُمّة، وقائدها الشرعي المسؤول عن مصيرها ودينها ومقدراتها.
ثمّ بعد كلّ هذه التضحيات الجسيمة التي بذلها الإمام عليه السلام في سبيل نهضته، ووقوع هذه المأساة التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً في شناعتها وبشاعتها، لنا ولغيرنا أن يتساءل عن التأثير الذي أحدثته عاشوراء في واقع الأُمّة ومستقبلها.
فهل تمكَّنت النهضة الحسينيّة أن توقظ الأُمّة من غفلتها، وتبعث الحياة في إرادتها، بعدما أصابها الوهن والضعف؟ وهل استطاعت أيضاً أن تُعيد لها بعض مبادئها وقيمها المفقودة؟ أو أنّ القضية على النقيض من ذلك؛ فإن الأُمّة بخذلانها الإمام الحسين عليه السلام وموقفها السلبي والمشين تجاه ثورته ألبسها الله تعالى ثوب الذلّ والهوان، وأُصيبت بانتكاسة كبيرة على الأصعدة كافّة.
هاتان قراءتان ورؤيتان نُحاول عرضهما للقارئ الكريم، لمعرفة صحّة كلّ منهما وواقعيته.
الرؤية الأولى: انتكاسة الأمّة بعد واقعة كربلاء
من سُنن الله الجارية في خلقه أن يكون الإصلاح والتغيير والسير نحو الكمال نابعاً من المجتمع البشري نفسه، ولا يتدخَّل الله سبحانه تكويناً في حصول هذا التغيير والإصلاح إلاّ في حالات خاصّة جداً، قال تعالى: إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ[23]، فكثير من الأُمم عانت من الظلم والاضطهاد والانحراف بسبب رضوخها للظلم والطغيان، وخذلانها للمصلحين وقادة التغيير، والأُمّة الإسلاميّة ليست بدعاً من الأُمم؛ فإنّها قد اتّخذت سلسلة من المواقف المتراجعة، كان أولها إحجامها عن نصرة الخليفة الشرعي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعدم وضعه في المكان الذي أراده الله له؛ ما جرّ عليها الويلات والمصائب، حتى جاء موقفها المتخاذل تجاه النهضة الحسينيّة، فتركت الحسين عليه السلام وحيداً بين أعدائه، وهو مَن لبّى نداءها حين استصرخته ولهة متحيّرة، فمُنيت بالذلّة والمسكنة والانتكاسة على المستويات كافّة، ويمكن أن يُستدلّ على حصول التراجع والنكول للأُمّة الإسلاميّة بعد واقعة كربلاء بالواقع التاريخي، وبعض نصوص النهضة الحسينيّة:
الواقع التاريخي للأُمّة الإسلامية بعد عاشوراء
إنّ نظرة إجمالية سريعة وخاطفة للواقع التاريخي للأُمّة الإسلاميّة بعد حادثة عاشوراء ـ وعلى جميع مستوياته السياسية والاجتماعية والدينية والأخلاقية ـ تُثبت بأنّ المسلمين عاشوا حالة من التراجع والانحدار والابتعاد عن التعاليم الإسلاميّة.
فعلى المستوى السياسي، فإنّه بعد أحداث كربلاء كانت الدولة الإسلامية مفكَّكة وموزَّعة بين الأُمويين في الشام وبعض المناطق، والزبيريين المسيطرين على الحجاز والعراق، بالإضافة إلى الخوارج في بعض مناطق الجزيرة، ونشبت بين هذه الأطراف نزاعات وحروب انتهت بسيطرة الأُمويين وبسط نفوذهم على معظم المناطق في عهد عبد الملك بن مروان[24]، ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاً، حتى حدثت الصراعات العائلية على تولّي مقاليد الحكم ما أضعف الدولة، وكذلك ظهور الحركات النضالية والجهادية بين الحين والآخر؛ ما عجّل بسقوط الدولة الأُموية على يد العباسيين الذين استغلّوا شعار الرضا من آل محمد للتوصّل إلى الحكم عبر استقطاب الجماهير الناقمة على الأُمويين وضمان ولائها، ولكنهم ما أن تمكَّنوا من السيطرة على الحكم حتى تنكّروا لذلك الشعار، ولكنهم وإن بدوا أقوياء في بداية حكمهم الذي استمر أقلّ من قرن من الزمن، ولكنّه في تلك المدّة كان هناك الأُمويون في الأندلس، والأدارسة والخوارج في شمال إفريقيا، ومع هذا، فإنّهم سرعان ما أُصيبت دولتهم بالأدواء ذاتها التي أُصيبت به الدولة الأُموية، من الصراعات الداخلية على الحكم والسلطة، والانشغال بجمع الثروات؛ فدبّ الضعف بأوصال الدولة العباسية واقتُطعت منها أجزاء واسعة وكثيرة، تعاقبت على حكمها دول عديدة قامت على أُسس مذهبية أو قومية، وكثيراً ما تحدث الصراعات بين هذه الدول؛ فتخبوا دول وتظهر أُخرى، حتى وصل الأمر أن فقد الخليفة العباسي كلّ صلاحياته في الحكم مدّة طويلة من الزمن، وأصبح مجرَّد اسم[25].
ونتيجة ما كان يُعانيه المسلمون، من تفكّك دويلاتهم، وتشتّت قواهم وتناحرهم؛ استطاع المغول اجتياح البلاد وإسقاط الحكومة العباسية؛ وبعدها ظلّ الواقع السياسي للمسلمين في انحطاط وتدهور، حتى وقع المسلمون فريسة للاستعمار الغربي الذي احتلّ البلاد الإسلامية، ونهب ثرواتها واستعبد شعوبها، وأورثها الدمار والخراب، فأيّ ذلّ أكبر من هذا الذي عاشته الأُمّة الإسلامية في واقعها السياسي.
وأمّا على المستوى الاجتماعي، فإنّ حال المسلمين لا يختلف عن وضعهم السياسي، فقد عاش المسلمون بعد واقعة عاشوراء ظروفاً اجتماعية سيئة تمثّلت بانتشار الفقر والفساد، وفقدان الأمن والاستقرار؛ بسبب الصراعات السياسية، مضافاً إلى تفشّي القمع والقهر والاستبداد من قِبَل حكّام الجور وولاة الظلم، كالحجاج وغيره من ولاة وحكّام بني أُميّة وبني العباس، فقتل عدداً من الخيِّرين والشرفاء، وزجّ بعدد آخر منهم في السجون والمعتقلات، فيما شرَّد بعضاً آخر، والتاريخ مليء من هذه الشواهد، كما ساعدت هذه الأوضاع على بروز ظواهر اجتماعية غريبة على المجتمع الإسلامي، كالتمييز على أساس العرق والقومية، كما حصل في الدولة الأُموية التي ميّزت بين العرب والموالي؛ ممّا يعني أنّ المسلمين كانوا بعيدين عن تعاليم دينهم ووصايا نبيهم في هذا الجانب.
ولعل أفدح ما أصاب هذه الأُمّة هو أنّها حرمت نفسها من النبع الصافي للشريعة الإسلاميّة، وهم أهل البيت عليهم السلام ، الثقل الثاني مع القرآن الكريم، اللذين جُعلا أماناً من الضلال متى تُمسك بهما مجتمعَين، فراحوا يرتشفون علومهم في الفقه والعقيدة وغير ذلك من كلّ مَن هبّ ودبّ، فلم يزدهم ذلك إلاّ تيهاً وضلالاً؛ فبرزت ظاهرة علماء البلاط الذين شرعنوا للحكّام ما يقومون به من ظلم وجور؛ فكان أن وُلِدت أفكار طبقاً لتوجُّهات الأنظمة المتسلطة وأمزجة حكّامها؛ فتكوّنت في الواقع الديني للمسلمين مدارس فقهيّة وعَقديّة، اندرس بعضها وظلّ بعضها الآخر حيّاً إلى يومنا هذا.
وإلى جانب ذلك ابتُليت الأُمّة أيضاً بمدارس منحرفة إلى درجة أنّها لا تمتّ إلى الإسلام بصلة، كحركة الزنادقة والدهريين وغيرهم.
إنّ معظم الحكّام والولاة الذين تولّوا أُمور المسلمين كانوا بعيدين جداً عن الشريعة الإسلاميّة وأحكامها، فقد كانت قصورهم وبيوتهم تعجّ بمظاهر الفساد الأخلاقي والانحلال الديني، كمعاقرة الخمور، وممارسة الفجور، والضرب بالطنبور، والرقص والغناء واللهو؛ فانعكس ذلك بطبيعة الحال على المجتمع الإسلامي الذي تفشّت فيه هذه الظواهر؛ لأنّ الناس على دين ملوكهم كما يقال، والشاهد على ذلك: تجد أنّ كثيراً من البلاد التي فُتحت في زمن هؤلاء الطواغيت سرعان ما تعود إلى ديانتها وشركها حين تسنح الفرصة لها، عندما تضعف سيطرة الدولة على المناطق.
إنّ ما تقدَّم هو لمحة بسيطة على واقع الأُمّة الإسلاميّة بعد عاشوراء، تبيّن من خلالها أنّ الأُمّة فقدت هويتها ودينها، وأصبحت أُمّة مفكّكة ضعيفة الإرادة واهية العزيمة؛ ما مثّل انتكاسةً وتراجعاً خطيراً بسبب خذلانها لقادتها الشرعيين، وتركها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والباطل.
شواهد نصّية على حصول انتكاسة الأُمّة بعد عاشوراء
في طيّات مواقف الإمام الحسين عليه السلام وبياناته وخطبه، بإمكان المتابع أن يرصد بعض عباراته التي تدلّ على أنّ الإمام كان يستشرف مستقبل الأُمّة، وما يؤول إليه مستقبلها، من الوقوع في الذلّ والخوف والهوان، فيما إذا خانت أمانتها وقصّرت في أداء واجبها، ولم تنصر الحقّ ليس فقط بعدم الوقوف إلى جانب أهله، بل بنصرة أهل الباطل وتقديم الدعم والعون لهم، بقتال أهل الحقّ ومناجزتهم وقتلهم، ففي إحدى المواقف التي يُسجّلها لنا التاريخ حين يصل إلى منطقة في طريقه إلى الكوفة، يلتقي به رجل من أهل الكوفة يكنّى أبا هرم، فيسأله عن السبب الذي أخرجه من المدينة، فيبادره الإمام بجواب فيه نوع من الشدّة: ((ويحك! يا أبا هرم! شتموا عرضي فصبرت، وطلبوا مالي فصبرت، وطلبوا دمي فهربت))، ثمّ يُبيّن له ما سيلاقيه من القتل على أيدي هؤلاء، وما سيحلّ بهم نتيجة ذلك ((وايْمَ الله، ليقتلُنّي، ثمّ ليُلبسنّهم الله ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً، وليُسلّطنّ عليهم مَن يذلّهم))[26].
ويظهر من كلام الإمام ـ حين وصف الذلّ الذي سيحلّ بهم بأنّه شامل ـ أنّهم سيتجرّعون مرارة الذلّ على أكثر من صعيد، سوى ما يعانونه من القتل والتنكيل على أيدي حكّام الجور والظلم، وهذا ما حصل فعلاً وشهده تاريخ المسلمين، ولا نظنّ أنّ القضية مختصّة بمَن باشروا قتل الإمام عليه السلام ، وإنّما يشمل كلّ مَن علم بثورته ونهضته ولم ينصره خوفاً أو طمعاً، وكلّ مَن رضي بذلك ممّن عاصر نهضته أو من الأجيال اللاحقة.
وفي قصّة مشابهة لهذه القصّة، يلتقي به رجل يكنى أبا هرّة، ويسأله السؤال ذاته المتقدِّم، ويُجيبه الإمام عليه السلام بالجواب نفسه، ولعل القصّتين قصّة واحدة وحصل تصحيف في الاسم، ولكن الإمام عليه السلام بعد قوله: ((وليُسلطنّ عليهم مَن يذلّهم))، يضيف: ((حتى يكونوا أذلّ من قوم سبأ؛ إذ ملكتهم امرأة منهم، فحكمت في أموالهم وفي دمائهم))[27]، وهو ما يرمي إلى أنّ الأُمّة بعد قتلها الحسين عليه السلام سيتحكّم بمصيرها ومقدراتها أراذلُها؛ حتى يوردوها في مهاوي الردى والهلكة، ويظلّ أهل العقل والرأي مقهورين مقموعين، كما حصل مع قوم سبأ، بل هم أضلّ؛ لأنّ تلك المرأة كانت تمتلك رجاحة في عقلها دلّ عليه تصرفها مع طلب النبي سليمان عليه السلام .
ولكن تبقى المرأة بشكل عامّ لا تمتلك مقوّمات القيادة التي تحتاج إلى حزم وقوة وصبر وثبات في المواقف الصعبة والحرجة، وبما أن المرأة لا تتمتع بهذه الأُمور بحكم طبيعة تكوينها؛ فيصبح تبوّؤ المرأة لمنصب الحكم والقيادة بدل الرجال علامة على ذلّ وهوان هؤلاء الرجال.
وفي نصّ آخر يعطينا الإمام صورة تُبيّن لنا مدى ما يصل إليه القوم من الامتهان والذلّ، عندما يقدمون على قتله وانتهاك حرمات الله، فيصفهم بأنّهم سيكونون أذلّ من الخرقة التي تضعها المرأة في فرجها أيام حيضها، وهو ما رواه الطبري وابن عساكر، عن الإمام الحسين عليه السلام ، قال: ((والله، لا يدعوني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي، فإذا فعلوا سلّط الله عليهم مَن يذلّهم حتى يكونوا أذلّ من فرم الأَمة))[28]، وذكرها في الكامل في التاريخ بلفظ: ((حتى يكونوا أذلّ من فرام المرأة))، ثمّ قال: ((والفرام خرقة تجعلها المرأة في قُبلها إذا حاضت))[29].
وهذه النصوص لا تحتاج إلى تعليق لبيان دلالتها على ما يُصيب هؤلاء من ذلّ وانحطاط، جرّاء ما عملت أيدهم من انتهاك حرمات الله بخذلان الحسين عليه السلام ، ثمّ قتله هو وأهل بيته وأصحابه، وسبي ذراريهم، وانتهاب ثقلهم.
نعم، وإن قيل: إنّ هذه النصوص ربما تختصّ بالذين باشروا هذه الأعمال، لكن يمكن أن تعمّ كلّ مَن هُم على شاكلتهم في ذلك الوقت، من أعوان الظلمة وسلاطين الجور، وممّن سيأتي بعدهم على مرّ الدهور، وهم كُثُر طالما تظاهروا على أهل الحقّ من الأئمة والمصلحين والثائرين، ومارسوا ضدّهم كلّ أشكال الاضطهاد والاستبداد.
وبهذا البيان الذي تقدّم، ومن خلال ما عرضناه سريعاً من وقائع تاريخية وشواهد نصّية تشهد بمجموعها على صحّة الرؤية، التي تذهب إلى أنّ الأُمّة انتكست بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام وأصابها الوهن والضعف في مجمل تاريخها، إلاّ من بعض الفترات المضيئة هنا وهناك.
الرؤية الثانية: نهضة الحسين وإيقاظ الأُمّة
في قبال ما تقدَّم من قراءةٍ حول مصير الأُمّة بعد أحداث عاشوراء هناك انطباع مغاير وقراءة تختلف في نظرتها للمجتمع الإسلامي عن القراءة الأولى، وهي وإن تقبل في حدود معيّنة أنّ الأُمّة وقعت في كثير من الكبوات في مسيرتها، وعاشت في فترات من الركود أو التراجع، إلاّ أنّها في الوقت عينه تعتقد بأنّ نهضة الإمام الحسين عليه السلام وأحداث عاشوراء المؤلمة ساعدت الأُمّة على الاحتفاظ بالعديد من عناصر قوّتها وحيويّتها، وجعلتها أُمّة تنبض فيها روح الرفض والثورة، ومنحتها الحصانة ضد التيارات والأهواء التي تعمل على انسلاخ الأُمّة عن دينها وهويتها؛ وذلك من خلال ما أفرزته عاشوراء من نتائج ومعطيات عديدة.
نتائج ومُعطيات النهضة الحسينيّة
أولاً: نزع غطاء الشرعيّة عن سلطة بني أميّة وبيان أحقّيّة أهل البيت عليهم السلام
إنّ معاوية بن أبي سفيان رغم كلّ سلوكياته وأفعاله المجانبة للحقّ وتعاليم الدين الإسلامي، لكنّه عمل جاهداً على الحفاظ على صورته أمام المسلمين وتقديم نفسه على أنّه صحابي وكاتب للوحي وعامل للخليفة الثاني والثالث على بلاد الشام، والمُطالب بدم الخليفة عثمان، وغيرها من الأمور التي انطلت على قطاعات واسعة من بسطاء الأُمّة، لكنّه عندما نصّب ابنه يزيد خليفة على المسلمين كان لا بدّ من الوقوف بوجه هذه الخطوة ونزع الغطاء الشرعي عن يزيد وحكومته، وتقديم البديل الشرعي عنه وهم أهل البيت عليهم السلام ، وهذا ما قاله الحسين عليه السلام للوليد بن عتية والي المدينة عندما طلب منه البيعة: ((أيها الأمير، إنّا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وبنا فتح الله، وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر، قاتل النفس المحرَّمة، معلِن بالفسق، ومثلي لا يُبايع مثله))[30].
هذا وقد أشرنا في بداية المقال إلى ما رُوي عن الإمام عليه السلام من أنّه قال: ((ولقد سمعت جدي يقول: الخلافة محرّمة على آل أبي سفيان))[31]؛ فهم طلقاء هذه الأُمّة، الذين لم يترسّخ الإيمان في قلوبهم، وما أسلموا إلاّ حين رأوا جحافل المسلمين تدخل فاتحةً مكةَ ومطهرةً لها من بقايا الشرك والأوثان.
وبيّن الإمام عليه السلام في مناسبة أُخرى شروط الحاكم الشرعيّة التي يجب توفرها فيمَن يتولّى أُمور المسلمين، وليس كلّ من يستولي على الحكم ـ ولو بالقهر والغلبة ـ على الأُمّة أن تطيعه، وذكر هذه الشروط حين ردّ على كُتب أهل الكوفة التي وصلته وهو في مكة، فقال عليه السلام : ((فلعمري، ما الإمام إلاّ العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط، والدائن بالحقّ، والحابس نفسه على ذات الله))[32].
وهذه المواصفات أبعد ما تكون عن يزيد وأترابه من بني أُمية، ولا تنطبق إلاّ على الحسين وأهل البيت عليهم السلام ، فالإمام الحسين عليه السلام بنهضته المباركة ثبّت أركان هذا الأصل الذي جاء به الإسلام وبلّغه النبي صلى الله عليه وآله بعد أن كاد بنو أُمية أن يطمسوه ويغيّروا معالمه بتأسيس ضوابط جديدة للحاكم الإسلامي، بعيدة عن روح الإسلام ورسالته الحقّة.
وقد أتت النهضة الحسينيّة أُكُلَها في مسألة إسقاط الشرعيّة عن بني أُميّة، بعد برهة وجيزة من الزمن حين هلك يزيد بن معاوية سنة أربع وستين للهجرة، وكان قد استخلف ابنه معاوية بن يزيد، فقام معاوية هذا خطيباً في الناس مبيّناً عدم شرعيّة خلافة بني أُمية، وأنّهم مغتصبون لها من أصحابها الشرعيين، فقد روى اليعقوبي في تاريخه أنّ معاوية بن يزيد قال في خطبته: ((ألا وإنّ جدي معاوية بن أبي سفيان نازع الأمر مَن كان أولى به منه في القرابة برسول الله، وأحقّ في الإسلام، سابق المسلمين، وأول المؤمنين، وابن عمّ رسول ربّ العالمين، وأبا بقية خاتم المرسلين))[33]، ولم يبقَ في الحكم إلاّ ثلاثة أشهر أو أربعين يوماً ـ على اختلاف الأقوال[34] ـ ثمّ توفي في ظروف غامضة، وعصفت الاختلافات في الدولة الأُموية، وعاشت فراغاً سياسيّاً كاد أن يطيح بها لولا تولي مروان بن الحكم مقاليد السلطة في اللحظات الأخيرة.
وقد ظلت الدولة ـ رغم سيطرتها على الناس بالحديد والنار، واستمالتها لبعضهم بالمناصب أو الأموال ـ تفتقر للغطاء الشرعي في حكمها للمسلمين؛ ما حدا بالدعوة العباسيّة أن تنجح في رفعها شعار الأحقّيّة بالحكم من بني أُمية لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، في إسقاط الدولة الأُموية وتأسيس الدولة العباسيّة على أنقاضها.
ثانياً: دور المظلومية والمأساة في استنهاض الأمّة
ما إن أفِلَت شمس العاشر من المحرّم سنة ستين للهجرة حتى استفاقت الأُمّة على هول المصيبة التي وقعت، وهي ترى آخر سبط للنبي صلى الله عليه وآله مذبوحاً قد فُصل رأسه عن جسده، وسائر إخوته وأهل بيته كباراً وصغاراً، وأصحابه، تطؤهم الخيل بحوافرها، ونساءه يفررن من مكان إلى مكان، وقد أُحرقت الخيام وسُلبت النساء، وأُخذن سبايا من بلد إلى بلد، مع رؤوس ذويهن هدايا إلى طغاة بني أُميّة.
إنّ أبلغ الكلمات وأفصح العبارات، وأرجح العقول والأفكار لتقف عاجزة عن وصف جانب من جوانب هذه المأساة، التي لم يأتِ بمثلها التاريخ.
لعلّ من أهمّ الوسائل التي أراد الله سبحانه أن يستخدمها في إحداث الإصلاح الشامل هو جانب المأساة في واقعة عاشوراء، والمظلوم المحقّ يكسب تعاطف جميع أفراد المجتمع على اختلاف ميولهم، واتجاهاتهم، وأعمارهم، وثقافاتهم، فكيف إذا كانت المظلومية بهذه الصورة التي يعجز عنها الوصف!
فالمأساة لغة تفهمها كلّ شرائح المجتمع وطبقاته، وهي تلامس شغاف قلوبهم، وتخاطب وجدانهم وأحاسيسهم، فتحدث طاقة كامنة تحركهم للاصطفاف إلى جانب مَن حصلت له المأساة، ونصْرته والتأثّر بأفكاره وأطروحاته؛ ولذا فقد رأينا بمجرَّد إسدال الستار على فصول مأساة كربلاء، حتى انفجر بركان النهضة الحسينيّة في وجه أعدائها، فالتهَمَ واحداً بعد الآخر، بعد انتشار موجة الرفض وتصاعد وتيرة الكراهية لكلّ ما يمتّ إلى بني أُميّة ودولتهم بصلة، فلم تدم حكومة يزيد أكثر من أربع سنوات، وهلك وهو لا يسيطر إلاّ على أجزاء قليلة من المناطق الإسلاميّة، التي استأثرت بها الدولة الزبيريّة الممتدة من الحجاز إلى العراق وأجزاء من الشام.
وهكذا ظلت شعلة النهضة الحسينيّة متّقدة، تستمدّ وقودها ممّا أورثته مأساة كربلاء ومظلوميتهم من حرارة قلوب المؤمنين، وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: ((إنّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً))[35]، وما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام : ((أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلاّ استعبر))[36].
أثر أهل البيت في تجذير المأساة في أعماق الأُمّة
سعى أهل البيت عليهم السلام على إبقاء ذكرى الحسين عليه السلام ومأساة كربلاء حيّة في قلوب المؤمنين، وفي كل زمان ومكان لإدامة زخم الثورة الحسينيّة؛ لتحقيق هدفها في الإصلاح والتغيير، فجاء في كثير من رواياتهم التأكيد على الجانب المأساوي في حادثة عاشوراء، بالإشارة إلى بعض مشاهدها المؤلمة، فعن الإمام الرضا عليه السلام : ((إنّ المحرّم شهر كان أهل الجاهلية يحرِّمون فيه القتال، فاستُحلّت فيه دماؤنا، وهُتكت فيه حرمتنا، وسُبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأُضرمت النيران في مضاربنا، واُنتهب ما فيها من ثقلنا، ولم تُرعَ لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا))[37].
ويؤكّدون كذلك على أنّ مصيبة الحسين عليه السلام أعظم وأشدّ من المصائب التي مرّت على أهل البيت عليهم السلام [38]، وأنّ يوم الحسين أقرح جفونهم، وأسبل دموعهم، وأذلّ عزيزهم، بأرض كرب وبلاء، أورثتهم الكرب والبلاء، إلى يوم الانقضاء[39]. وكان يبدو عليهم الحزن الشديد والأسى، وتعلو وجوههم الكآبة في مواسم عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام . ويحثّون أصحابهم وشيعتهم أيضاً على إظهار الحزن والتفجّع على مصائب أبي عبد الله، والبكاء حزناً على ما جرى عليه من مصائب وويلات، وبيّنوا عظيم الثواب وجزيل الأجر على تلك الأعمال، وأمروا بإقامة المآتم والمجالس الحسينيّة التي تُذكر فيها ـ إلى جانب الوعظ والإرشاد ـ مصائب أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه، ووحشية ظالميهم؛ كي تبقى مصيبة الحسين عليه السلام غضّة طريّة متجددة تُحرّك في الأُمّة مشاعر الاستنكار لكلّ أشكال الظلم والاستبدال والجور على طول التاريخ تأسياً بالإمام الحسين عليه السلام .
وفعلاً كانت مواسم عاشوراء تمثلّ مصدر قلق وصداع للأنظمة المستبدّة في جميع الأزمنة؛ لأنّهم يخشون من حصول بيئة مناسبة لحدوث الانتفاضات والثورات على أنظمتهم، فنراهم يعملون على منعها بكلّ الأشكال والصور، وهذا ما حصل أيام النظام البعثي المستبدّ الذي حكم العراق، فحارب الشعائر الحسينيّة وحاول منع زيارة الحسين عليه السلام ، ومارس الظلم والقهر في حقّ الموالين والمحبّين لأهل البيت عليه السلام .
ثالثاً: هاجس الشعور بالذنب وتأنيب الضمير
ومن المعطيات المهمّة التي أفرزتها واقعة عاشوراء، وكان لها أثر مهم في إيقاظ الأُمّة واستنهاضها هو ما حصل من شعور كبير بالتقصير والندم لدى شرائح واسعة من الأُمّة الإسلامية، لا من جهة واقع عاشوراء المأسوي وما حصل من مصائب وآلام، لكن من جهة أنّ الأُمّة أحسّت بأنّها ارتكبت خطأً جسيماً وذنباً لا يُغتفر بترك الحسين عليه السلام وحيداً في مواجهة أعدائه من دون أن تُقدِّم له العون والنصرة ومقاتلة خصومه وظالميه.
إنّ الشعور بالذنب وتأنيب الضمير جعل فئة كبيرة من المسلمين تقدم على أفعال أرادت بها أن تخفف عنها الإحساس بهذا الشعور، ولعلّها تكفّر بذلك عمّا أقدمت عليه، وأوضح مثال لهذه الجماعة هم التوابون الذين ظهروا في الكوفة، وصمموا على الثورة ضد الأُمويين، عندما تهيأت الظروف، يقودهم إحساسهم بالذنب والندم على ما فرَّطوا في جنب الإمام الحسين عليه السلام ، قال ابن الأثير: ((لمّا قُتِلَ الحسين ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة ودخل الكوفة تلاقته الشيعة بالتلاوم والمنادمة، ورأت أن قد أخطأت خطأً كبيراً بدعائهم الحسين وتركهم نصرته وإجابته، حتى قُتِلَ إلى جانبهم، ورأوا أنّه لا يغسل عارهم والإثم عليهم إلاّ قتل مَن قتله والقتل فيهم))[40].
ونظراً إلى أنّ حركتهم نابعة من شعورهم بالخطيئة والذنب، ولكي ينصحوا في توبتهم، رفضوا عرضاً من عبد الله بن يزيد الأنصاري عامل ابن الزبير على الكوفة، يقضي بإمدادهم بقوّة عسكرية، فخرجوا حتى وصلوا إلى قبر الحسين عليه السلام ، فبكوا وتابوا على خذلانهم، ثمّ قرروا المسير إلى الشام لمقاتلة بني أُمية[41].
ثمّ تطوّرت فكرة الإحساس بالذنب والندم إلى فكرة الانتقام من قتلة الإمام الحسين عليه السلام والأخذ بثأره، فبدأت حركات وثورات تقوم على مبدأ الثأر، كالحركة التي قادها المختار الثقفي في الكوفة، التي استطاع من خلالها تصفية رموز وقادة الجيش الأُموي الخارج لحرب الحسين عليه السلام وفي مقدِّمتهم عبيد الله بن زياد.
نعم، يمكن القول: بأنّ هذا العنصر الذي أفرزته النهضة الحسينيّة وساهم في خلق ردّة فعل لدى الأُمّة على الفساد والانحراف ـ وإن كانت له فاعليّة ـ إلاّ أنّه كان محدود الزمان والمكان.
نعم بالإمكان القول: بأنّ شعار يا لثارات الحسين ظلّت ترفعه العديد من الحركات والثورات في الإسلام، وإلى يومنا هذا؛ لأنّ الحسين عليه السلام أصبح يمثّل ثورة ضد كلّ مظاهر الانحراف والفساد والظلم، مضافاً إلى الثورات والحركات التي قامت على أُسس الإحساس بالندم والخطيئة، كل ذلك مثّل علامة فارقة في التاريخ الجهادي والنضالي، وأمسى مصدر إلهام للعديد من الثورات وحركات الرفض، وأُنموذجاً قابلاً للاحتذاء والتطبيق في كلّ عهد وزمان.
رابعاً: حادثة عاشوراء أعادت تثمين المبادئ الدينيّة
إنّ الإنسان بحكم ما في تركيبته من جانب مادي وأرضي قد يركن إلى حبّ السلامة والدعة، والتعلُّق بما في هذه الحياة الدنيا، من جاه وسلطة ومال وبنين وملذات أخرى، فإذا ما وُضِعَ الإنسان المسلم يوماً على المحكّ، وصار عليه أن يختار إمّا حياته الدنيا بما فيها من مزايا، وإمّا دينه وآخرته، وهذا هو الامتحان الصعب الذي لم يجتزه كثير من المسلمين، كما يشهد بذلك تاريخنا الإسلامي وواقعنا المعاصر، لكن الذي نعتقده أنّ الشيء الأساس الذي يؤدّي بالإنسان المسلم إلى الفشل في مثل هذا الاختبار ليست الجنبة المادّية والتعلّق بالدنيا، وإنّما هو غياب الوعي والإدراك الحقيقي لقيمة العقيدة والدين وجعلهما في مرتبة دانية في سلّم أولوياته وحساباته.
إنّ غياب هذا الإدراك والفهم الصحيح لمكانة الدين في حياة الإنسان ـ الفرد المسلم ـ تساهم فيه عوامل عديدة، من أهمّها ترك المنبع الصافي للدين وتعاليمه والأخذ من مصادر شتى، فتأتي الصورة مشوهة غير واضحة المعالم، وهو ما كان عليه الأمر حين أُقصي أهل البيت عليهم السلام عن الساحة الإسلامية، وقُدِّم غيرهم على أنّهم مرجعيات دينيّة للأُمّة الإسلامية.
ومن العوامل الأُخرى هو سعي الحكّام والظَلَمة على ترسيخ حبّ الدنيا وإضعاف الوازع الديني عند المسلمين، وإبعادهم عن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ كي يكونوا في مأمن من غضب الجماهير وثورتها على تصرفاتهم وممارساتهم البعيدة عن الإسلام.
وقد أشار الإمام الحسين عليه السلام إلى الواقع الذي وصلت إليه الأُمّة في علاقتها الضعيفة بدينها، والتي لم تكن مستعدّة أن تضحِّي بوسائل عيشها وأسباب رزقها إذا ما هُددت في دينها وعقيدتها، وتعرّضت للبلاء والامتحان، فقال عليه السلام : ((إنّ الناس عبيد الدنيا، والدين لَعِقٌ على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم، فإذا مُحِّصوا بالبلاء قلّ الديّانون))[42]، وهو المضمون نفسه الذي ذكره القرآن في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الخُسْرَانُ المُبِينُ}[43].
فجاءت النهضة الحسينيّة لتعطي القيمة الحقيقية للعقيدة والدين، وتثمّن المبادئ الإسلاميّة بشكل عملي وتجسيد حيّ، فأوضحت من خلال أحداث كربلاء وما قُدّم فيها من تضحيات وعطاءات أنّ كلّ ما يمتلكه الإنسان المسلم لا يساوي شيئاً إذا ما قيس إلى دينه وعقيدته، فإذا خسر الإنسان دينه وعقيدته لا يشفع له ما حازه من حطام الدنيا مهما كان عظيماً وكبيراً.
لقد قطع الإمام الحسين عليه السلام الطريق على كلّ من يُقَدِّم الذرائع والحجج في أنّه يريد الحفاظ على نفسه، أو أهله، أو ماله، أو عرضه في حال تفريطه بدينه ومبدئه، فإنّ الإنسان المؤمن وإن كان يجب عليه الحفاظ على نفسه وماله وأهله، وصيانته عرضه، ولكن إذا تعارض مع حفظ المبدأ، عليه أن يبذل ذلك كلّه في سبيل دينه ومعتقده الحقّ، وقد كان هذا الأمر واضحاً في كلام الإمام عليه السلام مع أصحابه وأهل بيته عندما تجهّز للخروج من مكة، قائلاً: ((مَن كان باذلاً فينا مهجته، وموطناً على لقاء الله نفسَه؛ فليرحل معنا، فإنّني راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى))[44]، وكذلك يمكننا أن نستظهر وجوب تقديم الدين والمبدأ على المال والنفس والأهل، ولا أن تكون الأُمور معكوسة والأولويات منكوسة من المحاورة التي حصلت بين الإمام الحسين عليه السلام وعمر بن سعد عشية العاشر من المحرّم، فسأله الإمام أن يتقي الله ولا يقاتله، وهو يعلم مَن هو الحسين عليه السلام ، وأن يذر هؤلاء القوم وينضمّ إليه؛ فإنّ فيه رضا الله سبحانه، فأجابه عمر بن سعد بأنّه يخاف أن تُهدم داره، وتُؤخذ ضيعته، أو يُقتل عياله، فتركه الإمام عليه السلام حين وجد أن عمر بن سعد لا يعبأ لدينه وآخرته، ولا يقدمهما على دنياه[45].
وهكذا كان للإمام الحسين عليه السلام بتسطيره لهذه الملحمة البطولية الفريدة، أثر واضح في تعميق هذه المفاهيم في وجدان الأُمّة؛ ليجعل منها أُمّة لم تمتْ فيها معاني التضحية والفداء، وبذل الغالي والنفيس في طريق الحقّ وحفظ المبادئ والدين، وظلّت حركات الجهاد والتحرر تستقي قيم التضحية والبذل والعطاء من معين عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام الذي لا ينضب.
خامساً: معايير النصر والهزيمة في نظر الحسين عليه السلام
في الغالب تُحسب نتائج النصر والهزيمة وفق الحسابات المادّية والآنيّة، وهو فيما إذا استطاع أحد الأطراف إنزال الهزيمة بخصمه من خلال قتله، أو تدمير معداته، أو إجباره على الاستسلام، أو الفرار، أو الانسحاب، فإنّ هذا الطرف يعدّ منتصراً حينئذٍ.
ولكن هذه النظرة في تقييم نتائج الصراع قاصرة وغير دقيقة؛ إذ لا بدّ أن تكون النظرة أكثر بُعداً وعمقاً وشمولاً لكلّ جوانب المسألة، فربما تجد جهةٍ ما استطاعت أن تنزل هزيمة عسكرية آنيّة ساحقة بعدوها، ولكن النتائج في المستقبل في غير صالحها، فيتحوّل هذا النصر العسكري إلى كابوس يقضّ مضاجعها، وتميل كفّة النصر إلى صالح المنهزم والمقتول، وهذا ما أفرزته نتائج نهضة الإمام الحسين عليه السلام ؛ إذ أعطت معايير جديدة وصحيحة لتقويم نتائج الفوز والخسارة في موازين الصراع والمعارك الحاصلة بين الخصوم، فإنّ النتائج الآنيّة والأولية تؤشر انتصار الجيش الأُموي في معركة كربلاء، وقتل الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه، وانتهاب ثقله وسبي حرمه، لكنّ الطريقة المثلى هي التي أدار بها الإمام الحسين عليه السلام دفّة الصراع والخطوات الصحيحة التي اتّخذها منذ بداية نهضته وخروجه من المدينة وتوجهه إلى مكة، ثمّ العراق ووصوله إلى كربلاء.
بل كان الإمام الحسين عليه السلام واثقاً من تحقيق هذا الانتصار الباهر طبق الموازين، حين كتب إلى أخيه محمد بن الحنفية، وسائر بني هاشم: ((أمّا بعد، فإنّ مَن لَحِق بي استشهد، ومَن لم يلحق بي لم يدرك الفتح))[46].
إنّ هذه العبارة من الإمام وقعت مورداً للبحث والتحليل، وهناك بعض التفسيرات لها، كقول العلاّمة المجلسي: ((قوله عليه السلام : لم يبلغ الفتح. أي: لم يبلغ ما يتمنّاه من فتوح الدنيا والتمتّع بها، وظاهر هذا الجواب ذمّه، ويحتمل أن يكون المعنى أنّه عليه السلام خيَّرهم في ذلك، فلا إثم على مَن تخلّف))[47].
ولكننا نظنّ أنّها تفسيرات بعيدة عن مراده عليه السلام ، والأقرب هو ما نحن بصدده من أنّه عليه السلام كان يدرك تمام الإدراك أنّه سيحقق النصر والفتح العظيم بتحقيق أهداف نهضته من الإصلاح والتغيير، وزوال دولة الظلم والجور، وأنّهم بشهادتهم سيحققون هذا النصر المؤزّر، وينالون هذه المنزلة العظيمة التي سيُحرم منها مَن لم يلتحق بهذه النهضة.
إنّ إطلالة سريعة لمُجمل أحداث التاريخ تبيّن وضوح الرؤية التي بيّنها الإمام عليه السلام في قوله السالف الذكر، فقد أعطت النهضة الحسينيّة نتائج باهرة، فعلى المستوى السياسي لم يتمكّن بنو أُميّة من الاستمرار في الحكم، سوى حفنة من السنين الممتلئة بالمشاكل والاضطرابات لتنتهي على يد الدولة العباسية بشعار الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله، وهذا ما تحقق أيضاً في الدولة العباسية، فقد قامت عدّة انتفاضات وثورات ضدها استلهمت النموذج الحسيني في أُسلوبها[48]، وأما على الصعيد الاجتماعي والديني، فما زالت النهضة الحسينيّة إلى يومنا هذا نبع عطاء لا ينضب.
وينبغي الإشارة إلى أن عاشوراء الحسين عليه السلام أحيت بعض القيم والمبادئ النبيلة وأعطتها دفعة معنوية، ومنها مبدأ الموت في عزّ وشرف أحلى من الحياة في ذلّ وهوان في ظل الظالمين والمتجبِّرين ((وإنّي لا أرى الموت إلاّ سعادة، والحياة مع الظالمين إلاّ برماً))[49]، وكذلك مبدأ الثبات في المواجهة حتى النهاية، وعدم الجنوح نحو الاستسلام المذلّ أو الفرار المهين؛ الأمر الذي يفرض الثائر من خلالِه احترامَه وتقديرَه على الجميع.
لا شكّ في أنّ هناك معطيات ونتائج أُخرى ولّدتها النهضة الحسينيّة ـ غير ما ذُكر ـ ساهمت في استنهاض الأُمّة وإيقاظها، وحافظت على روح الرفض فيها لكلّ أشكال الخنوع والذلّ، ويشهد لذلك ما تشهده البلاد الإسلاميّة من مظاهر الصحوة والنهوض في القرن الأخير من هذا الزمان.
نظرة توفيقية:
وفي نهاية المطاف يمكن الملائمة والتوفيق بين الرؤية الأُولى القائلة: بأنّ الأُمّة باءت بالذلّ والصَغار بعد تخليها عن نصرة النهضة الحسينيّة والاستفادة منها، وبين الرؤية الثانية التي عرضناها آنفاً، بأنّ نقول: إنّ النهضة الحسينيّة ـ باعتبارها محطّة مهمة وأساسيّة في المسيرة التكامليّة للبشرية ـ ينتفع بها مَن يلتحق بها أو يتزوّد من عطائها ويستفيد من فيضها، ويتضرر مَن يعرض عنها أو يكون في الجهة المناوئة لها؛ فيصيبه الذلّ والهوان، ويبوء بالخيبة والخسران، ولعلّ هذا حال الكثيرين في الأُمّة الإسلاميّة، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أنّ النهضة الحسينيّة كانت السبب في وقوع الأُمّة في وهاد الانحطاط والذلّ، فمثلها في ذلك كمثل دعوات الأنبياء والرسل فاز فيها قوم وضلّ وخسر آخرون، قال تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا[50].
[1] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329. الخوارزمي، مقتل الحسين عليه السلام : ج1، ص88.
[2] اُنظر: العصفري، خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط: ص133.
[3] الحلي، ابن نما، مثير الأحزان: ص15.
[4] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص18.
[5] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص381.
[6] عدّ بعض المفكرين مسألة استلام الحكم من دوافع وأهداف الثورة الحسينيّة، في معرض حديثه عن الأهداف والدوافع المتصوّرة وما هو الصحيح منها. اُنظر: الشاهرودي، محمود، محاضرات في الثورة الحسينيّة: ص50 وما بعدها.
[7] الحرّاني، ابن شعبة، تحف العقول: ص239.
[8] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص329ـ330.
[9] المصدر السابق: ج44، ص340ـ341.
[10] المفيد، الإرشاد: ج2، ص70. اُنظر: البلاذري، أنساب الأشراف: ج3، ص167.
[11] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص42.
[12] المفيد، الإرشاد: ج2، ص79.
[13] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص382.
[14] اُنظر: الشاهرودي، محمود، محاضرات في الثورة الحسينية: ص51ـ58.
[15] الشريف المرتضى، تنزيه الأنبياء: ص228ـ229.
[16] الإربلي، علي بن أبي الفتح، كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج2، ص242.
[17] الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، الأمالي: ص216.
[18] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص381.
[19] ابن كثير، البداية والنهاية: ج8، ص170. الحلي، ابن نما، مثير الأحزان: ص17.
[20] الكوفي، ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص19.
[21] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص331ـ332.
[22] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص157.
[23] الرعد: آية11.
[24] اُنظر: سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأُموية: ص89.
[25] اُنظر: سهيل طقوش، تاريخ الدولة العباسية: ص243.
[26] الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، الأمالي: ص218.
[27] الكوفي، ابن أعثم، الفتوح: ج5، ص71. اُنظر: الحلي، ابن نما، مثير الأحزان: ص33.
[28] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص296. ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج14، ص216. وفي رواية: «حتى يكونوا أذلّ فرق الأُمم». المفيد، الإرشاد: ج2، ص76.
[29] ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص39.
[30] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص17.
[31] الحلي، ابن نما، مثير الأحزان: ص15.
[32] الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري: ج4، ص262.
[33] اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي: ج2، ص254.
[34] اُنظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: ج59، ص302.
[35] النوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل: ج10، ص318.
[36] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص215.
[37] الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، الأمالي: ص190.
[38] اُنظر: الحرّ العاملي، وسائل الشيعة: ج14، ص503.(آل البيت).
[39] اُنظر: الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، الأمالي: ص190.
[40] ابن الأثير، الكامل في التاريخ: ج4، ص158.
[41] اُنظر: سهيل طقوش، تاريخ الدولة الأموية: ص71.
[42] الحرّاني، ابن شعبة، تحف العقول: ص245.
[43] الحج: آية11.
[44] ابن طاووس، اللهوف في قتلى الطفوف: ص38.
[45] اُنظر: المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج44، ص388.
[46] ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات: ص157.
[47] المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار: ج42، ص81.
[48] ومنها على سبيل المثال: ثورة بطل فخ، وهو الحسين بن علي بن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى بن الحسن السبط عليه السلام ، وقد ثار في زمن الهادي العباسي سنة مائة وتسع وستين للهجرة. انظر: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الطبري: ج6، ص410 وما بعدها.
[49] ابن شهرآشوب، مناقب آل أبي طالب: ج3، ص224.
[50] الإسراء: آية82