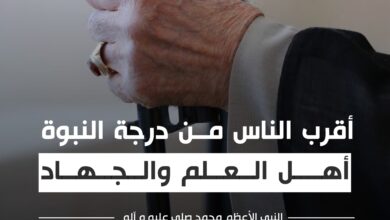أولاً: لم تكن الخلافة في المفهوم الإسلامي حقّاً يورث، ولكنَّ السّلطة التي استبدّت بالحكم في عصر عثمان أرادت أنْ تجعلها كذلك؛ ففي المحفل الحاشد الذي ضمّ كثيراً من المسلمين بينهم عثمان والإمام علي عليهالسلام، جاء أبو سفيان شيخ بني اُميّة والوجيه لديهم، وهم الحزب الحاكم على الأوساط السياسيّة في البلاد الإسلاميّة ذلك اليوم، جاء يتفقّد طريقه بِعَصاً يحملها وقد كُف بصره -وكان آنذاك قد شعر بانتهاء دوره في الحياة واقتراب منيَّته- فسأل أحد الجالسين: هل في الحفل مَن يُخشى منه من غير بني اُميّة؟ قال له رجل: ليس ها هنا رجلٌ غريب. فقال: تَلَقَّفوها -أي السّلطة- تَلَقُّفَ الكرة، فو الذي يحلف به أبو سفيان، لا جنَّة ولا نار.
فأصاخ إليه كلّ سمع كان في بني اُميّة، ووعى نصيحته بكلّ التفات، ولَم يعترض عليه يومئذ سوى أمير المؤمنين عليٍّ عليهالسلام، إذ وبَّخه على إعلانه الكفر وأنَّبه، فاعتذر قائلاً: لقد كنتُ مغروراً بهذا الرجل الذي نفى وجودَ أيِّ غريب في المجلس، وإلاّ لم يكنْ من الحزم أنْ اُصارح مثلك بهذا.
وانتهى الحفل وتفرّق الجمع، إلاّ أنّه كان ذا تأثير كبير في تسيير الأوضاع السياسيّة لمستقبل المسلمين.
أجل، قد أفصح قول أبي سفيان عن خطّة له مدروسة ساعده على تنفيذها الحزب الاُموي أوّلاً، ومَن ابتغى السّلطة، بل ومَن ابتغى تقويض الاُسس الإسلاميّة لأضغان قديمة وأحقاد متراكمة.
ثانياً: تلك هي رغبة السّيطرة على الحكم، ثمّ يَسهل عليهم كلّ ما يشاؤون.
وأبو سفيان -وهم معه- كانوا يستسهلون كلَّ صعب، ويستحسنون كلّ قبيح في سبيل ذلك، ماداموا لا يعتقدون بجنّة أو نار، ولا يؤمنون بنبيٍّ أو وصيٍّ، ولا يُبالون لأيّ مُقدَّس يُدحض، وأيّ شرف يُدنَّس، وأيّة سُمعةٍ تُساء؛ فإنّ أمامهم غاية يُبرّرون في سبيل الوصول إليها كلَّ واسطة، بل يعتبرون كلَّ واسطة تُؤدّي إليها أمراً مُقدَّساً ومُحرَّماً، تماماً كالفكرة الجاهليّة التي تمكّنت من أدمغتهم البالية.
وحينما نُجري مع الأحداث التي مرّت بالعالم الإسلامي من أواخر عهد عثمان حتّى قيام الدولة العباسيّة، نجد أوفق التفاسير لها هذا الذي قدّمناه لك الآن من كلام أبي سفيان، واعتقاده ومَن تابعه.
فالحروب التي رافقت عصر الإمام علي عليهالسلام، والحُرمات التي هُتكتْ في عصر معاوية، والغارات التي شُنّتْ في عهد يزيد، والمعارك التي شبَّتْ واُضرمتْ في عهد سائر الخلفاء الاُمويّين، كانت جميعاً جارية على هذا المبدأ، ومنفِّذة لهذه الخُطّة المدروسة.
فالحزب الاُموي لم يُفكّر إلاّ في ابتزاز الأموال وتشكيل السّلطان، واستعباد الخلق بكلّ وسيلة. ومَن أراد تفكيك الأحداث السياسيّة في هذه الحقبة الطويلة عن هذه الحقيقة الصريحة، فقد أراد تفكيك المعلول عن علَّته، والمسبِّب عن سببه.
الحقّ الموروث
وهكذا فإنّ الحزب الاُموي شاء أنْ يجعل الخلافة حقّاً شخصيّاً وموروثاً منذ استبدّ بالحكم في عهد عثمان، إلاّ أنّ المسلمين أدركوا ذلك بوعيهم وبتنبُّه كبار صحابة رسول الله صلىاللهعليهوآله؛ أمثال أبي ذر الغفاري، وعمرو بن الحمق الخزاعي فأشعلوها ثورة أطاحت بآمال بني اُميّة، ونسفت أحلامهم وما بنوا عليها من صروح خياليّة.
بَيد أنّهم دبّروا الأمر بشكل آخر كما يعرفه الجميع، حيث طالبوا بدم عثمان، وهذه أوَّل آية تدلّ على أنّهم اعتبروا أنفسهم وارثين الخلافة بعد عثمان، وإلاّ فما كان يمكنهم أنْ يُطالبوا بذلك بعد أنْ يضمُّوا صوتهم إلى سائر أصوات المسلمين، ويبايعوا عليّاً عليهالسلام، لا بل إنّهم يُريدونها كسرويّة وقيصريّة يرثها الحفيد، وتُبرَم فما أغنى معاوية عن هذا الذي لجَّ فيه وتهالك عليه. لقد رفع في الشام قميص عثمان حيث حشد تحته خمسين ألف مقاتل خاضبي لحاهم بدموع أعينهم، ورافعيه على أطراف الرماح، قد عاهدوا الله ألاّ يُغمدوا سيوفهم حتّى يقتلوا قَتَلة عثمان، أو تلحق أرواحهم بالله.
هل كان نهج معاوية هو النّهج الصحيح الأمثل لإنزال القصاص باُولئك القتلة؟ أكان طريق القصاص أنْ يمتنع من البيعة للخليفة الجديد الذي اختاره المهاجرون والأنصار في المدينة، ثمّ دخل المسلمون في بيعته أفواجاً من كلّ الأمصار والأقطار؟ أكان طريق الثأر لعثمان أنْ يمتنع معاوية عن البيعة، ويتمرّد على الدولة في تلك الظروف المزلزلة التي لا تتطلّب شيئاً كما تتطلّب رأب الصدع وجمع الكلمة؟ أكانت آية ولائه وحبِّه لعثمان أنْ يجعل من (قميصه) المضمّخ بدمه رايةً يبعث تحتها كلّ غرائز الجاهليّة، ويدير تحتها أتعس حرب أهليّة تُزلزل الإسلام وتفني المسلمين1؟
لم يكن الهدف الثأر لعثمان، وإلاّ فما حداه إلى أنْ يكتب إلىكلٍّ من طلحة والزبير يدعو كلاً منهما بإمرة المؤمنين، ويدَّعي أنّهما أحقّ بها من عليٍّ عليهالسلام، وأنّه من ورائهما ظهير، قد اتّخذ لهما البيعة من أهل الشام سلفاً؟! وإنّما كان هدفه أنْ يُثير استفزازاً في العالم الإسلامي المتوتّر، ويخرج من وراء ذلك بما يريد من الظفر بالسلطة المأمولة، والحزب الاُموي من وراء القصد.
ولنترك هذا المشهد إلى مشهد آخر. فحينما نجحت مؤامرة معاوية، وساعدته الأقدار على ابتزاز السّلطة من يد أهلها، وهيّأت له كلّ أهدافه وحقّقت له جميع شهواته، فما الذي حداه إذاً إلى استخلاف يزيد هذا السكِّير المقامر من بعده؟!
لا نستطيع تفسيراً لذلك إلاّ ما قد سبق: من أنَّ القضيّة كانت أعمق ممّا نخاله؛ فإنّها ليست قضيّة استخلاف والد ولده فقط، بل هي تحويل الخلافة إلى مُلكٍ اُمويٍّ عضوض، صرّح به مروان بن الحكم في عهد عثمان إذ قال للنّاس المحتشدين حول البلاط، يطالبون بحقوقهم الشرعيّة: ما تريدون من مُلكنا؟!
إذاً هو مُلكٌ لكم تُريدون الإبقاء عليه بما اُوتيتم من قوّة وسلطان! وراحت الأحداث تباعاً كلّها تؤكّد هذا التفسير حتّى جاء أحد الموالين لبني اُميّة، فصعد المنبر في حشد يضمّ زعماء المسلمين ذلك اليوم، ومعاوية مُتصدّر وإلى جنبه يزيد، فنظر إلى معاوية، ثمّ إلى يزيد، ثمّ هز سيفه قائلاً: أمير المؤمنين هذا (معاوية)، فإنْ مات فهذا (يزيد)، وإلاّ فهذا. وهزّ السّيف، فتقبّل النّاس خوفاً من آخر الثلاثة.
ومات معاوية، وكتب يزيد إلى الولاة بأخذ البيعة له، وجاء كتابه إلى المدينة، وطلب حاكم المدينة من الحسين عليهالسلام البيعة ليزيد فأبى، وكان من الطبيعي أنْ يأبى. ثمّ حشّد الحسين عليهالسلام أهله وأصحابه، وسار إلى مكّة لإعلان ثورته، لا على يزيد فقط بل على الحزب الاُموي، وعلى التوتّر الذي يسود العالم الإسلامي أيضاً، ولا شكّ أنّه سوف يربح القضيّة.
وبقي عليهالسلام في مكّة المكرمّة أيّاماً، يُعرّف النّاس مكانته السامية من الرسول صلىاللهعليهوآله، وسابقته النّاصعة للرسالة، وقِدمه الأصيل في قضايا المسلمين.
وأرسل يزيد إلى اغتياله مئة مسلّح، فعرف الحسين عليهالسلام ذلك، فتنكَّب الطريق وقصد الخروج إلى الكوفة. لماذا؟ لأسباب نوجزها فيما يلي:
1 – إنّه، إمّا أنْ يُعلن الحرب على بني اُميّة وأنصارهم في مكّة، وهو لا يُريد ذلك؛ لأنّه يخالف قداسة البيت وحرمته أولاً؛ ولأنّه إنْ ربحها لم يفد شيئاً؛ لأنّ من ورائه دولة مُسلّحة منتشرة قواها في كلّ مكان، في حين أنّ مكّة تكفيها سريّة تتّجه من المدينة، حيث لا تزال حكومة الاُمويّين متمكِّنة هناك، فتطحنها طحناً، بينما الكوفة هي الآن أعظم قوّة إسلاميّة على الإطلاق.
أضف إلى ذلك، أنّ هناك من اُجراءِ بني اُميّة كثيرون يُلفّقون عليه من الروايات ما هو بريء منها، كما فعلوا بالنّسبة إلى أمير المؤمنين عليٍّ عليهالسلام، والحسين عليهالسلام لا يهمّه شيء كما يهمّه معرفة النّاس أنّه على حقٍّ، وأنّ مناوئيه على باطل حتّى يُتّبع نهج الحقّ الذي يُمثّله، ويترك نهج الباطل الذي يُمثّلونه. ولو أعلنها حرباً عليهم، لكانت النتيجة أنْ يُقتل بسيف هؤلاء الوافدين من قِبل السّلطة وتحت ألبستهم أسلحة الإجرام.
2 – في مكّة ابنُ الزبير، وهو يزعم بأنّه أحقّ بالأمر من الحسين عليهالسلام، ولا يهمّه أنْ يتّحد مع يزيد الذي يدّعي الآن أنّه من مناوئيه في سبيل القضاء على الحسين عليهالسلام، كما صنع ذلك أبوه في معركة البصرة، حيث اصطفّ بجانب مناوئي عليٍّ عليهالسلام ليحظى بالخلافة دون الإمام عليهالسلام.
3 – الإمام الحسين عليهالسلام لم يكنْ يُريد أنْ يشتغل به، وهناك القضيّة الكبرى، حيث تحوّلت الخلافة في الشام إلى مُلك عضوض، وهذا انحراف يُجري الخلافة من حقٍّ إلى باطل، والاُولى أشدّ وأمرّ من الثانية قطعاً.
4 – إنّ مجرّد سفره إلى العراق في حين يتقاطر النّاس إلى مكّة من كلّ حدب وصوب -يوم الثامن من ذي الحِجّة الحرام- إعلانٌ كافٍ لهم عن هدفه، بل هو وحده كافٍ لتنبيه أهل الأمصار والأقطار النائية بما يحدث في العاصمة من حقيقة أمر الخلافة.
ثمّ سار بموكبه الحافل يقصد الكوفة، وقد أعلنت متابعة الإمام عليهالسلام وأعطت البيعة له، وتواعدت على الحرب معه، كما كانت تحارب مع أبيه عليهالسلام أهلَ الشام.
ومسلم بن عقيل ابن عمّه والٍ عليهم، نافذ الكلمة، مطاعٌ أمين، ثم اختلفت الرياح السّود على الأوساط، وكما يبيّن الإمام عليهالسلام نفسُه؛ خذلته شيعته وأنصاره، ونقضوا بيعته، وتلاشت قواه تحت ترهيب قوّة الشام وترغيبها.
وهناك سبب آخر غيّر مجرى التاريخ، وهو: التزام أنصار الحسين عليهالسلام بالحقّ حتّى في أشدّ الظروف وأعتاها، فهذا في جانب، وفي جانب آخر عدم ارتداع أهل الشام عن أيّ جريمة، وأيّ اغتيال وخدعة.
وهنا أنقل لكم قصّتين فقط، ثمّ آتي بنظرتين لهما حتّى نعرف بالمجموع اختلاف السير والاتّجاه بين الحسين عليهالسلام، وبين يزيد وأنصارهما:
كان مسلم بن عقيل الحاكم على الكوفة مطلق اليد، وكان عبيد الله بن زياد قد جاء إليها ليرجعها لبني اُميّة، ويُرضي رجل من زعماء الشيعة يُدعى هاني بن عروة، فعاده ابن زياد علّه يستطيع أنْ يربحه، وكان مسلم حاضراً، فأمره هاني أنْ يختفي في مخدع، فإذا جاء ابن زياد، والي يزيد وزعيم المعارضة الاُمويّة في الكوفة، ضرب عنقه وتخلّص من شرّه وشرّ يزيد من بعده.
وجاء ابن زياد، وانتظر هاني خروج مسلم ساعة بعد ساعة تستطيل دقائقها أنْ لا يفوته الوقت، ومع ذلك فلم يوافِهِ مسلم على الوعد، فأخذ يُنشد أشعاراً يُحرّضه بتلميحٍ على قتل ابن زياد، فأحسّ ابن زياد بالسّرِّ وخرج هارباً، فلمّا جاء مسلم وبَّخه هاني على استمهاله، فقال: قال رسول الله صلىاللهعليهوآله: «المُسلمُ لا يغدُرُ».
فقول رسول الله هو الميزان، وهو المقياس الأوّل والأخير للحركة في منطق أنصار الحسين عليهالسلام؛ لأنّهم لا يهدفون إلى غاية سوى بلوغ مرضاة الله تعالى، ولنْ تُبلغ مرضاته بمعصيته، ولا يُطاع الله من حيث يُعصى.
وانقلبت الاُمور، وقُتل مسلم، وجيء بخبر شهادته إلى الحسين عليهالسلام وهو في طريقه إلى الكوفة، في منزل يُدعى (زُبالة).
وهو إذ ذاك أحوج ما يكون إلى أنصار يؤيِّدونه وينصرونه؛ لأنّ أمامه الكوفة المخلوعة المغلوبة على أمرها، ووراءه مكّة المحتشدة فيها قوى مناوئيه من أنصار بني اُميّة وغيرهم، ومعه الآن زهاء ألف من الأنصار، أشدّ ما يكون احتياجاً إلى الإبقاء عليهم بكلِّ وسيلة. لكنّه أبَى إلاّ أنْ يُصارحهم بالموضوع، ويُبيّن لهم سقوط حكومته في الكوفة وحرج موقفه، ويجيز لهم التخلّي عنه إنْ شاؤوا.
استمعوا إلى خطبته حينما سمع بسقوط الكوفة في أيدي بني اُميّة: «أيّها النّاس، إنَّما جمعتُكُمْ على أنّ العراق لي، وقد أتانِي خَبرٌ فظيعٌ عن ابن عمِّي مسلمٍ يدلُّ على أنّ شيعَتَنا قد خذلتنا. فمَنْ منكُمْ يصبرُ على حرِّ السِّيوفِ وطعنِ الأسنّةِ فليأتِ معنا، وإلاّ فلينْصَرف عنَّا»2.
إنّه لا يبتغي من وراء نهضته سوى الله، وإذاً فليعمل كما يُريد الله صريحاً واضحاً فلا يخدع ولا يمكر.
وهنا ندع التاريخ يقصّ علينا عن أنصار يزيد قصّتين أيضاً:
- طلب ابنُ زياد الزعيمَ الشيعي الآنف الذكر، هاني بن عروة، ليتفاوض معه في بعض الشؤون، واغترّ الرجل وذهب إلى قصر الإمارة، فلمّا دخله أخذوه وعذّبوه ثمّ قتلوه، في حين أنّهم أعطوه الأيمان والمواثيق قبل قدومه القصر بأنّه لا يمسُّه سوء منهم.
- حشّدت شيعة عليٍّ عليهالسلام أمرها، وجاءت تُحاصر قصر الإمارة تُريد إنقاذ هانئ الذي خدعوه ومكروا به، ولم يكن -إذ ذاك- على قيد الحياة، فإذا بأنصار بني اُميّة من فوق القصر يُطمْئنون النّاسَ ويُهدّئونهم بحياة هانئ، وأنّه سوف يخرج إليهم بعد إجراء بعض المفاوضات.
ثمّ راحوا يُهدّدونهم بجيش الشام، وأنّه قد اقترب من حدود الكوفة، مالهم به قِبَلٌ أبداً، ورغَّبوهم بالأموال الطائلة التي سوف تهطل عليهم من الخزينة، فإذا بالنّاس يتفرّقون قليلاً قليلاً حتّى سقطت الكوفة في أيدي هؤلاء، وأوَّل ما صنعوه قتْل مسلم بعد ما قتلوا هانئ بن عروة غدراً ومكراً.
إنّ المستفاد من تاريخ النّهضة الحُسينيّة أنّ سبب سقوطها إنّما كان هذه القصّة بالذات، التي استقامت على وعود فارغة، وتهديد ماكر.
ثمّ حشّد ابن زياد بعد استيلائه التَّام على الكوفة جيشاً باسم محاربة الترك والدَّيلم، فلمّا اقتربت قافلة الإمام عليهالسلام من الكوفة، وجَّهه إليه ليُقيِّده إليه أو إلى الموت، وأوّل سريّة لقيت الحسين عليهالسلام من الجيش كانت مُكوّنة من ألف مقاتل، وعلى رأسها الحُرُّ بنُ يزيد الرياحي الذي طلب من الإمام عليهالسلام: إمّا البيعة، وإمّا قدوم الكوفة أسيراً.
فأبى الإمام عليهالسلام، وأخذ طريقاً وسطاً بين طريق الكوفة والمدينة، وأرسل الحُرُّ كتاباً إلى ابن زياد، فأجابه بلزوم محاربته، وحشّد إلى الإمام عليهالسلام جيوشاً بلغ عددها أكثر من ثلاثين ألف رجل، فالتقوا على صعيد كربلاء التي تبعد عن بغداد اليوم مئةً وخمسة كيلو مترات، وعن الكوفة خمسة وسبعين كيلو متراً.
وكان ذلك اليوم عصر التاسع من شهر مُحرّم الحرام، حيث جاءت رسالة ابن زياد إلى عمر بن سعد قائد جيش بني اُميّة، يأمره بالحرب بعد منع الماء عن حرم الرسول صلىاللهعليهوآله.
واستمهلهم الإمام الحسين عليهالسلام سواد الليل، حتّى إذا أفصحت ليلة العاشر من المحرّم عن صبحٍ كئيب، زحف الجيش على مُخيّم أبي عبد الله عليهالسلام وقاوم أنصاره، وهم اثنان وسبعون بطلاً من أشجع أبطال العالم الإسلامي، وصُرعوا واحداً بعد الآخر بعد ما أبلوا بلاءً حسناً.
وقُتل أيضاً إخوة الإمام عليهالسلام، وعلى رأسهم بطل العلقمي أبو الفضل العبّاس عليهالسلام، واستشهد أبناؤه حتّى الرضيع في حضن والده، ولَم يبقَ إلاّ الإمام عليهالسلام، فزحف إلى القوم وجاهد جهاداً عظيماً، وقَتل من أهل الكوفة عدداً هائلاً، ولَمْ تمضِ إلاّ ساعات حتّى أصابه القدر سهمه الغدّار على يد حرملة الكاهلي (لعنه الله)، وأصابه الكفر برمحه على يد سنان بن أنس (لعنه الله)، وبسيفه على يد شمر بن ذي الجوشن (لعنه الله وأعدّ له جحيماً وعذاباً أليماً)، فصُرع شهيداً رشيداً، ظامئاً مظلوماً، فعليه وعلى أنصاره ألف تحيّة وسلام.
ولما وقعت الواقعة الرهيبة، وانتهت بمصرع السّبط وأصحابه الأطهار عليهمالسلام على أرض كربلاء بأبشع إجرام عرفه التاريخ، دوّى صداها في العالم الإسلامي، وزُلزل عرش بني اُميّة زلزالاً.
ولَم تمضِ مدّة طويلة حتّى اندلعت ثورات في كلّ مكان، واستمرّت حلقات متّصلة حتّى انتهت بسقوط الدولة الاُمويّة، وإنْ كان الأمر لم ينتهِ بسقوط بني اُميّة تماماً؛ حيث انحرفت القيادة الإسلاميّة أيضاً عن مجراها الصحيح، إلاّ أنّ ثورة أبي عبد الله عليهالسلام ونهضته الجبّارة كوَّنت جبهة قويّة مُتماسكة تقف دون أي انحراف يُريده المجرمون للحقِّ ومفاهيمه.
والواقع أنّنا إذا تابعنا أحداث التاريخ بدقّة، نرى أنّ كلّ دعوة صادعة ثارت على الطغيان في قرون متطاولة، إنّما كانت نابعة عن حركة الإمام الحسين عليهالسلام.
وهكذا نستطيع أنْ نقول: إنّ نهضة الحسين عليهالسلام ظلّت قاعدة أصيلة للحركات الإصلاحية في التاريخ الإسلامي على طول الخطِّ، وستظلّ هكذا إلى الأبد 3.
- 1. خالد محمد خالد عن كتابه في رحاب علي / 162 – 163.
- 2. بلاغة الإمام الحسين عليهالسلام / 69.
- 3. من كتاب الإمام الحسين عليهالسلام قدوةٌ واُسوة.